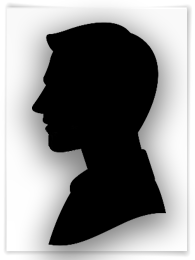كثير عزة
كثير عزة كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي، أبو صخر: شاعر، متيم مشهور. من أهل المدينة. أكثر إقامته بمصر. وفد على عبد الملك بن مروان، فازدرى منظره، ولما عرف أدبه رفع مجلسه، فاختص به وببني مروان، يعظمونه ويكرمونه. وكان مفرط القصر دميما، في نفسه شمم وترفع. يقال له ’’ابن أبي جمعة) و (كثير عزة’’ و’’الملحي’’ نسبة إلى بني مليح، وهم قبيلته. قال المرزباني: كان شاعر أهل الحجاز في الإسلام، لايقدمون عليه أحدا. وفي المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة، وينسبون إليه القول بالتناسخ، قيل: كان يرى أنه ’’يونس بن متي’’. أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة. وكان عفيفا في حبه، قيل له: هل نلت من عزة شيئا طول مدتك؟ فقال: لا والله، إنما كنت إذا أشتد بي الأمر أخذت يدها فاذا وضعتها على جبيني وجدت لذلك راحة. توفي بالمدينة. له ’’ديوان شعر -ط’’وللزبير بن بكار ’’أخبار كثير’’.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 5- ص: 219
كثير عزة أو صخر كثير بن عبد الرحمن وكثير بضم الكاف وفتح الثاء وتشديد الياء تصغير كثير بوزن أمير في القاموس كثير كأمير اسم وبالتصغير صاحب عزة ’’1ه’’ ولكنه قد ورد في شعر كثير نفسه مكبرا حيث قال:
وقال لي الواشون ويحك إنها | بغيرك حقا يا كثير تهيم |
لو يناجي ذكر المديح كثيرا | بمعانيه خالهن نسيبا |
فكأن قسا في عكاظ تخطب | وكثير عزة يوم بين ينسب |
توفي سنة 105بالمدينة في ولاية يزيد عن عبد الملك وقيل توفي أول خلافة هشام وعمره إحدى وثمانون أو اثنتان وثمانون سنة.
في معجم الشعراء للمرزباني: كان شاعر أهل الحجاز في الإسلام يقدمون عليه أحدا وكان أبرش قصيرا عليه خيلان في وجهه طويل العنق تعلوه حمرة وكان مزهوا متكبرا وكان يتشيع ويظهر الميل إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجا عبد
الله بن الزبير لما كان بينه وبين بني هاشم. وكان شاعر بني مروان وخاصا بعبد الملك وكانوا يعظمونه ويكرمونه، وقال خلف الأحمر كثير أشعر الناس في قوله لعبد الملك:
أبوك الذي لما أتى مرج راهط | وقد ألبوا للشر فبمن تألبا |
تشنأ للأعداء حتى إذا انتهوا | إلى أمره طوعا وكرها تحببا |
إذا قل مالي زاد عرضي كرامة | علي ولم أتبع دقيق المطامع |
هنيئا مريئا غير داء مخامر | لعزة من أعراضنا ما استحلت |
فقلت لها يا عز كل مصيبة | إذا وطنت يوما لها النفس ذلت |
وأدنيتني حتى إذا ما استبتني | بقول يحل العصم سهل الأباطح |
توليت عني حين لآلي حيلة | وغادرت ما غادرت بين الجوانح |
ومن لا يغمض عينه عن صديقه | وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب |
ومن يتبع جاهدا كل عثرة | يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب |
ألا أن الأثمة من قريش | ولاة الحق أربعة سواء |
وله:
لمن الديار بأبرق الحنان | فالبرق فالهضبات من أدمان |
أقوت منازلها وغير رسمها | بعد الأنيس تعاقب الأزمان |
فوقفت فيها صاحبي وما بها | يا عز من نعم ولا إنسان |
ما للوشاة بعزة عندي | شيء سوى التكذيب والرد |
ولعزة عندي وإن بعدت | أدنى من الأهلين والولد |
إني وعزة ما تزال على | حكم الهوى في القرب والبعد |
نبدي السلو تسترا وبنا | تحت الضلوع خلاف ما نبدي |
إياك يا عز الوشاة فهم | أعداء أهل الحب والود |
كم عائب لكم لا بغضكم | ما زادني شيئا سوى الوجد |
إني لأحفظ بالمغيب لكم | عهد المودة فاحفظوا عهدي |
نساء الأخلاء المصافين محرم | علي وجارات البيوت كنائن |
وإني لما استودعنني من أمانة | إذا ضيع الأسرار يا عز دافن |
وإني إذا ما الجبس ضيع عرضه | لعرضي وما أحوى من المجد صائن |
إذا ما انطوى كشحي على مستكنة | من الأمر لم يفطن له الدهر فاطن |
أليس أبي بالنضر أم ليس والدي | لكل نجيب من خزاعة أزهرا |
وإذا كان ’’الإجماع’’ أحد الأدلة القاطعة في الأحكام الشرعية، فلا يمكن أن تكون له هذه القيمة في قضايا الأدب، والتفكير الأدبي، ولذلك كان من حق الدكتور أن يخرج على الإجماع، ويتخذ الرأي الذي يراه. وليس من حقنا، كما قلت، ولا حق لأحد أن يتخذ من هذا الاعتراف سيفا يواجه به الدكتور. ولكن من حقنا أن نسأل الدكتور سؤالا متواضعا عن قوله في المقال نفسه: ’’ كان شاعرا ممتازا، وكان النساء فيحسن ذكرهن’’، فما معنى ’’يحسن’’ هذه؟ وفي أي شيء؟ وهل كان إحسانه في ذكرهن من باب إحسان المتنبي في ذكر بدر بن عمار، أو سيف الدولة، أو من باب إحسان حبيب في ذكر المعتصم؟ أم أنه كان يحسن ذكر ’’الجمال’’ و’’الهيام’’ و’’ الولع’’ وما أشيه ذلك من المعاني الشائعة في الغزل؟ وإذا كان ’’يحسن ذكرهن’’ في المعاني المذكورة فعلى أي شيء يقوم الغزل إذا لم يكن قائما على هذه المعاني؟
لا نعتقد أن نساء كثير كن في مستوى مدام كوري في العلوم مثلا أو بلقيس أو فكتوريا في إدارة الدولة حتى يكون إحسانه في ذكرهن قائما على معاني المثابرة والصبر في اكتشاف أسرار الطبيعة، أو سياسة الدولة وإدارتها وترقية الشعب والسهر على مصالحة وأي شيء في الشعر يهم المرأة التي كانت في عصر كثير حتى أعجبت به؟
أظن أن الجواب العلمي على هذه الأسئلة، كاف للدلالة على وقوع الدكتور في ’’تناقض’’ صارخ، وهو يثبت أن رأيه غي آخر الموضوع الذي كتبه عن كثير بلغي رأيه في أوله، ثم يلغي كثيرا من الآراء التي ذكرها بحق الشاعر في هذا الموضوع.
وأما ’’النفاق السياسي’’ الذي وصفه به نكون مع الدكتور فيه، ولكن إلى حد، فالمعروف عن كثير أنه هاشمي الهوى والرأي، ولكنه كان في الوقت نفسه يمدح بني أمية، وقد عد الدكتور هذا الموقف ’’نفاقا’’ ولا شك أن موقف كثير هذا موقف بين النقيضين حسب التعبير الفلسفي، ولا يمكن الدفاع عنه من ناحية المبدأ. ولكن يمكن أن يكون له عذر إذا أخذ من وجه آخر. . . من الوجه السياسي للدولة التي كانت دولة أوتوقراطية تعد على الناس أنفاسهم، وتحصي عليهم تنهداتهم، وتحسب حركاتهم حركة حركة.
معنى ذلك أن حرية الرأي أو القول كفر وخروج على الدين والإيمان، وعلى الذي يرى رأيا غير رأي الدولة أن يحمل دمه على كفه، وأن يكون مستعدا للرحيل إلى المقابر. وكثير كان مؤمنا ببني هاشم، ومؤمنا بأنهم أحق من بني أمية، ولكنه لم يكن ’’مستعدا’’ حتى للتضحية بحياته في سبيل ذلك الإيمان، على أنه في الوقت نفسه كان يصرح لكبار الأمويين بحبه لبني هاشم، وقد روى الدكتور نفسه عنه هذه الحادثة:
’’لما خرج عبد الملك لحرب مصعب بن الزبير لحظ في عسكره ’’ كثيرا’’ يمشي مطرقا وكأنه حزين، فدعاه فسأله: أتصدقني إن أنبأتك بما في نفسك؟ قال: نعم! قال: فاحلف بأبي تراب، فحلف كثير بالله ليصدقنه! فقال عبد الملك: لا بد من أن تحلف بأبي تراب فحلف له بأبي تراب. فقال عبد الملك: تقول في نفسك: رجلان من قريش يلقى أحدهما الآخر لحربه فيقتله، والقاتل والمقتول في النار، وما آمن أن يصيبني سهم فيقتلني، فأكون معهما! قال كثير: ما أخطأت، يا أمير المؤمنين! فقال عبد الملك: عد من قريب، وأمر له بجائزة’’.
فهذا الموقف يدل، في أقل ما يدل عليه، إن الرجل لم يكن منافقا، بل كان بالرغم من عنف الاستبداد، على شيء من الصراحة وإن مدح بني أمية.
وإذا كان مدح كثير لبني أمية نفاقا سياسيا فما رأي الدكتور بمدحه للملك فاروق لما تزوج فريدة؟ نحن نعرف أن الدكتور طه من ملة الألوية في الدعوة إلى الحرية، ونعرف أن رأيه السياسي يختلف عن رأي فاروق، ونعرف في الوقت ذاته فاروقا لا يمكن أن يكون سوى قزم إذا قيس بالدكتور طه حسين. وبالرغم من الفروق الهائلة بين عصر كثير وطه حسين، ومع الفروق الهائلة بين كثير وطه نفسيهما من حيث المستوى الثقافي والعقلي، فإن الدكتور وقف أمام فاروق، موقف كثير ذاته الذي وقفه أمام بني أمية، وإذا أمكن أن يكون لكثير عذر في ذلك العصر المظلم، فأي عذر للدكتور طه في هذا العصر المنير؟
لقد تأسف الكثيرون يومئذ لموقف الدكتور، ودخوله في قافلة المداحين لملك تافه، وعدره جينا غير لائق بواحد مثله. ولو وقف يومها موقف المدافع عن رأيه، ورفض النزول إلى مدح واحد كفاروق، لهللت له الحرية في أنحاء الدنيا، ولكنه لم يفعل. بل كان قبل ذلك يلوم كثيرا على موقف وقف مثله فيما بعد! ثم عد موقف كثير من فصيلة النفاق السياسي.
نقد آخر تعرض له هذا الشاعر، ولكن ذلك كان في حياته وفي أيامه،لا بعد وفاته بقرون كما فعل الدكتور طه. فقد قدم الكوفة، وطلب الاجتماع ب’’قطام’’ التي لعبت الدور الأكبر في اغتيال الإمام علي عليه السلام. ونهاه البعض عن ذلك، فما انتهى، ثم سأل عن منزلها فدل عليه، وأخيرا وصل، ومذ رأته سألت: ’’من أجل؟’’ فقال ’’كثير بن عبد الرحمن’’ فقالت: ’’التيمي الخزاعي؟’’ فأجابها بالإيجاب. ثم سألها: ’’أنت قطام؟’’ فقالت نعم: فتابع السؤال: ’’أنت صاحبة علي بن أبي طالب علي السلام’’ فردت عليه: ’’بل صاحبة عبد الرحمن بن ملجم’’ وعندئذ قال:
’’والله إني كنت أحب أن أراك، فلما رأيتك نبت عيني عنك، وما ومقك قلبي، ولا احلوليت في صدري’’، فردت عليه: ’’أنت والله قصير القامة، صغير الهامة، ضعيف الدعامة، كما قيل لئن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه’’،
فأنشأ كثير:
رأت رجلا أودى السفار بجسمه | فلم يبق إلا منطق وجناجن |
وإن خفيت كانت لعينك قرة | وإن تبد يوما لم يعمك عارها |
من الخفرات البيض لم تر شقوة | وفي الحسب المحض الرفيع نجارها |
فما روضة بالحزن طيبة الثرى | يمج الندى جثجاثها وعرارها |
بأطيب من فيها إذا جئت طارقا | وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها |
ألم تراني كلما جئت طارقا | وجدت بها طيبا وإن تتطيب |
رمتني على عمد بثينة بعد ما | تولى شبابي، وأرجحن شبابها |
بعينين نجلاوين لو رقرقتهما | لنوء الثريا لاستهل سحابها |
ولكنما ترمين نفسا مريضة | لعزة منها صفوها ولبابها |
وددت، وبيت الله، إنك بكرة | هجان وإني مصعب ثم نهرب |
كلانا به عر فمن يرنا يقل | على حسنها جرباء تعدي وأجرب |
نكون لذي مال كثير مغفل | فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب |
إذا ما وردنا منهلا صاح أهله | علينا، فما ننفك ننفى ونضرب |
إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه | تواشوا بنا حتى أمل مكاني |
لو أن عزة خاصمت شمس الضحى | في الحسن عند موفق لقضى لها |
وسعى إلي بصرم عزة نسوة | جعل المليك خدودهن نعالها |
يقيك جميل كل سواء أما له | لديك حديث أو إليك رسول؟ |
وقد قلت في حبي لكم وصبابتي | محاسن شعر ذكرهن يطول |
إذا لم يكن يرضيك قولي فعلمي | نسيم الصبا، يا بثن، كيف أقول |
فما غاب عن عيني خيالك لحظة | ولا زال عنها، والخيال يزول! |
يقول العدى يا عز قد حال دونكم | شجاع على ظهر الطريق مصمم |
فقلت لها والله لو كان دونكم | جهنم. . ما راعت فؤادي جهنم |
وكيف يروع القلب، يا عز رائع | ووجهك في الظلماء في السفر معلم |
وما ظلمتك النفس يا عز في الهوى | فلا تنقمي حبي، فما فيه منقم |
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 9- ص: 25
كثير عزة بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي من فحول الشعراء، وهو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي، المدني.
امتدح عبد الملك والكبار.
وقال الزبير بن بكار: كان شيعيا، يقول بتناسخ الأرواح، وكان خشبيا، يؤمن بالرجعة، وكان قد تتيم بعزة، وشبب بها، وبعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار.
ومات هو وعكرمة: في يوم، سنة سبع ومائة.
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 5- ص: 470