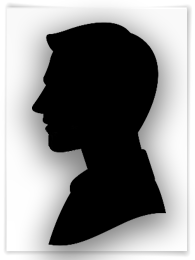عنان بن مغامس
عنان بن مغامس عنان بن مغامس بن رميثة بن ابي نمى: شريف حسني، من امراء بمكة. وليها للظاهر برقوق (صاحب مصر) بعد مقتل الشريف محمد بن احمدج بن عجلان (سنة 788هـ) ثم عزله الظاهر سنة 789 فرحل إلى مصر سنة 794 فاقام إلى ان توفى فيها.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 5- ص: 90
عنان بن مغامس بن رميثة بن أبي نمى محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني المكي، يكنى أبا لجام، ويلقب زين الدين:
أمير مكة. ولى إمرتها مرتين: الأولى سنة، غير أنه كان معزولا من قبل السلطان، نحو أربعة أشهر من آخرها، والثانية سنتان، أو نحوهما، غير أنه كان ممنوعا أشهرا من قبل آل عجلان، لغلبتهم له على الأمر بمكة، وسنوضح ذلك وغيره من خبره، وذلك أنه كان بعد قتل أبيه مغامسا، لايم عمه سند بن رميثة، فلما مات سند، استولى عنان على خيله وسلاحه، وفر بذلك عن عمه عجلان، لأنه وارث لسند، ثم لايم عنان عمه عجلان، وابنه أحمد، وكانا يغتبطان به، لما فيه من الخصال المحمودة.
وبلغني أنه دخل يوما على عجلان، وعنده بعض أعيان بنى حسن، مستقضيا منه حاجة، فقضاها له عجلان، ثم قال: هنيئا لمن كان له ابن مثله!، وكان أحمد بن عجلان يكرمه كثيرا، وزوجه على ابنته: أم المسعود، وفي ليلة مقامه للدخول عليها، قتل أخوه محمد بن مغامس، فأرضاه عنه أحمد بن عجلان بمال جيد، ثم نفر عنه أحمد، لميله عنه إلى صاحب حلى، لما رام أحمد القيام عليه، كما سبق مبينا في ترجمة أحمد.
وأمر عنانا بأن يبين عنه، فبان، وأخذ إبلا كثيرة للأعراب، فسألوا أحمد بن عجلان أن يستنقذها لهم من عنان، فأبى ذلك أحمد، فتوسل كل من له فيها حق إلى عنان، ببعض بنى حسن، فأجاب كل سائل بمراده، إلى أن لم يبق معه إلا اليسير، فقال لصاحبه: إن كان لك صاحب من بنى حسن، فكلمه يسألنى في رد ذلك فأرده، فقال له: إنما أسألك بالله في رد ذلك، فرده عليه. وحصل خيلا وسلاحا، بمعاونة صاحب حلى له على ذلك، ثم رأي أحمد بن عجلان، أن يعيده إلى مصاحبته، فأجاب عنان إلى ذلك، وأحسن له بعد عوده إليه، ثم أغرى به بعض بنى ثقبة، وأغراه ببعضهم، كما سبق مبينا في ترجمة أحمد، ليشتغل عنان عن أحمد بمعاداة بنى ثقبة، ويشتغل بنو ثقبة عن أحمد، بمعاداة عنان، فما تم له قصد، وعرف ذلك عنان، وبنو ثقبة، ثم سافر عنان وحسن بن ثقبة إلى مصر، فبالغا في شكوى أحمد، وسألا السلطان الملك الظاهر برقوق صاحب مصر، في أن يرسم لهم عليه بأمور رغبا فيها، فأجاب سؤالهم، إلا أن عنانا رزق قبولا من السلطان، واتبعهم أحمد بن عجلان بهدية سنية للسلطان مع كبيش، ولما رأي كبيش حال عنان رائجا، أظهر للسلطان وللدولة، أن أحمد بن عجلان يوافق ما رسم لعنان وبنى ثقبة، لئلا يتم على أحمد بمصر سوء، وسالم المذكورين حتى وصل مكة، وعرف أحمد بالحال، وقال له: لا بد لك من الموافقة على ما رسم به لهما، أو الفتك بعنان، فمال إلى الثاني، وأضمر ذلك، واجتمع به عنان وحسن بن ثقبة، بعد التوثق منه، فما أجاب لمرادهما، ثم إن بعض المتكفلين لعنان، بأمان أحمد بن عجلان، عرفه بقصد أحمد فيه، وكان ذلك بمنى، ففر إلى ينبع، وتلاه حسن بن ثقبة، ثم حسن لهما أمير الحاج المصري، أبو بكر بن سنقر الجمالى، أن يرجعا إلى مكة، وحسن لمحمد ابن عجلان، أن يرجع معهما، وكان قد توجه من مكة مغاضبا لأخيه، وضمن لهم أن أحمد يقضى حوائجهم، إذا وصل إليه كتابه، فرجعوا إلى أحمد، فلما اجتمعوا به قبض عليهم، وضم إليهم أحمد ابن ثقبة، وابنه عليا، وقيد الخمسة وسجنهم بالعلقمية، من أول سنة سبع وثمانين وسبعمائة، وإلى موسمها، ثم نقلهم إلى أجياد، في موسم هذه السنة، ثم أعادهم بعد الموسم إلى العلقمية، وكادوا يفلتون منها بحيلة دبروها، وهي أنهم ربطوا سررا كانت عندهم بثياب معهم، وصعدوا فيها، غير محمد بن عجلان، حتى بلغوا طاقة تشرف على منزل ملاصق لسجنهم، فنزلوا منها إليه، فنذر بهم بعض الساكنين فيه، فصاح عليهم يظنهم لصوصا، فسمع الصياح، الموكلون بهم من خارج السجن، فتيقظوا، وعرف الأشراف بتيقظ الموكلين بهم، فأحجموا عن الخروج إلا عنانا، فإنه أقدم، ولما بلغ الدار، وثب وثبة شديدة، فانفك القيد عن إحدى رجليه، وما شعر به أحد حين خرج، فسار إلى جهة سوق الليل، وما كان غير قليل، حتى رأي كبيش والعسكر يفتشون عليه بضوء معهم، فدنا إلى مزبلة بسوق الليل، وأظهر أنه يبول، وأخفاه الله عن أعينهم.
فلما رجعوا، سار إلى أن لقيه بعض معارفه، فعرفه خبره، وسأله في تغييبه، فغيبه في بيت بشعب على، في صهريج فيه، ووضع على فمه حشيش ودابة، لئلا يظهر موضع الصهريج للناظر في البيت، وفي الصباح أتى كبيش بعسكره إلى ذلك البيت، لأنه أنهى إليه أنه فيه، فما وجده فيه، فقيل له: إن في البيت صهريجا، فأعرض عن ذلك، لما أراده
الله تعالى من سلامة المختفى فيه، ثم بعث إلى بعض الأشراف ذوى راجح، وكان له منهم قرابة، فحضر إليه غير واحد منهم، وسألهم في إعانته، بمركوب له ولمن يسافر معه، فأجابوه لقصده، وأخرجوا له ركائب إلى المعابدة، وحملوا عليها فخارا وغيره، ليخفى أمرها على من يراها، وخرج عنان من سوق الليل إلى المعابدة، ونزل عند امرأة يعرفها من أهلها، فأخفته بإلباسها له ثياب النساء، وأجلسته معها ومع غيرها، ونمى الخبر إلى كبيش، فأتى إلى المنزل الذي فيه عنان بالمعابدة، وسأل عنه صاحبة المنزل التي أخفته، فنالت بالقول من عنان كثيرا، وأنكرت أن يكون عندها، فصدقها كبيش.
فلما كان الليل، ركب مع رجلين أو ثلاثة، الرواحل التي أعدت لهم، فوقفت بعض ركابهم، قبل وصولهم إلى وادى مر، وما وصل هو إلى خليص، إلا وقد كلت راحلته، فسأل بعض أهل خليص عن راحلة لبعض أصحابه، بلغه أنها بخليص، فأخبر بوجودها، فأخذها؛ ويقال إن صاحبها كان إذا فرغ من علفها، يقول: ليت عنانا يخلص فينجو عليك، فكان ما تمناه، فتوصل عنان إلى ينبع، ثم إلى مصر، في أثناء سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، فأقبل عليه الملك الظاهر، ووصل إليه فيما بلغني، كتاب من أحمد بن عجلان، يسأله في رد عنان إليه، فكتب إليه الظاهر يقول: وأما ما ذكرت من جهة عنان، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] وبعد قليل، بلغ السلطان موت أحمد بن عجلان، وكحل ولده للأشراف المسجونين، فتغير على الولد، لأنه كان يسأل أباه في إطلاقهم، فأبى وأضمر تولية عنان مكة عوضه، وكتم ذلك على عنان، وخادع محمد بن أحمد بن عجلان، بأن أرسل إليه العهد والخلعة بولاية مكة، وأذن لعنان في التوجه صحبة الحاج، وأمر أمير الحاج، بقلة مراعاته لعنان في طريق مكة، فكان لا يلتفت إليه، وربما أهانه لئلا يتشوش محمد بن أحمد بن عجلان، وتمت عليه هذه الخدعة، لما قضى الله تعالى به من الشهادة، فإنه لما حضر لخدمة المحمل المصري، على عادة أمراء الحجاز، قتله باطنينان، في مستهل الحجة، من سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وبعد قتله، أشعر أمير الحاج المارديني عنانا بولايته لإمرة مكة، عوض المذكور، ودخل مع الترك، وعليهم السلاح، حتى انتهوا إلى أجياد، فحاربهم فيه بعض جماعة محمد بن أحمد ثم ولوا، ونودى لعنان في البلد بالولاية، وألبس الخلعة السلطانية بذلك، في مستهل الحجة، ثم قرئ توقيعه على قبة زمزم، وكتاب السلطان بولايته، وإلزام بنى حسن من الأشراف والقواد بطاعته، وقام بخدمة الحاج حتى رحلوا، وتوجه بعد سير الحاج بمدة بسيرة، إلى جدة، فقرر أمرها ورتب بها نائبا، محمد بن عجلان، لملايمته له من السجن، وتوحشه
من كبيش، بسبب قيامه في كحله، واستدنى جماعة كثيرة من عبيد أحمد، فأحسن إليهم، وقال لهم: أنا عوضكم في مولاكم وابن مولاكم، فأظهروا له الرضا عنه، وجعلهم بجدة، وجعل بها محمد بن بركتى - وهو ابن مولى أبيه مغامس - عينا له على محمد، ومن معه من آل عجلان، فوقع من محمد بن عجلان، ما أنكر عليه محمد بن بركتى، وأنهى ذلك عنه إلى عنان، فكتب عنان إلى محمد بن عجلان يزجره، فغضب محمد، وأرسل إلى كبيش ومن ومعه من آل عجلان وغيرهم، يستدعيهم إليه، فقدموا إليه، واستولوا على جدة، وما فيها من أموال الكارم، وغلال المصريين، من أهل الدولة بمصر، وكان ذلك شيئا عظيما جدا، ومال إليهم للطمع، جماعة من أصحاب عنان، ولم يستطيع عنان الخروج إليهم، واحتاج، وأخذ بمكة ما كان في بيت شمس الدين بن جن البئر، وكيل الأمير جركس الخليلي، أمير آخور الملكى الظاهري، وأحد خواص السلطان، من الغلال والقماش والسكر وغير ذلك، وكان شيئا كثيرا، وأعطى ذلك لبنى حسن وغيرهم [ ..... ] به حال عنان، وكان الذين مع عنان يختلفون عليه، فأرضى أحمد بن ثقبة وعقيل بن مبارك، بإشراكهما معه في الإمرة بمكة، وصار يدعى لهما معه في الخطبة، وبعد المغرب على زمزم، ولكل منهما طبلخانه وغلمانه، ثم أشرك معه في الإمرة والدعاء، علي بن مبارك، لما أتاه منافرا لآل عجلان، وبلغ ذلك - مع ما اتفق بجدة ومكة من النهب - السلطان بمصر، فعزل عنانا، وولى علي بن عجلان إمرة مكة عوضه.
وامتنع أصحاب عنان من تسليم البلد لعلى، فتابعهم عنان على ذلك، والتقوا مع أصحاب على بالأبطح، عند ثنية أذاخر، فقتل كبيش وغيره من آل عجلان ومن جماعتهم، وولوا راجعين إلى منازلهم بالوادى، فأجار عنان من اللحاق بهم، ودخل هو وأصحابه مكة مسرورين بالنصر، بعد أن كاد يتم عليهم الغلب، وكان من أسباب نصرهم، أنهم عاجلوا آل عجلان بالقتال، قبل وصول بقيتهم إلى الأبطح، وعدم ظهور عنان وقت الحرب، لإشارة بعض خواصه عليه بذلك، لظنه أن آل عجلان يجتهدون في حربه، إذا ظهر لهم، وقتل من جماعة عنان، شريف يقال له فياش، وخمسة من أهل مكة، وذلك يوم السبت سلخ شعبان سنة تسع وثمانين وسبعمائة، وفتحت الكعبة لعنان وأصحابه، لما انتهوا إلى المسجد، فدخلها جماعة منهم، وأقاموا بمكة إلى أن أطل الحجاج المصريون على دخول مكة، ثم فارقوها، وقصدوا الزيمة بوادى نخلة اليمانية، وتخلف
عنان لما بلغه من تقرير السلطان له في نصف الإمرة بمكة، شريكا لعلي بن عجلان، بشرط حضور عنان لخدمة المحمل، وبرز للقائه حتى كاد يصل إليه، فبلغه أن آل عجلان، يريدونه بسوء عند لقائه، وتبع أصحابه إلى الزيمة، فأتاهم إليها علي بن عجلان في طائفة من جماعته ومن الترك، فقتلوا بعض الأشراف وغيرهم، وعادوا ظافرين بخيل ودروع، لأنهم لما وافوا الزيمة، كان الأشراف في غفلة عنهم، وفي تعب من قتالهم لقافلة بجيلة، فأعرضوا عن قتال على ومن معه.
وبعد الموسم نرل عنان وأصحابه وادى مر، واستولوا عليه وعلى جدة، وحصل في طريقها وغيرها من الطرقات نهب وخوف، وكتب عنان إلى السلطان يعتذر عند ترك حضوره لخدمة المحمل، لما بلغه من قصد آل عجلان له بالسوء، وشكاهم إليه، فكتب إليه السلطان يقول له: أنت على ولايتك، فافعل ما تقدر عليه، فما تم له فيهم مراد، لاختلاف أصحابه عليه.
فسار في أثناء سنة تسعين وسبعمائة، وهو حنق عليهم إلى مصر، وما وجد بها الإقبال الذي كان يعهده، وأقام بها مطلقا، إلى أن زالت دولة الملك الظاهر، وصار الأمر لمن كان قبله، وهو الصالح حاجى بن الأشرف شعبان، ولمدبر دولته الأمير يلبغا الناصري، فسعي له عنده في عوده لولاية مكة، فأجيب لقصده، ووعد بإلباس خلعة الولاية، في يوم عين له، فلم يتم له الأمر، لأنه في ذلك اليوم، ثار على الناصري أمير يقال له تمربغا الأفضلى، ويلقب منطاش، وما كان غير قليل، حتى قبض على الناصري. ونحو أربعين أميرا من أصحابه، وبعد قيام منطاش بقليل، قدم إلى مصر محمد بن عجلان، فسعي عند منطاش في حبس عنان، فأجيب، وحبس عنان مع بعض مماليك الظاهر، في النصف الثاني من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة.
ثم خلصوا هم وعنان، وصورة خلاصهم، أنهم نقبوا نقبا من الموضع الذي كانوا مسجونين فيه من القلعة، فوجدوا فيه سربا، فمشوا فيه حتى انتهوا إلى موضع آخر فنقبوه، فخرجوا منه إلى محل سكن نائب القلعة، فصاحوا على من بها، وهم غافلون ليلا، فأدهشوهم، وكانوا في قلة، لخروج منطاش وغالب العسكر إلى الشام لقتال الظاهر، فإنه ظهر بالشام، واجتمع إليه ناس كثير، والتقى بشقحب، مع العسكر الذي فيه الصالح ومنطاش، فتم النصر للظاهر، وقبض على الصالح وغيره، وفر منطاش إلى دمشق هاربا، فتحصن بها.
وكان سبب إطلاق الظاهر، أن الناصري حين أحس بظهور منطاش عليه، كتب
كتابا إلى نائب قلعة الكرك، يأمره بإطلاق الظاهر، فأطلقه؛ وكان من أمره ما ذكرناه، وكان من أمر مماليكه الذين ثاروا بالقلعة، أنهم استولوا عليها لعجز أصحاب منطاش عن مقاومتهم، وبعثوا يبشرون مولاهم بذلك، وكان ممن بعثوه لبشارته عنان.
فلما عرف السلطان ذلك، أقبل إلى مصر، وأعرض عن حصار منطاش بدمشق، وبعد استقرار السلطان بالقلعة، شفع كبير مماليكه المستولين على القلعة، وهو بطا الدوادار، لعنان، في ولاية مكة، فأجابه السلطان لسؤاله، ولكن أقر علي بن عجلان على ولاية نصف إمرة مكة، شريكا لعنان، لما في نفسه على عنان، وتجهز عنان إلى مكة، ومعه شخص تركى من جهة السلطان، ليقلده الولاية بمكة، فلما انتهى عنان إلى ينبع، حسن له وبير بن مخبار أمير ينبع، أن يحارب معه بنى إبراهيم، ووعده بشيء على ذلك، فمال إلى ذلك عنان.
وحارب مع وبير، بنى إبراهيم، فظهروا على بنى إبراهيم، ثم توجه عنان إلى مكة، وتلقاه كثير من بنى حسن، قبل وصوله إلى الوادى، ثم مشى الناس في الألفة بينه وبين آل عجلان، فمال كل منهم إلى ذلك، فتوافقوا على أن كلا منهما، يدخل مكة لحاجته، فإذا قضاها خرج من مكة، ولكل منهما فيها نواب، بعضهم لقبض ما يخص كلا منهما من المتحصل، وبعضهم للحكم بها، وأن يكون القواد مع عنان، والأشراف مع على، وكان الاتفاق على ذلك ووصوله إلى الوادى، في النصف الأول من شعبان سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة.
وقبل نصفه بيومين، دخل عنان مكة لابسا لخلعة السلطان، وقرئ بها توقيعه، ثم دعى له على زمزم وفي الخطبة، ودام هذا بين المذكورين، إلى الرابع والعشرين من صفر سنة أربع وتسعين وسبعمائة، ثم أزيل شعار ولاية عنان من مكة، غير الدعاء له في الخطبة، فإنه لم يزل، وسبب ذلك، أن آل عجلان، قطعوا الدعاء له على زمزم بعد المغرب، وأخرجوا نوابه من مكة، بعد أن هموا بقتله بالمسعي، في التاريخ المذكور، وما نجا إلا بجهد عظيم، وقصد في حال هربه الأشراف، مستنصرا بهم على آل عجلان، وكانوا معه، فأمره الأشراف بالانتصار بالقواد أصحابه، فحركهم لنصره، فما تحركوا، لأنهم رأوا منه قبل ذلك تقصيرا، وسبب ذلك أن بعض آل عجلان، أحب تكدير خاطر القواد عليه ليتمكن منه آل عجلان، وقال لعنان: أرى القواد جفاة، ونحن نعينك عليهم، فظن ذلك حقيقة، وفعل ما أشير به عليه، فتأثر منه القواد، وحكوا ما رأوا منه لأصحابهم من آل عجلان، فذموه معهم، ونفروهم منه، فازدادوا نفورا، ولذلك تخلوا
عن نصره، حين سألهم ذلك، وبعد مفارقته لمكة على الوجه المذكور، اجتمع به علي بن عجلان، ومحمد بن محمود، وكان على لا يفصل أمرا دون ابن محمود، واعتذر إليه بعدم العلم بتجرى غلمانهم عليه، وكان في مدة ولايته مغلوبا مع أصحابه، وكذا على مع أصحابه، وحصل بسبب ذلك ضرر على السفار إلى مكة، لزيادة العرافة وقلة الأمن، وخطف الأموال، وأنهى هذا الحال إلى السلطان، فاستدعى عنانا وعليا مع جماعة من أعيان الأشراف والقواد، فأعرضوا عن الوصول لباب السلطان، غير على وعنان، فإنهما لم يجدا بدا من ذلك، وبعد وصول هذا الاستدعاء، تحرك لنصر عنان بعض الأشراف، الذين مع علي بن عجلان، وألزموه بإخلاء مكة من العبيد وأتباعهم، حتى يدخل إليها عنان، ليتجهز منها لسفره، فإذا تم جهازه، خرج وعادوا إليها، فما وسع على إلا الموافقة، فخرج المشار إليهم إلى منى، ودخل عنان مكة، وأقام بها حتى انقضى جهازه، ثم توجه إلى مصر في جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين، وتلاه على إليها، وحضر إلى السلطان غير مرة، ففوض إمرة مكة لعلى بمفرده، وأمر عنانا بالإقامة بمصر، ورتب له شيئا يصرفه، ولم يسجنه، ثم إن بعض بنى حسين أهل المدينة، وشى به إلى السلطان، وقال له: إنه يريد الهرب إلى مكة يفسد بها، وأنه أعد نجبا لذلك، فسجنه السلطان ببرج في القلعة، في أثناء سنة خمس وتسعين وسبعمائة، واستمر به إلى أن أنفذه السلطان إلى الإسكندرية، في آخر سنة تسع وتسعين وسبعمائة، مع جماز بن هبة الحسيني صاحب المدينة، وكان قبض عليه في هذه السنة، بإثر وصوله إلى مصر، وبعث السلطان معهما إلى الإسكندرية، علي بن المبارك بن رميثة وولديه، وسجن الجميع بالإسكندرية، إلى أن مات الملك الظاهر.
فلما ولى ابنه الملك الناصر فرج، شفع لهم بعض الناس في إطلاقهم بالإسكندرية، ومنعهم من الخروج من أبوابها، فتم لهم ذلك، ثم تكرر سجنهم وإطلاقهم بالإسكندرية على الصفة المذكورة، ثم نقل عنان إلى مصر في آخر سنة أربع وثمانمائة، أو في أول التي بعدها، بسعي القاضي برهان الدين إبراهيم بن عمر، تاجر الخواص الشريفة السلطانية، لتغيره على صاحب مكة، الشريف حسن بن عجلان، لما أخذه من الذهب الكثير، من ولده القاضي شهاب الدين أحمد، لما انكسر المركب الذي كان فيه، وهو إذ ذاك متوجها إلى اليمن، وقصد المحلى بإطلاق عنان، إخافة السيد حسن، كى يرد عليه المال، أو ما أمكن منه، ونوه لعنان بولاية مكة، فما قدر ذلك، لمعاجلة المنية عنانا.
وسبب موته، أنه حصل له مرض خطر، يقتضى إبطال بعض جسده، فعولج من ذلك بإضجاعه بمحل فيه أثر النار، حتى يخلص ذلك إلى أعضائه فيقويها.
وكان أثر النار الذي أضجعوه عليه، شديد القوة فأحرقه فمات، يوم الجمعة مستهل شهر ربيع الأول، وقيل ثانيه، سنة خمس وثمانمائة، عن ثلاث وستين سنة.
وكان كثير الشجاعة والكرم، عالى الهمة، قليل الحظ في الإمرة، وأما في بيت روحه، فسعده في ذلك عظيم، وخلف ولدين نجيبين، أحدهما السيد محمد، توفى بينبع في النصف الثاني من ذي القعدة، سنة ست وثمانمائة، قافلا إلى مكة، باستدعاء السيد حسن صاحب مكة، والآخر السيد على، وهو بقيد الحياة. وله اعتبار كبير بين قومه.
ومن محاسن أبيه، أنه سمح لبنى شيبة، سدنة الكعبة المعظمة، ما كان يأخذه منهم أمراء مكة قبله، وذلك جانب كبير من كسوتها، في كل سنة، أو خمسة آلاف درهم عوضا عن ذلك، مع ستارة الباب، وثوب مقام إبراهيم عليه السلام. ومما سمح به لبعض الشعراء، وهو الجمال محمد بن حسن بن العليف، ثلاثون ألف درهم، جزاء على قصيدة مدحه بها أولها:
بروج زاهرات أو مغانى
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1998) , ج: 5- ص: 1