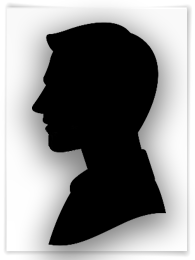ابن عصفور
ابن عصفور علي بن مؤمن بن محمد، الحضرمي الإشبيلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور: حامل لواء العربية بالإندلس في عصره. من كتبه (المقرب- خ) في النحو، و (الممتع) في التصريف، و (المفتاح) و (الهلال) و (السالف والعذار) و (شرح الجمل) و (شرح المتنبي) و (سرقات الشعراء) و (شرح الحماسة). توفي بتونس.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 5- ص: 27
ابن عصفور علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور ابن عصفور الحضرمي الأشبيلي، أبو الحسن، هكذا أملى ابن عصفور نسبه على تلميذه أبي علي الحسين بن أحمد الطبلي الباجي (من باجة أفريقية)، نزيل تونس النحوي اللغوي، وله مقطوعتان شعريتان ذكرهما مترجموه لا تؤهلانه لأن يكون معدودا من الشعراء ولعله لم يمارس نظم الشعر كثيرا.
مولده عام السيل الكبير باشبيلية، وبها نشأ، وعن شيوخها أخذ العلم، فقرأ النحو على علمين من أعلام النحاة في عصره أبي الحسن الدباج، وأبي علي الشلوبين الذي لازمه عشر سنين، وهو أبرع من تخرج عليه، ثم كانت بينهما منافرة ومقاطعة، وتصدر للاشتغال مدة بعدة بلدان من الأندلس، فجال بالأندلس وأقبل الطلبة عليه، وكان أمير الناس على المطالعة بالأندلس لا يمل ذلك، قاله أبو جعفر بن الزبير اقرأ باشبيلية، وشريش، ومالقة، ولورقة، ومرسية، ودخل المغرب الأقصى، وسكن ثغر آنفا وازمور، ثم عبر البحر إلى تونس وأقام بها يسيرا. ثم انتقل إلى بجاية بالقطر الجزائري بانتقال مخدومه الأمير ولي العهد أبي عبد الله محمد المستنصر بن أبي زكرياء الحفصي، وكان له اختصاص به فأقام بها مدة، ثم عاد إلى
تونس؛ ثم سافر إلى الأندلس، وقصد لورقة وعاد إلى غرب الأندلس ثم عبر إلى مدينة سلا بالمغرب الأقصى، وأقام بها يسيرا، ثم عاد إلى تونس باستدعاء من محمد المستنصر بعد توليه الملك واستقر بها إلى أن توفي، وتخرج به جماعة منهم أبو حيان الأندلسي.
نقل عن الشيخ تقي الدين بن تيمية ان ابن عصفور لم يزل يرجم بالنارنج في مجلس الشراب إلى أن مات ولم يوضح الناقلون لهذه الحكاية الغريبة مستندها ولعلها تلفيق من بعض الخصوم الذين لا يتورعون عن الكذب والاختلاق، مع ان المترجمين لابن عصفور من الأندلسيين والمغاربة لم يشيروا إلى هذه الحكاية ادنى اشارة، ولا غمزوا سيرته الشخصية بأدنى مغمز، وذكر المؤرخون التونسيون سببا آخر لموته وهم أعرف بهذا من غيرهم لوفاته في بلدهم. وكان سبب موته فيما نقل الشيخ القلشاني وغيره أنه دخل على السلطان محمد المستنصر الحفصي يوما وهو جالس برياض أبي فهر في اريانة في القبة التي على الجابية الكبيرة، فقال السلطان على جهة الفخر مصراع بيت كأنه يريد إجازته: «قد أصبح ملكنا الغداة عظيما» فقال ابن عصفور: «بنا وبأمثالنا».
فوجد منها السلطان وأسرها، ولما قام ابن عصفور ليخرج أوعز إلى بعض خواصه أن يقذفه بثيابه في الجابية، وتثاقل الحاضرون على إخراجه من الجابية المذكورة، وأوصاهم بأن لا يتركوه يصعد مظهرين اللعب معه فكلما أراد الصعود ردوه، وكان اليوم شديد البرد، وبعد صعوده أصابه برد وحمى، وبقي ثلاثة أيام ومات في ليلة الأحد 25 ذي القعدة /669 أوت 1271، ودفن بمقبرة ابن مهنا قرب جبانة ابن نفيس شرقي باب ينتجمي أحد أبواب القصبة، وسبب دخول ابن عصفور على السلطان المستنصر انه رتب أعلاما لمجالسته منهم ابن عصفور، وابن الابار، وأبو المطرف بن عميرة، وأبو بكر بن سيد الناس وغيرهم. إن ابن عصفور كان شيخ المستنصر ثم جليسه ومع ذلك لم يستنكف عن تعريضه للموت غيلة وغدرا لأن الأرواح البشرية لا تساوي شيئا عند الطغاة الحريصين على الأبهة
والناموس. ولتلميذه أحمد بن يوسف الكناني «الدر المنثور في أخبار ابن عصفور» وهو كتاب مفقود.
مؤلفاته:
1) إنارة الدياجي.
2) البديع في شرح المقدمة الجزولية قيل لم يتمها ابن عصفور وإنما تلميذه الشلوبين الصغير محمد بن علي المالقي الأنصاري المتوفي في حدود سنة 670/ 1272.
3) شرح الأشعار الستة.
4) شرح جمل الزجاجي منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس بها نقص، ونسخ في مكتبة بني جامع وفي ليدن وفي المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية وفي الأمير وسيانا، منه مصورتان في معهد المخطوطات العربية.
5) شرح ديوان المتنبي.
6) شرح ديوان الحماسة.
7) شرح كتابة المقرب ذكره في خزانة الأدب 1/ 30 - 31.وقيل إن هذه الشروح لم يكملها وكتاب شرح المقرب ألفه بطلب من أحد الملوك الحفصيين بتونس شرح فيه المسائل المشكلة من كتاب المقرب منه نسخة في جامعة استانبول، ونسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية.
8) سرقات الشعراء.
9) الشرائر الشعرية نقل عنه مرات عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» وفي «شرح شواهد المغني».
10) شرح الإيضاح.
11) شرح أبيات الإيضاح قال الغبريني: «ولم يسبقه أحد بمثله» وكلامه في جميع تأليفه سهل منسبك محصل. والذي قيده عنه أصحابه أكثر من
تآليفه النحوية، على أن له مشاركة في علم المنطق ولأجل ذلك حسن إيراده فيها تقسيما وحدودا واستعمال الأدلة وبالجملة فيليق كلامه مقدما على كلام غيره من المعبرين من النحاة».
12) كتاب المفتاح.
13) المقرب، وهو من أهم آثاره التي حازت شهرة، وتناوله النحاة بالشرح والتعليق والتهذيب والاختصار ألفه بإشارة من الأمير العالم أبي زكرياء الحفصي كما ذكر ذلك في ديباجة الكتاب، وبين له منهج التأليف ... «إلى وضع تأليفه منزه عن الأطناب الممل، والاختصار المخل، يحتوي على كلياته، مشتمل على فصوله وغاياته، عار من إيراد الخلاف والدليل، مجرد أكثره من ذكر التوجيه والتعليل، ليشرف الناظر فيه على جملة العلم في أقرب زمان ويحيط بمسائله في أقصر أوان، فوضعت في ذلك كتابا صغير الحجم، مقربا للفهم، ورفعت فيه من علم النحو شرائعه، وملكته عصيه وطائعه وذللته للفهم بحسن الترتيب، وكثرة التهذيب لألفاظه والتقريب، حتى صار «تمنعا إلى القلب أسرع من لفظه إلى السمع فلما أتيت به على القدح «منعا على القدح مشبها للعقد في التئام أصوله وانتظام فصوله سميته بالمقرب ليكون أسسه وفق معناه، ومترجما عن فحواه».
والظاهر أنه ألف الكتاب للمبتدئين، وتوخى فيه التبسيط والتوضيح والبعد عن إيراد الخلافات مع حسن التنسيق والترتيب، ومما يتميز به هذا الكتاب: البراعة والدقة في التعاريف، أكثر الاقتباس من تعاريفه أمثال ابن هشام، والأشموني، وابن يعيش غلبة المنطق عليه والذي يلاحظ أنه بالرغم من اقتباسه اصطلاحات قليلة من الكوفيين مثل «حروف الخفض» وبعض آرائهم إلا أنه متبع في الأصول المذهب البصري القائم على القياس وما كان مخالفا للقياس يعد شاذا، وهو خلاف مذهب الكوفيين.
في الاعتداد بالشاذلي في جواز الاستعمال، وإذن مذهبه انتقائي يأخذ من الكوفي والبصري مع التقيد بأصول المذهب البصري، وهذا المذهب الانتقائي ظهر منذ القرن الرابع مع أبي علي الفارسي وغيره وانتقلت عدواه إلى الأندلس، واستمر قائما حيا لدى كبار النحاة ومنهم ابن هشام صاحب «المغني» والقسم الأخير من الجزء الثاني من الكتاب مخصص للتصريف، ط الكتاب في مط العاني ببغداد 1399/ 1971 - 1392/ 1972، جزءان، وهو الكتاب الثالث من سلسلة إحياء التراث الإسلامي التي تصدرها رئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية، وصدر الكتاب بتحقيق الدكتور عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري.
14) مثل المقرب، منه نسخة في دار الكتب المصرية رقم 1911 كتبت نحو سنة 127 تقع في خمسين ورقة ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية.
15) الممتع في التصريف، ط في حلب سنة 1390/ 1970، المط العربية 2 جزءان بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة.
16) مختصر الغرة.
17) مختصر المحتسب.
18) المقنع، مخطوط في مكتبة القرويين بفاس.
19) كتاب الهلالية، وسماه بعضهم الهلال القدير على اسم القائد هلال من القواد العلوج في عهد المستنصر.
20) تفسير جزء من القرآن، قال الغبريني: «وسلك فيه مسلكا لم يسبق إليه من الإيراد والإصدار والاعذار وما يتعلق بالألفاظ ثم المعاني، ثم بإيراد الأسئلة الأدبية على انحاء مستحسنة» انفرد بذكره الغبريني في «عنوان الدراية» وقال قبل ذلك مثنيا على تآليفه «وتآليف أبي الحسن - رحمه
الله - في العربية من أحسن التصانيف ومن أجل الموضوعات والتآليف».
21) منظومة في النحو.
المصادر والمراجع:
- اتحاف أهل الزمان 1/ 162، الأعلام 5/ 27 (ط 5/)، ايضاح المكنون 1/ 527، بغية الوعاة 2/ 216، البلغة في تاريخ أئمة اللغة 169 - 70، تاريخ الأدب العربي في العراق عباس العزاوي 1/ 176 - 7، تاريخ الدولتين 29 - 30، تاريخ ابن الوردي (بيروت 1389/ 1971) 1/ 197، 315 - 16، تاريخ معالم التوحيد 179، الذيل والتكملة 1/ 444/5، رحلة العبدري 37 - 8، شجرة النور الزكية 197، شذرات الذهب 5/ 330، صلة الصلة لأبي جعفر بن الزبير 142 - 3، العبر للذهبي 5/ 292، عنوان الدراية (ط 2/) 266 - 8، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية 123 وتعليقات أواخر الكتاب 244 - 5 فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس 77، فوات الوفيات 2/ 184 - 5، كشف الظنون 527 (ومواضع كثيرة أحصاها صاحب معجم المؤلفين)، مسامرات الظريف 108 (عرضا في ترجمة حفيده محمد بن محمد أمام جامع الزيتونة) معجم المؤلفين 7/ 251، مفتاح السعادة (ط 1/) 1/ 118، المقدمة التي كتبها محققا كتاب «المقرب» (ابن عصفور حياته وآثاره)، نزهة الأنظار 1/ 218، 19، هدية العارفين 1/ 712، الوفيات لابن قنفذ 51، دائرة المعارف الإسلامية (بالفرنسية الطبعة الجديدة) 3/ 987، بقلم ج تروبو J.Troupeau وانظر عن ابن عصفور جمهرة الأنساب لابن حزم 340، محمد العروسي المطوي أثر الهجرة الأندلسية في المجتمع الحفصي، مجلة الاذاعة والتلفزة، ع 388 س 17، 15 أكتوبر 1976، ذيل كشف الظنون تعليقات وتقييدات الشيخ آقا بزرك الطهراني ملحق في آخر الجزء الثاني من هدية العارفين ص 101 مطبوع بالأوفسيت في بيروت عن طبعة استانبول سنة 1955.
دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان-ط 2( 1994) , ج: 3- ص: 391
ابن عصفور علي بن مؤمن بن محمد بن علي، العلامة ابن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي، حامل لواء العربية بالأندلس. أخذ عن الأستاذ أبي الحسن الدباج. ثم من الأستاذ أبي علي الشلوبين، وتصدر للأشغال مدة. لازم أبا علي نحوا من عشرة أعوام، إلى أن ختم عليه كتاب سيبويه في نحو السبعين طالبا. قال العلامة أبو حيان: الذي نعرفه أنه ما أكمل عليه الكتاب أصلا. وكان أصبر الناس على المطالعة، لا يمل من ذلك. وأقرأ بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ومرسية. قال ابن الزبير: لم يكن عنده ما يؤخذ عنه سوى ما ذكر - يعني العربية - ولا تأهل لغير ذلك. قال الشيخ شمس الدين: ولا تعلق له بعلم القراءات، ولا الفقه، ولا الحديث. وكان يخدم للأمير أبي عبد الله محمد ابن أبي زكرياء الهنتاتي، صاحب تونس.
ولد سنة سبع وتسعين وخمس مائة بإشبيلية، ومات بتونس، في رابع عشرين ذي القعدة، سنة ثلاث وستين وست مائة، وقيل سنة تسع وستين وست مائة. ولم يكن بذاك في الورع. قلت: كان الشيخ تقي الدين بن تيمية يدعي أنه لم يزل يرجم بالنارنج في مجلس شراب إلى أن مات.
ومن تصانيفه: كتاب الممتع، وكتاب المفتاح، وكتاب الهلال، وكتاب الأزهار، وكتاب إنارة الدياجي، وكتاب مختصر الغرة، وكتاب مختصر المحتسب، وكتاب مفاخرة السالف والعذار، وكتاب المقرب في النحو يقال: إن حدوده مأخوذة من الجزولية، وزاد فيها ما أورد على الجزولية، وهو نسختان، وكتاب البديع شرح الجزولية، وشرح المتنبي. وسرقات الشعراء، وشرح الأشعار الستة، وشرح المقرب، وشرح الحماسة، وهذه الشروح لم يكملها، وله غير ذلك. ومن شعره:
لما تدنست بالتفريط في كبري | وصرت مغرى بشرب الراح واللعس |
رأيت أن خضاب الشيب أستر لي | إن البياض قليل الحمل للدنس |
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 22- ص: 0