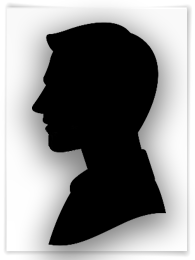صفي الدين الحلي
صفي الدين الحلي عبد العزيز بن سرايا بن علي بن ابي القاسم السنبسي الطائي: شاعر عصره. ولد ونشأ في الحلة (بين الكوفة وبغداد) واشتغل بالتجارة، فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها، في تجارته، ويعود إلى العراق. وانقطع مدة الدولة الارتقية، ومدحهم، واجزلوا له عطاياهم. ورحل إلى القاهرة سنة 726هـ ، فمدح السلطان الملك الناصر. وتوفى ببغداد. له (ديوان شعر - ط) و (العاطل الحالي - ط) رسالة في الزجل والموالي، و (الاغلاطي - خ) معجم للاغلاط اللغوية، و (درر النحور - خ) وهي قصائده المعروفة بالارتقيات، و (صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء - خ) و (الخدمة الجليلة - خ) رسالة في وصف الصيد بالبندق. وللشيخ علي الحزين المتوفي سنة 1181 كتاب (اخبار صفي الدين الحلي ونوادر اشعاره).
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 4- ص: 17
صفي الدين الحلي اسمه عبد العزيز بن سرايا بن علي.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 7- ص: 389
صفي الدين الحلي عبد العزيز بن نجم الدين سرايا ابن علي بن أبي القاسم الحسين بن سرايا
ولد في الحلة سنة677 أما مكان وفاته فاختلف فيه فقيل في بغداد وقيل بماردين وقيل في القاهرة كذلك اختلف في سنة وفاته فقيل سنة749 أو 750 أو 752. نشأ نشأة مترفة كغيره من أبناء الوجهاء وتعلم الفروسية والرماية والصيد ولم يهمل تثقيف نفسه فحفظ القرآن ودرس العلوم الإسلامية من لغة وتفسير وحديث وفقه وفلسفة وما يستتبع ذلك من شتى المعارف. اضطرب الأمر في الحلة ونالته أحداثها وقتل خاله (صفي الدين ابن محاسن) فساهم في معارك الأخذ بثأره وحرض عليها واضطر للالتجاء إلى ماردين، وكان يحكمها الملوك الأرتقيون، فأكرم الملك المنصور نجم الدين غازي وفادته وكذلك ولده الملك الصالح بعده، فمدح الأرتقيين ووقف شعره عليهم، وحج إلى بيت الله وزار مصر فكان له فيها صداقات مع الشاعر جمال الدين محمد بن نباتة والكاتب المؤرخ صلاح الدين الصفدي والقاضي علاء الدين بن الأثير كاتب السر. وهو الذي قدمه إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون فعني الملك به وطلب إليه أن يجمع ديوانه فجمعه له في الناصر المدائح الطوال وعاد من مصر إلى ماردين ثم إلى العراق وزار كثيرا من أهم البلاد في تجارته التي كان يتعاطاها سواء وهو في العراق أو ماردين. وفي العراق ظل على صلته بالأرتقيين يمدحهم ويرسل إليهم الشعر كقوله:
وكم قصدت بلادا كي أمر بكم | وأنتم القصد لا مصر ولا حلب |
أثر الأحداث في شعره
بدأ تحريضه على الأخذ بالثأر لخاله في كثير من شعره كقوله:
لا تترك الثأر من قوم مرادهم | إخفاء ذكر لنا في الناس منتشر |
سل الرماح العوالي عن معالينا | واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا |
يا يوم وقعة زوراء العراق وقد | دنا الأعادي كما كانوا يدينونا |
بخيل ما ربطناها مسومة | إلا لنغزو بها من بات يغزونا |
وسائلي العرب والأتراك ما فعلت | في أرض قبر عبيد الله أيدينا |
كل الذين غشوا الوقيعة قتلوا | ما فاز منهم سالما إلا أنا |
ليس الفرار علي عارا بعدما | شهدوا ببأسي يوم مشتبك القنا |
إن كنت أول من نأى عن أرضهم | قد كنت يوم الروع أول من دنا |
أبعدت عن أرض العراق ركائبي | علما بأن الحزم نعم المقتنى |
شفها السير واقتحام البوادي | ونزولي في كل يوم بوادي |
ومقيلي ظل المطية والتر | ب فراشي وساعداها وسادي |
وضجيعي ماضي المضارب عضب | أصلحته القيون من عهد عاد |
أبيض أخضر الحديدة مما | شق قدما حرائر الأجساد |
وقميصي درع كأن عراها | حبك النمل أو عيون الجماد |
ونديمي لفظي وفكري أنيسي | وسروري مائي وصبري زادي |
وإذا ما هوى الظلام فكم لي | من نجوم الظلام في الليل هادي |
جبت البلاد متخذا بها | مسكنا ولم أرض الثريا موطنا |
حتى أنخت بماردين مطيتي | فهناك قال لها الزمان: لك الهنا |
ولكن لي في ماردين معاشرا | شددت بهم لما حللت أزري |
ملوك إذا ألقى الزمان حباله | جعلتهم في كل نائبة ذخري |
#فارقت زوراء العراق وإن لي قلبا أقام بربعه المألوف وفي تعاطيه التجارة يقول في الملك الصالح:
تقول لي العلياء إن زرت ربعه | رويدك كم في الأرض تشقى وتكدح |
إذا كنت ترضى أن تعد بتاجر | هلم ففيه تاجر المدح يربح |
أعد إذا فارقت مغناك تاجرا | فإن أبت ظنوني شريكك في الملك |
كان الأرتقيون حكام ماردين في ظل السيطرة المغولية، ولما ذهب السلطان غازان المغولي لفتح الشام كان الملك المنصور معه، ولكنه على رواية ابن الأثير كان يناصح سرا الملك الناصر محمد بن قلاوون، وإذا كان المغول في ذلك الحين هم حكام العراق فعلا فإنهم لم يكونوا كذلك فيما نأى من الأطراف كماردين التي كانت سيطرتهم عليها سيطرة غير عملية. والأرتقيون وإن كانوا أتراكا إلا أنهم كانوا يستجيدون الشعر العربي ويستنشدونه ويطربون للمدائح، ولا بدع فالثقافة العربية واللسان العربي هما السائدان، لذلك استقبل صفي الدين في البلاط الأرتقي استقبالا حافلا واحتضنه الملك المنصور وأكرمه، وأنشد صفي الدين في مدائحه مطولات القصائد، حيى إنه اختصه بديوان كبير سماه (درر النحو في مدائح الملك المنصور) التزم فيه أن يكون أول البيت وقافيته على حرف ولحد، فإذا كانت همزية كانت أوائل البيت كذلك كقوله:
أبت الوصال مخالفة الرقباء | وأتتك تحت مدارع الظلماء |
أصفتك بعد الصدود مودة | وكذا الدواء يكون بعد الداء |
بدت لنا الراح في تاج من الحبب | فمزقت حالة الظلماء باللهب |
بكر أذا زوجت بالماء أولدها | أطفال در على مهد من الذهب |
بقية من بقايا قوم نوح إذا | لاحت جلت ظلمة الأحزان والكرب |
تاب الزمان من الذنوب فوات | وأغنم لذيذ العيش قبل فوات |
تم السرور بنا فقم يا صاحبي | نستدرك الماضي بنهب الآتي |
تاقت إلى شرب المدام نفوسنا | لا تذهبن بطالة الأوقات |
تسع وعشرون قد عدت قصائدها | ومثلها عدد الأبيات في النسق |
لم أقتنع بالقوافي في أواخرها | حتى لزمت أواليها فلم تفق |
يا ابن الذي كفل الأنام كأنما | أوصاه آدم في كلاية ولده |
المالك المنصور والملك الذي | جاز الفخار بجده وبجده |
أصل به طابت مآثر مجدكم | والغصن يظهر طيبه من ورده |
ولذاك لم يرني بمنظر شاعر | تبغي قصائده جوائز قصده |
ولقد عهدت إلى عرائس فكرتي | أن لا تزف لغيره من بعده |
لكنك الفرع الذي هو أصله | شرفا ومجدك بضعة من مجده |
مدحي لمجدك عن وداد خالص | وسواي يضمر صابه في شهده |
أنا لا أروم به الجزاء لأنه | ثمر أنزه خلتي عن ورده |
لا كالذي جعل القريضة بضاعة | متوقعا كسب الغنى من كده |
كم قد أبدت من الأعداء من فئة | تحت العجاج وكم فرقت من فرق |
رويت يوم لقاهم كل ذي ظمأ | في الحرب حتى جلال الخيل بالعرق |
مزقت بالموصل الحدباء شملهم | في مأزق بوميض البرق ممتزق |
و لكن لي في ماردين معاشرا | شددت بهم لما حللت بها أزري |
ملوك إذا ألقى الزمان حباله | جعلتهم في كل نائبة ذخري |
و ما أحدثت أيدي الزمان إساءة | ووافيتهم إلا انتقصت من الدهر |
و إذا ما غرقت في لجج الهم | ففي ماردين ملقى المراسي |
بلدة ما أتيتها قط إلا | خلتها بلدتي ومسقط رأسي |
بذلوا لي مع السماحة ودا | هو منهم يزيد في إيناسي |
وقيدتني عندهم أنعم | هن قيد الأمل السائح |
ووكلت فكري بمدحي لهم | مكارم المنصور والصالح |
ألا بلغ هديت سراة قومي | بحلة بابل عند الورود |
ألا لا تشغلوا قلبا لبعدي | فإني كل يوم في مزيد |
لأني قد حللت حمى ملوك | ربوع عبيدهم كهف الطريد |
فمن يك نازلا بحمى كليب | فأني قد نزلت حمى الأسود |
عذرتك حين حلت وأنت بحر | لأن البحر في مد وجزر |
لا تخش يا ربع الحبيب همودا | فلقد أخذت على المعاد عهودا |
وكما مدح الأرتقيين، كذلك رثاهم، فقد مات الملك المنصور وصفي الدين في بغداد فأسرع إلى ماردين يشاطر في المأتم ويبكي الرجل الذي حماه وآواه فمن رثائه له القصيدة التي يقول فيها:
وما كان يدري من تميم جوده | ونكب لج البحر أيهما البحر |
صفائح أرزاق العباد بكفه | فيمنى بها يمن ويسرى بها يسر |
كان للترحل الطويل الذي عاشه سواء في نزوحه اضطرارا إلى ماردين أو تنقله للتجارة أو سفره للحج - كان لذلك أثر بارز في شعره فرأينا فيه ملامح لكل البلاد التي حل بها:
فكل يوم لي برغم العلا | في كل أرض غربة وانتزاح |
عين البرود برود عيني | إن عز منظر رأس عين |
أرض ينمق زهرها | ما فاض من نهر وعين |
ويظل يرفدها السحاب | بصوب وسمي وعين |
وأخضر ودايها وحدق زهره | والنيل فيه ككوثر بجنان |
وبه الجواري المنشآت كأنها | أعلام بيد أو فروع قنان |
نهضت بأجنحة القلوع كأنها | عند المسير تهم بالطيران |
والماء يسرع بالتدفق كلما | عجلت عليه يد النسيم الواني |
إن جزت (بالمطيور) مبتهجا به | ونظرت ناظر دوحه الممطور |
وارتك بالآصال خفق هوائه | الممدود في ظل الهوى المقصور |
سل بأنه المنصوب أين حديثه | المرفوع من ذيل الصبا المجرور |
فحبذا العاصي وطيب شعبه | ومائه المسلسل المجمد |
والفلك فوق لجه كأنها | عقارب تدب فوق مبرد |
وناجم الأزهار من منظم | على شواطيه ومن منضد |
والورق من فوق الغصون قد حكت | بشدوها المطرب صوت معبد |
أطلعت داعي الهوى رغما على العاصي | لما نزلت على ناعورة العاصي |
والريح تجري رخاء فوق جدولها | والطير ما بين بناء وغواص |
وقد تلاقت فروع الدوح واشتبكت | كأنما الطير منها فوق أقفاص |
رغد العيش الذي ناله في ماردين وصحبة الملوك ومتارفهم لم تشغله عن الحنين إلى موطنه بل ظل دائم التطلع إليه بقلبه:
أحباي في الفيحاء إن طال بعدكم | فأنتم إلى قلبي كسحري من نحري |
أترى البازي الذي لاح ليلا | مر بالحي مت مدامع ليلى |
وترى السحب مذ نشأن ثقالا | سحبت من ربوع بابل ذيلا |
ما أضا البارق العراقي إلا | أرسلت مقلتي من الدمع سيلا |
كيف أنسى تلك الديار ومغنى | عامرا قد ربيت فيه طفيلا |
إن وردت الفيحاء يا سائق العيس | وشارفت دوحها والنخيلا |
ورأيت البدر في (مشهد الشمس) | يغشيان بأنه والأثيلا |
مل إليها واحبس قليلا عليها | إن لي نحو ذلك الحي ميلا |
وأبلغ الرملة الأنيقة وأبلغ | معشرا لي بربعها وأهيلا |
قد ذممنا بعيد بعدكم العيش | فليت الحمام كان قبيلا |
ورب نسيم مر بي من دياركم | ففاح لنا من طيبه طيب النشر |
فاذكرني عهدا وما كنت ناسيا | ولكنه تجديد ذكر إلى ذكر |
تجاذبني الأشواق نحو دياركم | واحذر من كيد العدو الذي يدري |
هب النسيم عراقيا فشوقني | وطالما هب نجديا فلم يشق |
فما تنفست والأرواح سارية | إلا إذا اشتكت نسمات الريح من حرقي |
كان شيعيا عارفا بحق علي وبنيه معرفة مرتكزة إلى الإيمان الصادق المخلص، ولا بدع في ذلك فقد شب في الحلة، والحلة هي من هي عراقة في التشييع العالم المفكر الناضج فقد كانت دار العلم وإليها الرحلة من كل مكان وفيها حلقات الدروس ونوادي الفكر والقلم وفيها يقول عبد الرحمن الكتاني المتوفى سنة629 في راجح الحلي:
يقولون لي ما بال حظك ناقصا | لدى راجح رب السماحة والفضل |
فقلت لهم: إني سمي ابن ملجم | وذلك اسم لا يقول به حلي |
وآلك الغرر اللائي بها عرفت | سبل الرشاد فكانت مهتدى الفرق |
حديث حبي لكم سائر | وسرور ودي في هواكم مقيم |
قد فزت كل الفوز إذ لم يزل | صراط ديني بكم مستقيم |
أقوال فيه
وفي مل الآمل: كان عالما فاضلا منشئا أديبا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي له القصيدة البديعية مائة وخمس وأربعون بيتا تشتمل على مائة وخمسين نوعا من أنواع البديع وله شرحها وديوان شعر كبير وديوان صغير وله قصائد محبوكات الطرفين جيدة ثمان وعشرون بيتا ’’اه’’. وفي حديقة الأفراح مناهل ألفاظه العذاب صافية من شوائب التعقيد ورياض معانيه المفرحة بنشرها الألباب شافية لمن كرع من بحرها الرائق المديد ’’اه’’ كان من الشعراء المجيدين المطبوعين وله في شعره احتجاجات على تفضيل علي عليه السلام وتقديمه تدل على علمه وفضله كقوله:
لو رأى مثلك النبي لأخا | ه وإلا فأخطأ الانتقاد |
شعره
ومن شعره قوله في أمير المؤمنين علي عليه السلام من أبيات:
جمعت في صفاتك الأضداد | فلهذا عزت لك الأنداد |
زاهد حاكم حليم شجاع | ناسك فاتك فقير جواد |
شيم ما جمعن في بشر قط | ولا حاز مثلهن العباد |
خلق يخجل النسيم من اللطف | وبأس يذوب منه الجماد |
ظهرت منك للورى معجزات | فقرت بفضلك الحساد |
إن يكذب بها عداك فقد كذ | ب من قبل قوم لوط وعاد |
أنت سر النبي والصنو وبن الـ | ـعم والصهر والأخ المستجاد |
لو رأى مثلك النبي لآخا | ه وإلا فأخطأ الانتقاد |
بكم بأهل النبي ولن يلـ | ـف لكم خامس سواه يزاد |
كنت نفسا له وعرسك وابنا | ك لديه النساء والأولاد |
جل معناك أن يحيط به الشعـ | ـر وتحصي صفاته النقاد |
إنما الله عنكم أذهب الرجـ | ـس فردت بغيظها الأضداد |
ذاك مدح الإله فيكم فإن فهـ | ـت بمدح فذاك قول معاد |
أمير المؤمنين أراك لما | ذكرتك عند ذي حسب صغالي |
وإن كررت ذكراك عند نغل | تكدر صفوه وبغى قتالي |
فها أنا قد خبرت بك البرايا | فأنت محك أولاد الحلال |
فو الله ما اختار الإله محمدا | حبيبا وبين العالمين له مثل |
كذلك ما اختار النبي لنفسه | عليا وصيا وهو لابنته بعل |
وصيره دون الأنام أخا له | وصنو وفيهم من له دونه الفضل |
وشاهد عقل المرء حسن اختياره | فما حال من يختاره الله والرسل |
توال عليا وأبناءه | تفز في المعاد وأهواله |
إمام له عقد يوم الغديـ | ـر بنص النبي وأقواله |
له في التشهد بعد الصلاة | مقام يخبر عن حاله |
فهل بعد ذكر إله السما | ء وذكر النبي سوى آله |
يا عترة المختار يا من بهم | يفوز عبد يتولاهم |
أعرف في الناس بحبي لكم | إذ يعرف الناس بسيماهم |
ولائي لآل المصطفى عقد مذهبي | وقلبي من حب الصحابة مفعم |
و ما أنا ممن يستجيز بحبهم | مسبة أقوام عليهم تقدموا |
و لكنني أعطي الفريقين حقهم | وربي بحال الأفضلية أعلم |
فمن شاء تعويجي فإني معوج | ومن شاء تقويمي فإني مقوم |
قيل لي تعشق الصحابة طرا | أم تفردت منهم بفريق |
فوصفت الجميع وصفا إذا ضو | ع أزرى بكل مسك سحيق |
قيل لي من تميل قلت إلى الأر | بع لا سيما إلى الفاروق |
و نحن ورثنا ثياب النبي | فكم تجذبون بأهدابها |
لكم رحمة يا بني بنته | ولكن بنو العلم أولى بها |
بكم بأهل المصطفى أم بهم | فرد العداة بأوصابها |
أعنكم نفى الرجس أم عنهم | لطهر النفوس وألبابها |
و قلت ورثنا ثياب النبي | فكم تجذبون بأهدابها |
و عندك لا يورث الأنبيا | ء فكيف حظيتم بأثوابها |
و قولك أنتم بنو بنته | ولكن بنو العم أولى بها |
بنو البنت أيضا بنو عمه | وذلك أدنى لأنسابها |
كيف صبري وأنت للعين قره | وهي ما إن تراك في العام مره |
وبماذا أسر قلبي إذا غبـ | ـت وقد كنت للقلوب مسره |
قسما بالذي أفض على طلـ | ـعتك النور فهي للشمس ضره |
إن يوما أرى جمالك فيه | هو عندي في جبهة الدهر غره |
أيهما المعرض الذي هان عندي | تعبي فيه واحتمال المضره |
راقب الله في حشاشة نفس | إنه لا يضيع مثقال ذره |
وليس صديقا من إذا قلت لفظة | توهم من أثناء موقعها أمرا |
ولكن من أن قطعت بنانه | تيقنه قصدا لمصلحة أخرى |
سوابقنا والنقع والسمر والظبا | وأحسابنا والحلم والبأس والبر |
هبوب الصبا والرعد والبرق والقضا | وشمس الضحى والطور والنار والبحر |
لا يمتطي المجد من لا يركب الخطرا | ولا ينال العلى من قدم الحذرا |
ومن أراد العلى عفوا بلا نعب | قضى ولم يقض من إدراكها وطرا |
لا بد للشهد من نحل يمنعه | لا يجتني النفع من لا يحمل الضررا |
وذي هيف زار في ليلة | فأضحى به الهم في معزل |
فمالت لتقبيله شمعة | ولم تخش من ذلك المحفل |
فقلت لصحبي وقد حكمت | صوارم لحظيه في مقلتي |
أتدرون شمعتنا لم هوت | لتقبيل ذاك الرشا الأكحل |
درت أن ريقته شهدة | فحنت إلى بيتها الأول |
لحا الله الطبيب فقد تعدى | وجاء لقلع ضرسك بالمحال |
أعاق الظبي عن كلتا يديه | وسلط كلبتين على الغزال |
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما | بالطول والطول يا طوبي لو اعتدلا |
يجود بالطول ليلي كلما بخلت | بالطول ليلى وإن جادت به بخلا |
أنشدني لنفسه إجازة ما كتب به إلى صاحب أبي بكر بن القاسم السلامي شعرا:
فلتة كان منك من غير قصد | يا أبا بكر عقد بيعة ودي |
فلهذا إذا تقادم عهد | بيننا خنت ذا وفاء وعهد |
بعض هذا الدلال والإدلال | حال بالهجر والتجنب حالي |
جرت إذ حزت ربع قلبي وإذلا | لي صبر أكثرت من إذلالي |
صفي الدين الحلي بين رأيين
كتب مارون عبود كلمة عن صفي الدين الحلي أجاب عنها حارث الراوي وفيما يلي هذان الرأيان المختلفان: يبدأ الأستاذ مارون عبود رأيه في ’’صفي الدين’’ في ص309 من كتابه ’’الرؤوس’’ حيث يقول: ’’إن خير ما سمعنا من الأصوات في هذه الحقبة، صوتان ارتفعا في آن واحد، أولهما في العراق وهو صوت صفي الدين الحلي، والشاعر الذي استعبدته الصناعة اللفظية حتى اجتمعت في شعره جميع معايبها. كان صفي الدين كالطفيليات يعيش على جذوع الأقدمين، فخمس وضمن، ثم حاول اجتراع العجائب في الشعر - كما كان يظن - فراح ينظم لسلطانه الذي فزع إليه من ظلم المغول قصائد سماها ’’درر النحور في مدائح الملك المنصور’’ وهي تسع وعشرون قصيدة على كل حرف من حروف المعجم، يبدأ بالحرف البيت ثم يختمه، وإليك نموذجا منها:
مغانم صفو العيش أسمى المغانم | هي الظل إلا أنه غير دائم |
ملكت زمام العيش فيها وطالما | ’’رفعت’’ بها لولا وقوع’’الجوازم’’ |
إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم | وأقر السلام على عرب’’بذي سلمن’’ |
’’وهكذا لا نرى للحلي شيئا جديدا - إن كان هذا شيئا - إلا سبقه إلى نظم فنون البديع في قصيدة، ولكن بديعيته لم تصب من السيرورة ما أصابته ’’بديعية’’ الحموي فركدت ريحها. أما شعر الحلي فجار حين يتبع سجيته، ولكنه لا يخرج أبدا من دائرة التقليد فهو يعارض قصيدة المتنبي ليقول من الجناس:
أسلبن من فوق النهود’’ذوائبا’’ | فتركن حبات القلوب’’ذوائبا’’ |
بيض دعاهن الغبي كواعبا | ولو استبان الرشد قال كواكبا |
إن غبت عن عياني | يا غاية الأماني |
فالفكر في ضميري | والذكر في لساني |
ما حال عنك عهدي | ولا انثنى لساني |
شوقي أليك باق | والصبر عنك فاني |
تماشى بأيد كلما وافت الصفا | نقشن به صدر البزاة حوافيا |
فتظل ترقم في الصخور أهلة | بسنا حوافرها وإن لم تنعل |
سلي الرماح العوالي عن معالينا | واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا |
أنا لا أبري صفي الدين من الصناعة اللفظية، مصيبة أبناء زمانه، أما أن تجتمع في شعره جميع معايب الصناعة اللفظية، فقول مردود، لأن أكثر شعره منزه عن هذه المهنة ماخلا شعره الذي يخرج به عن نطاق سجيته فينظمه للبراعة ليس إلا. ولا أدري كيف جاز لمارون عبود أن ينعت ’’صفي الدين’’ - الشاعر المتميز بأصالته، بالطفيلي الذي يعيش على جذوع الأقدمين، كل ذلك لأنه يخمس ويضمن. . . وليس التخميس والتضمين من علامات عجز الشاعر في كل الأحوال، فقد يضيف التخميس والتضمين روعة تفوق روعة الأصل أو تدانيها. أما التخميس والتضمين لمجرد إظهار البراعة فشيء لا شك مرذول يأباه الشاعر المبدع. وتخميسات وتضمينات صفي الدين لم تكن لمجرد إظهار البراعة، وإنما جاءت، في أغلب الأحوال لاتفاقه مع بعض الشعراء في فكرة القصيدة وغايتها. وكثيرا ما يمر صفي الدين بتجربة مماثلة لتجربة شاعر آخر فيكون التخميس والتضمين من دواعي التقاء التجربيين. من ذلك تخميسه للامية ’’السموأل’’ الشهيرة. والمعروف عن هذه اللامية أنها تزخر بالفخر والتحدي، وكان صفي الدين جديرا بالفخر والتحدي لأنه كان من عشيرة عربية ترفض الضيم وتأبى الهوان. .
ولا ندري ما هي’’الجرائم الأدبية التي ارتكبها شاعرنا صفي الدين في نظر الأستاذ مارون؟ أيكون مجرما، في مجال الأدب، لأنه نظم القصائد ’’الطويلة والقصيرة’’؟! والقصائد، بطبيعتها، إما تكون طويلة أو قصيرة. . . أم لأنه نظم ’’الموشحات والأزجال’’؟ ومتى كانت الموشحات والأزجال خالية من الرقة والإبداع لا سيما إذا صدرت عن شاعر موهوب كصفي الدين الحلي، وأما أن تبقى على الألسنة قصيدته ’’النونية’’ المشهورة:
سلي الرماح العوالي عن معالينا | واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا |
نظرة في شعره
ثم يسترسل في الحديث عن شعره فيقول:
من طبيعة الشاعر العربي - لا سيما - في الماضي البعيد - أن يفخر بنسبه وعشيرته وشجاعته وبما يتحلى به من المواهب، فكأنه، يريد بذلك، أن يشعر ممدوحه أنه ليس إنسانا طفيليا لا هم له إلا أن يعيش على صدقات المحسنين الذين رفعتهم الأقدار إلى مستوى البذل والعطاء، وإنما هو إنسان له كرامته وعزته وله من كريم محتده بحبوحة تنعم بها روحه ويشفى جسده. . وليس كل الشعراء سواسية في هذا الشعور وهذه المنزلة من الإحساس الوثاب، فبعضهم طفيلي لا هم له غير أن يستجدي، وليس صفي الدين من هؤلاء على أي حال. . فقد من الله عليه بكرم المحتد وصفاء المعدن وشجاعة القلب وعلو الهمة، إلى غير ذلك من الصفات التي يتحلى بها كبار النفوس عادة. فكيف لا يفخر، وهو ينعم في بحبوحة من هذه الفضائل. ومن طبيعة الشاعر أن يندفع، في صباه، في التغني بمآثر ذاته، مندفعا مع أحلامه الباسقة وأمانيه الفسيحة، وخير ما يشير إلى هذه الحقيقة هو’’بائية’’ صفي الدين التي يقول فيها:
لئن ثلمت حدي صروف النوائب | فقد أخلصت سبكي بنار التجارب |
وفي الأدب الباقي الذي قد وهبنني | عزاء من الأقوال عن كل ذاهب |
فكم غاية أدركتها غير جاهد | وكم رتبة قد نلتها غير طالب |
وما كل وان في الطلاب بمخطئ | ولا كل ماض في الأمور بصائب |
سمت بي إلى العلياء نفس أبيه | ترى أقبح الأشياء أخذ المواهب |
بعزم يريني ما أمام مطالبي | وحزم يريني ما وراء العواقب |
وما عابني جاري سوى أن حاجتي | أكلفها من دونه للأجانب |
وإن نوالي في الملمات واصل | أباعد أهل الحي قبل الأقارب |
وليس حسود ينشر الفضل عائبا | ولكنه مغرى بد المناقب |
سلي الرماح العوالي عن معالينا | واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا |
إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة | وإن دعوا قالت الأيام آمينا |
قوم إذا استخصوا كانوا فراعنة | يوما وإن حكموا كانوا موازينا |
أنا لقوم أبت أخلاقه شرفا | أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا |
و أحيانا على بكر أخينا | إذا ما لم نجد إلا أخانا |
ومما قاله عن نفسه:
لما دعتني للنزال أقاربي | لباهم عني لسان المنصل |
وأبيت من أني أعيش بعزهم | وأكون عنهم في الحروب بمعزل |
وافيت في يوم أغر محجل | أغشى الهياج على أغر محجل |
ثار العجاج فكنت أول صائل | وعلا الضرام فكنت أول مصطل |
فغدا يقول كبيرهم وصغيرهم | لا خير فيمن قال إن لم يفعل. . . |
و لما مدت الأعداء باعا | وراع النفس كسرهم سراعا |
برزت وقد حسرت لها القناعا | أقول لها وقد طارت شعاعا |
كما ابتعت العلاء بغير سوم | وأحللت التكال بغير قوم |
ردي كأس الغناء بغير لوم | فإنك لو سئلت بقاء يوم |
فكم أرغمت أنف الضد قسرا | وأفنيت العدى قتلا وأسرا |
و أنت محيطة بالدهر خبرة | فصبرا في مجال الموت صبرا |
عندما صفا العيش لصفي الدين في كنف الملك المنصور غازي وابنه الملك الصالح، حمل شيطان الغزل إلى شاعرنا هبات كثيرة بعضها يعد من الأعلاق، ومن تلك الهبات نونيته التي مطلعها:
قالت: كحلت الجفون بالوسن | قلت انتظارا لطيفك الحسن |
قالت: تسليت بعد فرقتنا | فقلت: عن مسكني وعن سكني |
قالت: تشاغلت عن محبتنا | قلت: بفرط البكاء والحزن |
قالت: تناسيت،قلت: عافيتي | قالت: تناءيت، قلت: عن وطني |
قالت تخليت، قلت: عن جلدي | قالت: تغيرت، قلت:في بدني |
فقالت: تخصصت دون صحبتنا | فقلت: بالعين فيك والغبن |
قالت: أذعت الأسرار قلت لها: | صير سري هواك كالعلن |
قالت: سررت الأعداء قلت لها: | ذلك شيء لو شئت لم يكن |
قالت: فماذا تروم؟ قلت لها: | ساعة سعد بالوصل تسعدني |
قالت: فعين الرقيب تنظرنا | قلت: فإني للعين لم أبن |
أنحلتني بالصدود منك فلو | ترصدتني المنون لم ترني! |
يقولون لي، والبدر في الأفق مشرق | بذا أنت صب؟ قلت: بل بشقيقه |
لولا الهوى ما ذاب من حنينه | صب أصابته عيون عينه |
متيم لا تهتدي عواده | إلا بما تسمع من أنينه |
يا جيرة الحي أجيروا عاشقا | ما حاد عن شرع الهوى ودينه |
باطنه أحسن من ظاهره | وشكه أوضح من يقينه |
لا تحسبوا ما ساح فوق خده | مدامعا تسفح من جفونه |
وإنما ذاب جليد قلبه | فطرفه يرشح من معينه |
ولقد ذكرتك والرماح نواهل | مني وبيض الهند تقطر بالدم |
ولقد ذكرتك والسيوف مواطر | كالسحب من وبل النجيع وطله |
فوجدت أنسا عند ذكرك كاملا | في موقف يخشى الفتى من ظله |
ولقد ذكرتك والعجاج كأنه | ظل الغني وسوء عيش المعسر |
والشوس بين مجدل في جندل | منا وبين معفر في معفر |
فظننت إني في صباح مشرق | بضياء وجهك أو مساء مقمر |
ترض الحصى شوقا لمن سبح الحصى | لديه وحيا بالسلام بشيرها |
إلى خير مبعوث إلى خير أمة | إلى خير معبود دعاها بشيرها |
ومن أخمدت مع وضعه نار فارس | وزلزل منها عرشها وسريرها |
محمد خير المرسلين بأسرها | وأولها في الفضل، وهو أخيرها |
أيا آية الله التي قد تبلجت | على خلقه أخفى الضلال ظهورها |
عليك سلام الله يا خير مرسل | إلى أمة لولاه دام غرورها |
عليك سلام الله يا خير شافع | إذا النار ضم الكافرين حصيرها |
عليك سلام الله يا من تشرفت | به الأنس طرا واستتم سرورها |
عليك سلام الله يا من تعبدت | له الجن، وانقادت إليه أمورها |
تشرفت الأقدام لما تتابعت | إليك خطاها واستمر مريرها |
وفاخرت الأفواه نور عيونها | بتربك لما قبلته ثغورها |
فضائل رامتها الرؤوس فقصرت | ألم تر للتقصير جزت شعورها |
ولو وفت الوفاد قدرك حقه | لكان على الأحداث منها مسيرها |
(1) الأغلاطي وهو معجم للأغلاط اللغوية التي يقع فيها الكتاب والأدباء.
(2) وصف الصيد بالبندق.
(3) العاطل الحالي.
(4) الأوزان المستحدثة.
(5) رسالة الدار والغار.
(6) ديوان صفوة الشعراء وخلاصة ا
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 8- ص: 19
الحلي الشاعر صفي الدين عبد العزيز بن سرايا.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 13- ص: 0
صفي الدين الحلي عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن أبي العز بن سرايا بن باقي بن عبد الله بن العريض، هو الإمام العلامة البليغ المفوه، الناظم الناثر، شاعر عصرنا على الإطلاق، صفي الدين الطائي السنبسي الحلي. شاعر أصبح به راجح الحلي ناقصا، وكان سابقا فعاد على عقبه ناكصا، أجاد القصائد المطولة والمقاطيع، وأتى بما أخجل زهر النجوم في السماء فما قدر زهر الأرض في الربيع، تطربك ألفاظه المصقولة، ومعانيه المعسولة، ومقاصده التي كأنها سهام راشقة وسيوف مسلولة.
مولده يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وست مائة، دخل إلى مصر أيام الملك الناصر في سنة ست وعشرين وسبع مائة تقريبا وأظنه وردها مرتين، واجتمع بالقاضي علاء الدين بن الأثير كاتب السر ومدحه وأقبل عليه، واجتمع بالشيخ فتح الدين ابن سيد الناس وغيره، وأثنى فضلاء الديار المصرية عليه. وأما شمس الدين عبد اللطيف فإنه كان يظن أنه لم ينظم الشعر أحد مثله - لا في المتقدمين ولا في المتأخرين- مطلقا، ورأيت عنده قطعة وافرة من كلامه بخطه نقلت منها أشياء.
اجتمعت به بالباب وبزاعه من بلاد حلب في مستهل ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة، وأجاز لي بخطه جميع ما له من نظم ونثر وتأليف مما سمعته منه، وما لم أسمعه وما لعله يتفق له بعد ذلك التاريخ على أحد الرائين وما يجوز له أن يرويه سماعا وإجازة ومناولة ووجادة بشرطه، وقلت وقد بلغتني وفاته رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وسبع مائة:
إن فن الشعر نادى | في جميع الأدباء |
أحسن الله تعالى | في الصفي الحلي عزائي |
للترك ما لي ترك | ما دين حيي شرك |
حواجب وعيون | لها بقلبي فتك |
كالقوس يصمي، وهذي | تشكي المحب وتشكو |
وإذا العداة أرتك فر | ط مذلة فإليك عنها |
وإذا الذئاب استنعجت | لك مرة فحذار منها |
لا غرو أن يصلي الفؤاد بذكركم | نارا تؤججها يد التذكار |
قلبي إذا غبتم يصور شخصكم | فيه، وكل مصور في النار |
يقبل الأرض عبد تحت ظلكم | عليكم بعد فضل الله يعتمد |
ما دار مية من أسنى مطالبه | يوما، وأنتم له العلياء فالسند |
وأغر تبري الإهاب مورد | سبط الأديم محجل ببياض |
أخشى عليه بأن يصاب بأسهم | مما يسابقني إلى الأغراض |
وأدهم يقق التحجيل ذي مرح | يميس من عجبه كالشارب الثمل |
مضمر مشرف الأذنين تحسبه | موكلا باستراق السمع عن زحل |
ركبت منه مطا ليل تسير به | كواكب تلحق المحمول بالحمل |
إذا رميت سهامي فوق صهوته | مرت بهاديه وانحطت عن الكفل |
نشكي المحب وتشكو وهي ظالمة | كالقوس تصمى الرمايا وهي مريان |
وإذا الذئاب استنعجت لك مرة | فحذار منها أن تعود ذئابا |
والذئاب أخبث ما يكون إذا اكتسى | من جلد أولاد النعاج ذئابا |
سوابقنا والنقع والسمر والظبى | وأحسابنا والحلم والبأس والبر |
هبوب الصبا والليل والبرق والقضا | وشمس الضحى والطود والنار والبحر |
لئن لم أبرقع بالحيا وجه عفتي | فلا أشبهته راحتي في التكرم |
ولا كنت ممن يكسر الجفن في الوغى | إذا أنا لم أغضضه عن رأي محرم |
لا يسمع العود منا غير خاضنه | من لبة الشوس يوم الروع بالعلق |
ولا يعاطى كميتا غير مصدره | يوم الصدام بليل العطف بالعرق |
أود حسادي أن يكثروا | وأعذر الحاسد في فعله |
لا أفقد الحساد إلا إذا | فقدت ما أحسد من أجله |
أقول للدار إذ مررت بها | وعبرتي في عراصها تكف |
ما بال وعد السحاب أخلف مغـ | ـناك فقالت: في دمعك الخلف |
وساق من بني الأتراك طفل | أتيه به على جمع الرفاق |
أملكه قيادي وهو رقي | وأفديه بعيني وهو ساقي |
وظبي بقفر فوق طرف مفوق | بقوس رمى في النقع وحشا بأسهم |
كشمس بأفق فوق برق بكفه | هلال رمى في الليل جنا بأنجم |
ما زال كحل النوم في ناظري | من قبل إعراضك والبين |
حتى سرقت الغمض من مقلتي | يا سارق الكحل من العين |
رب يوم قد رفلت به | في ثياب اللهو والمرح |
أشرقت شمس المدام به | وجبين الشمس لم يلح |
فظللنا بين مغتبق | محياها ومصطبح |
وشدت في الدوح صادحة | بضروب السجع والملح |
كلما ناحت على شجن | خلتها غنت على قدحي |
طلبت نديما يوجد الراح راحة | إذا الراح أودت بالقليل من العقل |
يشاركني في شربها وشروطها | فيسمع أو يحسو، ويملأ أو يملي |
ومشرق الوجه بماء الحيا | حيا بوجه كله أعين |
قبلته ثم تقبلته | بين وجوه كلها أعين |
وقلت: وقيت صروف الردى | وانصرفت عن وجهك الأعين |
أحن إليكم كما ذر شارق | ويرتاح قلبي كلما مر خاطف |
وأهتز من خفق النسيم إذا سرى | ولولاكم ما حركتني العواصف |
ولقد ذكرتك والعجاج كأنه | مطل الغني وسوء عيش المعسر |
والشوس بين مجدل في جندل | منا، وبين معفر في مغفر |
فظننت أني في صباح مسفر | بضياء وجهك أو مساء مقمر |
وتعطرت أرض الكفاح كأنما | فتقت لنا ريح الجلاد بعنبر |
ولقد ذكرتك والسيوف مواطر | كالسحب من وبل النجيع وطله |
فوجدت أنسا عند ذكرك كاملا | في موقف يخشى الفتى من ظله |
ولقد ذكرتك والجماجم وقع | تحت السنابك والأكف تطير |
والهام في أفق العجاجة حوم | فكأنها فوق النسور نسور |
فاعتادني من طيب ذكرك نشوة | وبدت علي بشاشة وسرور |
فظننت أني في مجالس لذتي | والراح تجلى والكؤوس تدور |
أطلقت نطقي بالمحامد عندما | قيدتني بسوابق الإنعام |
فلتشكرنك نيابة عن منطقي | صدر الطروس وألسن الأقلام |
سأثني على نعماك بالكم التي | يقر لها الحساد في اللفظ والفضل |
بها يطرد السارون عن جفنها الكرى | ويجلب طيب النوم في المهد للطفل |
والله ما سهرت عيني لبعدكم | لعلمها أن طيب الوصل في الحلم |
ولا صبوت إلى ذكر الجليس لكم | لأن ذكركم في خاطري وفمي |
كفى البدر حسنا أن يقال نظيرها | فيزهى ولكنا بذاك نضيرها |
وحسبت غصون البان أن قوامها | يقاس به ميادها ونضيرها |
أسيرة حجل مطلقات لحاظها | قضى حسنها أن لا يفك أسيرها |
تهيم بها العشاق خلف حجابها | فكيف إذا ما آن منها سفورها |
وليس عجيبا أن غررت بنظرة | إليها فمن شأن البدور غرورها |
فكم نظرة قادت إلى القلب حسرة | يقطع أنفاس الحياة زفيرها |
فوا عجبا كم نسلب الأسد في الوغى | وتسلبنا من أعين الحور حورها |
فتور الظبى عند القراع يشينها | وما يرهف الأجفان إلا فتورها |
وجذوة حسن في الخدود لهيبها | يشب ولكن في القلوب سعيرها |
إذا آنستها مقلتي خر صاعقا | فوادي وقال القلب لا دك طورها |
وسرب ظباء مشرقات شموسه | على حلية عند النجوم بدورها |
تمانع عما في الكناس أسودها | وتحرس ما تحوي القصور صقورها |
تغار من الطيف الملم حماتها | ويغضب من مر النسيم غيورها |
إذا ما رأى في النوم طيفا يزورها | توهمه في اليوم ضيفا يزورها |
نظرنا فأعدتنا السقام عيونها | ولذنا فأولتنا النحول خصورها |
وزرنا وأسد الحي تذكي لحاظها | ويسمع في غاب الرماح زئيرها |
فيا ساعد الله المحب فإنه | يرى غمرات الموت ثم يزورها |
ولما ألمت للزيارة خلسة | وسجف الدياجي مسبلات ستورها |
سعى بيننا الواشون حتى حجولها | وثمت بنا الأعداء حتى عبيرها |
وهمت بنا لولا حبائل شعرها | خطى الصبح لكن قيدتها ظفورها |
ليالي يعديني زماني على العدى | وإن ملئت حقدا علي صدورها |
ويسعدني شرخ الشبيبة والغنى | إذا شانها إقتارها وقتيرها |
ومذ قلب الدهر المجن أصابني | صبورا على حال قليل صبورها |
فلو تحمل الأيام ما أنا حامل | لما كاد يمحو صبغة الليل نورها |
سأصبر إما أن تدور صروفها | علي وإما تستقيم أمورها |
فإن تكن الخنساء إني صخرها | وإن تكن الزباء إني قصيرها |
وقد ارتدى ثوب الظلام بحسرة | عليها من الشوس الحماة جسورها |
كأني بأحشاء السباسب خاطر | فما وجدت إلا وشخصي ضميرها |
وصادية الأحشاء غضى بالها | يعز على الشعري العبور عبورها |
ينوح بها الخريت ندبا لنفسه | إذا اختلفت حصباؤها وصخورها |
إذا وطئتها الشمس سال لعابها | وإن سلكتها الريح طال هديرها |
وإن قامت الحرباء ترصد شمسها | أصيلا أذاب اللحظ منها هجيرها |
تجنب عنها للحذار جنوبها | وتدبر عنها في الهبوب دبورها |
خبرت مرامي أرضها فقتلتها | وما يقتل الأرضين إلا خبيرها |
بخطوة مرقال أمون عثارها | كثير على وفق الصواب عثورها |
ألذ من الأنغام رجع بغامها | وأطرب من سجع الهديل هديرها |
نساهم شطر العيش عيسا سواهما | لطول السرى لم يبق إلا سطورها |
حروفا كنونات الصحائف أصبحت | تخط على طرس الفيافي سطورها |
إذا نظمت نظم القلائد في البرى | تقلدها خضر الربى ونحورها |
طواها طواها فاغتدت وبطونها | تجول عليها كالوشاح ظهروها |
يعبر عن فرط الحنين أنينها | ويعرب عما في الضمير ضمورها |
تسير بها نحو الحجاز وقصدها | ملاعب شعبي بابل وقصورها |
فلما ترامت عن زرود ورملها | ولاحت لها أعلام نجد وقورها |
وصدت يمينا عن شميط وجاوزت | ربى قطن والشهب قد شف نورها |
وعاج بها عن رمل عاج دليلها | فقامت لعرفان المراد صدورها |
غدت تتقاضانا المسير لأنها | إلى نحو خير المرسلين مسيرها |
ترض الحصى شوقا لمن سبح الحصى | لديه وحيا بالسلام بعيرها |
إلى خير مبعوث إلى خير أمة | إلى خير معبود دعاها بشيرها |
ومن بشر الله الأنام بأنه | مبشرها عن إذنه ونذيرها |
ومن أخمدت مع وضعه نار فارس | وزلزل منها عرشها وسريرها |
ومن نطقت توراة موسى بفضله | وجاء به إنجيلها وزبورها |
محمد خير المرسلين بأسرهم | وأولها في المجد وهو أخيرها |
فيا آية الله التي مذ تبلجت | على خلقه أخفى الظلال ظهورها |
عليك سلام الله يا خير مرسل | إلى أمة لولاه دام غرورها |
عليك سلام الله يا خير شافع | إذا النار ضم الكافرين حصيرها |
عليك سلام الله يا من تشرفت | به الإنس طرا واستتم سرورها |
عليك سلام الله يا من تعبدت | له الجن وانقادت لديه أمورها |
تشرفت الأقدام لما تتابعت | إليك خطاها واستمر مريرها |
وفاخرت الأفواه نور عيوننا | بتربك لما قبلته ثغورها |
فضائل رامتها الرؤوس فقصرت | ألم تر للتقصير جزت شعورها |
ولو وفت الوفاد قدرك حقه | لكان على الأحداق منها مسيرها |
لأنك سر الله والآية التي | تجلت فجلى ظلمة الشرك نورها |
مدينة علم وابن عمك بابها | فمن غير ذاك الباب لم يؤت سرورها |
شموس لكم في الغرب مدت شموسها | بدور لكم في الشرق حق بدورها |
جبال إذا ما الهضب دكت جبالها | بحور إذا ما الأرض عادت بحورها |
فآلك خير الآل والعترة التي | محبتها نعمى قليل شكورها |
إذا جولست للبذل ذل نضارها | وإن سوجلت في الفضل عز نظيرها |
وصحبك خير الصحب والغرر التي | بهم أمنت من كل أرض ثغورها |
كماة حماة في القراع وفي القرى | إذا شط قاربها وطاش وقورها |
أيا صادق الوعد الأمين وعدتني | ببشرى فلا أخشى وأنت بشيرها |
بعثت الأماني باطلات لتبتغي | نداك فجاءت حاليات نحورها |
وأرسلت آمالا خماصا بطونها | إليك فعادت مثقلات ظهروها |
إليك رسول الله أشكو جرائما | يوازي الجبال الراسيات صغيرها |
كبائر لو تبلى الجبال بحملها | لدكت وناد بالثبور ثبيرها |
وغالب ظني بل يقيني أنها | ستمحى وإن جلت وأنت سفيرها |
لأني رأيت العرب تخفر بالعصا | وتحمي إذا ما أمها مستجيرها |
فكيف بمن في كفه أورق العصا | تضام بنو الآمال وهو خفيرها |
وبين يدي نجواي قدمت مدحة | قضى خاطري أن لا يخيب خطيرها |
يروي غليل السامعين قطارها | وتجلو عيون الناظرين قطورها |
وأحسن شيء أنني قد جلوتها | عليك وأملاك السماء حضورها |
تروم بها نفسي الجزاء فكن لها | مجيرا بأن تمسي وأنت مجيرها |
فلابن زهير قد أجزت ببردة | عليك فأثرى من ذويه فقيرها |
أجرني أجزني واجزني أجر مدحتي | ببرد إذا ما النار شب سعيرها |
وقابل ثناها بالقبول فإنها | عرائس فكر والقبول مهورها |
فإن زانها تطويلها واطرادها | فقد شانها تقصرها وقصورها |
إذا ما القوافي لم تحط بصفاتكم | فسيان منها جمها ويسيرها |
بمدحك تمت حجتي وهي حجتي | على عصبة يطغى علي فجورها |
أقص بشعري إثر فضلك واصفا | علاك إذا ما الناس قصت شعورها |
وأسهر في نظم القوافي ولم أقل | خليلي هل من رقدة أستعيرها |
ولقد أسير على الضلال ولم أقل | أين الطريق وإن كرهت ضلالي |
وأعاف تسآل الدليل ترفعا | عن أن يفوه فمي بلفظ سؤالي |
ولائي لآل المصطفى عقد مذهبي | وقلبي من حب الصحابة مفعم |
وما أنا ممن يستجيز لحبهم | مسبة أقوام عليهم تقدموا |
ولكنني أعطي الفريقين حقهم | وزي بحال الأفضلية أعلم |
فمن شاء تعويجي فإني معوج | ومن شاء تقويمي فإني مقوم |
قيل لي تعشق الصحابة طرا | أم تفردت بينهم بفريق |
فوصفت الجميع وصفا إذا ضو | ع أزرى بكل مسك سحيق |
قيل هذي الصفات والكل كالدر | ياق يشفي من كل داء وثيق |
فإلى من تميل؟ قلت إلى الأر | بع لا سيما إلى الفاروق |
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل | بسقط اللوى بين الدخول وحومل |
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها | لما نسجتها من جنوب وشمأل |
ترى بعر الأرآم في عرصاتها | وقيعانها كأنه حب فلفل |
كأني غداة البين يوم تحملوا | لدى سمرات الحي ناقف حنظل |
وقوفا بها صحبي علي مطيهم | يقولون لا تهلك أسى وتجمل |
وإن شفائي عبرة إن سفحتها | وهل عند رسم دارس من معول |
كذا يك من أم الحويرث قبلها | وجارتها أم الرباب بمأسل |
الكريم مرتجى وإن أصبح بابه مرتجا، والندب يلتقى وإن كان بأسه يتقى. والسحب تؤمل بوارقها وإن رهبت صواعقها. ولحلم سيدنا أعظم من اللحن بعتب لسالف ذنب، فما فتى شرف الله بلثم كفوفه أفواه العباد يغفر الخطيئة ويوفر العطية. والمملوك مقر عرف أنه رب حق بل مالك رق ومقتض من جوده العميم نجاز وعده الكريم فسالف كرمه مقيم لا برح إحسانه شاملا مدى السنين. إن الله يحب المحسنين.
فلما سطروها وسطروها وعدوا أحرفها واعتبروها، سألوا أن أرجع ربعها مأهولا وأعيدها سيرتها الأولى فنظمت:
قفا نبك في أطلال ليلى ونسأل | دوارسها عن ركبها المتحمل |
وننشد من أدراسها كل معلم | محاه هبوب الرامسات ومجهل |
ونأخذ عن أترابها من ترابها | صحيح مقال كالجمان المفصل |
معان هوى أقوى بها دأب بينهم | كدأبي من تبريح قلب مفلفل |
عفت غير سفع من رواكد جثم | تحف بشفع من رواكض جفل |
ووشم أو أرى سحيل مريرها | ليلهى بقاه حول نؤى معطل |
فرفقا بها رفقا وإن هي لم تنج | بلظ ولا تأوي لسائل منزل |
وأنشدني له إجازة من قصيدة طويلة، ونقلت ذلك من خطه:
من نفخة الصور أم من نفخة الصور | أحييت يا ريح ميتا غير مقبور |
أم من شذا نسمة الفردوس حين سرت | علي بليل من الأزهار ممطور |
أم روض رسمك أعدى عطر نفحته | طي النسيم بنشر فيه منشور |
والريح قد أطلقت فضل العنان به | والغصن ما بين تقديم وتأخير |
في روضة نصبت أغصانها وغدا | ذيل الصبا بين مرفوع ومجرور |
قد جمعت جمع تصحيح جوانبها | والماء يجمع فيها جمع تكسير |
والريح ترقم في أمواجها شبكا | والغيم يرسم أنواع التصاوير |
والماء ما بين مصروف وممتنع | والظل ما بين ممدود ومقصور |
والنرجس الغض لم تغضض نواظره | فزهره بين منغض ومزرور |
كأنه ذهب من فوق أعمدة | من الزمرد في أوراق كافور |
والأقحوان زهى بين البهار بها | شبه الدراهم ما بين الدنانير |
وقد أطعنا التصابي حين ساعدنا | عصر الشباب بجود غير منزور |
وزامر القوم يطوينا وينشرنا | بالنفخ في الناي لا بالنفخ في الصور |
وقد ترنم شاد صوته غرد | كأنه ناطق من حلق شحرور |
شاد أنامله ترضى الأنام له | إذا شدا وأجاب اليم بالزير |
بشامخ الأنف قوام على قدم | يشكو الصبابة عن أنفاس مهجور |
شدت بتصحيفه في العضد ألسنه | فزاد نطقا بسر فيه محصور |
إذا تأبطه الشادي وأذكره | عصر الشباب بأطراف الأظافير |
شكت إلى الصحب أحشاه وأضلعه | قرض المقاريض أو نشر المناشير |
بينا ترى خده من فوق سالفة | كمن يشاوره في حسن تدبير |
تراه يزعجه عنفا ويوجعه | بضرب أوتاره عن حقد موتور |
والراقصات وقد مالت ذوائبها | على خصور كأوساط الزنابير |
رأيت أمواج أرداف إذا التطمت | في لج بحر بماء الحسن مسحور |
كأن في الشيز أيديها إذا ضربت | صبح تقلقل فيه قلب ديجور |
ترعى الضروب بأيديها وأرجلها | وتحفظ الأصل من نقص وتغيير |
وتعرب الرقص من لحن فتلحقه | ما يلحق النحو من حذف وتقدير |
وحامل الكأس ساجي الطرف ذو هيف | صاحي اللواحظ يثني عطف مخمور |
كأنما صاغه الرحمن تذكرة | لمن يشكك في الولدان والحور |
تظلمت وجنتاه وهي ظالمة | وطرفه ساحر في زي مسحور |
يدير راحا يشب الماء جذوتها | فلا يزيد لظاها غير تسعير |
نارا بدت لكليم الوجد آنسها | من جانب الكأس لا من جانب الطور |
كأنها وضياء الكأس يحجبها | روح من الماء في جسم من النور |
تشعشعت في يد الساقين واتقدت | بها زجاجاتها من لطف تأثير |
وللأباريق عند المزج لجلجة | كنطق مرتبك الألفاظ مذعور |
كأنها وهي في الأكواب ساكبة | طير تزق فراخا بالمناقير |
أمست تحاول منا ثأر والدها | ودوسه تحت أقدام المعاصير |
فحين لم يبق عقل غير معتقل | من العقار ولب غير معقور |
أجلت في الصحب أجفاني فكم نظرت | ليثا تعفره ألحاظ يعفور |
من كل عين عليها مثل ثالثها | مكسورة ذات فتك غير مكسور |
أقول والكأس قد أبدت فواقعها | والراح تنفث منها نفث مصدور |
أسأت يا مازج الكاسات حليتها | وهل يطوق ياقوت ببلور |
وقائل إذ رأى الجنات عالية | والحور مقصورة بين المقاصير |
والجوسق الفرد في لج البحيرة والـ | ـصرح الممرد فيه من قوارير |
لمن ترى الملك في ذا اليوم؟ قلت له | مقال منبسط الآمال مسرور |
لصاحب التاج والقصر المشيد ومن | أتى بعدل برحب الأرض منشور |
الصالح الملك المشكور نائله | ورب نائل ملك غير مشكور |
كيف الضلال وصبح وجهك مشرق | وشذاك في الأكوان مسك يعبق |
يا من إذا سفرت محاسن وجهه | ظلت به حدق الخلائق تحدق |
أوضحت عذري في هواك بواضح | ماء الحيا بأديمه يترقرق |
فإذا العذول رأى جمالك قال لي | عجبا لقلبك كيف لا يتمزق |
يا آسرا قلب المحب فدمعه | والنوم منه مطلق ومطلق |
أغنيتني بالفكر فيك عن الكرى | يا آسري فأنا الغني المملق |
وصحبت قوما لست من نظرائهم | فكأنني في الطرس سطر ملحق |
قولا لمن حمل السلاح وخضره | ومن قد ذابله أدق وأرشق |
لا توه جسمك بالسلاح وحمله | إني عليك من الغلالة أشفق |
ظبي من الأتراك فوق خدوده | نار يخر لها الكليم ويصعق |
تلقاه وهو مزرد ومدرع | وتراه وهو مقرط ومقرطق |
لم تترك الأتراك بعد جمالها | حسنا لمخلوق سواها يخلق |
إن نوزلوا كانوا أسود عريكة | أو غوزلوا كانوا بدورا تشرق |
قوم إذا ركبوا الجياد ظننتهم | أسدا بألحاظ الجآذر ترمق |
قد خلقت بدم القلوب خدودهم | ودروعهم بدم الكماة تخلق |
جذبوا القسي إلى قسي حواجب | من تحتها نبل اللواحظ ترشق |
نشروا الشعور فكل قد منهم | لدن عليه من الذؤابة صنجق |
لي منهم رشأ إذا قابلته | كاد لواحظه بسحر تنطق |
إن شاء يلقاني بخلق واسع | عند السلام نهاه طرق ضيق |
لم أنس ليلة زارني ورقيبه | يبدي الرضى وهو المغيظ المحنق |
حتى إذا عبث الكرى بجفونه | كان الوسادة ساعدي والمرفق |
عانقته وضممته فكأنه | من ساعدي ممنطق ومطوق |
حتى بدا قلق الصباح فراعه | إن الصباح هو العدو الأزرق |
أسبلن من فوق النحور ذوائبا | فتركن حبات القلوب ذوائبا |
وجلون من صبح الوجوه أشعة | غادرن فود الليل منها شائبا |
بيض دعاهن الغبي كواعبا | ولو استبان الرشد قال كواكبا |
وربائب فإذا رأيت نفارها | من بسط أنسك خلتهن رباربا |
سفهن رأي المانوية عندما | أسبلن من ظلم الشعور غياهبا |
وسفرن لي فرأين شخصا حاضرا | شدهت بصيرته وقلبا غائبا |
أشرقن في حلل كأن أديمها | شفق تدرعه الشموس جلائبا |
وغربن في كلل فقلت لصاحبي | بأبي الشموس الجانحات غواربا |
ومعربد اللحظات يثني عطفه | فيخال من مرح الشبيبة شاربا |
حلو التعتب والدلال يروعه | عتبي ولست أراه إلا عاتبا |
عاتبته فتضرجت وجناته | وازور ألحاظا وقطب حاجبا |
فأراني الخد الكليم وطرفه | ذو النون إذ ذهب الغداة مغاضبا |
ذو منظر تغدو القلوب بحسنها | نهبا وإن منح العيون مواهبا |
لا غرو أن وهب اللواحظ حظوة | من نوره ودعاه قلبي ناهبا |
فمواهب السلطان قد كست الورى | نعما وتدعوه القساور سالبا |
الناصر الملك الذي خضعت له | صيد الملوك مشارقا ومغاربا |
ملك يرى تعب المكارم راحة | ويعد راحات الفراغ متاعبا |
لم تخل أرض من ثناه وإن خلت | من ذكره ملئت قنا وقواضبا |
بمكارم تذر السباسب أبحرا | وعزائم تذر البحار سباسبا |
ترجى مواهب ويرهب بطشه | مثل الزمان مسالما ومحاربا |
فإذا سطا ملأ القلوب مهابة | وإذا سخا ملأ العيون مواهبا |
كالغيث يبعث من عطاه نائلا | سبطا ويرسل من سطاه حاصبا |
كالليث يحمي غابه بزئيره | طورا وينشب في القنيص مخالبا |
كالسيف يبدي للنواظر منظرا | طلقا ويمضي في الهياج مضاربا |
كالسيل يحمد منه عذبا واصلا | ويعده قوم عذابا واصبا |
كالبحر يهدي للنفوس نفائسا | منه ويبدي للعيون عجائبا |
فإذا نظرت ندا يديه ورأيه | لم تلف إلا صيبا أو صائبا |
أبقى قلاوون الفخار لولده | إرثا ففازوا بالثناء مكاسبا |
قوم إذا سئموا الصوافن صيروا | للمجد أخطار الأمور مراكبا |
عشقوا الحروب تيمنا بلقا العدا | فكأنهم حسبوا العداة حبائبا |
وكأنما ظنوا السيوف سوالفا | واللدن قدا والقسي حواجبا |
يا أيها الملك العزيز ومن له | شرف يجر على النجوم ذوائبا |
أصلحت بين المسلمين بهمة | تذر الأجانب بالوفود أقاربا |
ووهبتهم زمن الأمان فمن رأى | ملكا يكون له الزمان مواهبا |
فرأوا خطابا كان خطبا فادحا | لهم وكتبا كن قبل كتائبا |
وحرست ملكك من رجيم مارد | بعزائم إن صلت كن قواضبا |
حتى إذا خطف المنافق خطفة | أتبعته منها شهابا ثاقبا |
لا ينفع التجريب خصمك بعدما | أفنيت من أفنى الزمان تجاربا |
صرمت شمل المارقين بصارم | يبديه مسلوبا فيرجع سالبا |
صافي الفرند حكى صباحا جامدا | أبدى النجيع به شعاعا ذائبا |
وكتيبة تدع الصهيل رواعدا | والبيض برقا والعجاج سحائبا |
حتى إذا ريح الجلاد حدت لها | مطرت وكان الويل نبلا صائبا |
بذوابل ملد يخلن أراقما | وشوائل جرد يخلن عقاربا |
تطأ الصدور من الصدور كأنما | تعتاض عن وطء التراب ترائبا |
فأقمت تقسم للوحش وظائفا | فيها وتصنع للنسور مآدبا |
وجعلت هامات الكماة منابرا | وأقمت حد السيف فيها خاطبا |
يا راكب الخطر الجليل وقوله | فخرا بمجدك لا عدمت الراكبا |
صيرت أسحار السماح بواكرا | وجعلت أيام الكفاح غياهبا |
وبذلت للمداح صفو خلائق | لو أنها للبحر طاب مشاربا |
فرأوك في جنب النضار مفرطا | وعلى صلاتك والصلاة مواظبا |
إن يحرس الناس النضار بحاجب | كان السماح لعين مالك حاجبا |
لم يملأوا فيك البيوت رغائبا | إلا وقد ملأوا البيوت غرائبا |
أوليتني قبل المديح عناية | وملأت عيني هيبة ومواهبا |
ورفعت قدري في الأنام وقد رأوا | مثلي لمثلك خاطبا ومخاطبا |
في مجلس ساوى الخلائق في الندى | وترتبت فيه الملوك مرابتا |
وافيته في الفلك أسعى جالسا | فخرا على من قال أمشي راكبا |
فأقمت أنفذ في الأنام أوامرا | مني وأنشب في الخطوب مخالبا |
وسقتني الدنيا غداة وردته | ريا وما مطرت علي مصائبا |
فطفقت أملأ من ثناك وشكره | حقبا وأملأ من نداك حقائبا |
أثني فتثنيني صفاتك مظهرا | عيا وكم أعيت صفاتك خاطبا |
لو أن أعضانا جميعا ألسن | تثني عليك لما قضينا الواجبا |
يا نسمة لأحاديث الحمى شرحت | كم من صدور الأرباب النهى شرحت |
بليلة البرد يهدي للقلوب بها | برد فكم لفحت قلبي وقد نفحت |
وبارق كسقيط الزند مقتدح | له يد لزناد الشوق قد قدحت |
بدا فأذكرني أرض الصراة وقد | تكللت بالكلاء والشيح واتشحت |
والريح نائحة والسحب سافحة | والغدر طافحة والورق قد صدحت |
وقهوة كوميض البرق صافية | كأنها من أديم الشمس قد رشحت |
عذراء شمطاء قد جف النشاط بها | لولا المزاج إلى ندمانها جمحت |
رقيقة الجرم يستخفي المزاج بها | كأنها دون جرم الشمس قد سفحت |
باكرتها وعيون الشهب قد غمضت | خوف الصباح وعين الشمس قد فتحت |
وبشرت بوفاة الليل ساجعة | كأنها في غدير الصبح قد سبحت |
مخضوبة الكف ما تنفك نائحة | كأن أفراخها في كفها ذبحت |
وظبية من ظباء الترك كالية | لكنها في رياض القلب قد سرحت |
إن جال ماء الحيا في خدها خجلت | وإن تردد في أجفانها اتقحت |
قست على صبها قلبا ووجنتها | لو مر تقبيلها بالوهم لانجرحت |
سألتها قبلة والوقت منفسح | لنا فما رخصت فيها ولا فسحت |
وخلت أعطافها بالعطف تمنحني | فما نحت ذلك المنحا ولا منحت |
كم قد عصيت اللواحي في إطاعتها | وإن ألحت على عذلي بها ولحت |
من ليس يخشى أسود الغاب إن زارت | فيكف يخشى كلاب الحي إن نبحت |
ما أن أخاف من الأيام فادحة | إذا يد الدهر في أبنائه فدحت |
وكيف تفسد كف الدهر حال فتى | أموره بالمليك الناصر انصحلت |
لما رأت عيناك أني كالذي | أبدو فينقصني السقام الزائد |
وافيتني ووفيت لي بمكارم | فنداك لي صلة وأنت العائد |
ولقد ذكرت القرب منـ | ـك وطيب أيام الوصال |
فطفقت أصفق راحتي | وعند صفقها مقالي |
كيف السبيل إلى سعا | د ودونها قلل الجبال |
وعود به عاد السرور لأنه | حوى اللهو قدما وهو ريان ناعم |
يغرب في تغريده فكأنه | يعيد لنا ما لقنته الحمائم |
عود حوى في الروض أعواده | كل المعاني وهو رطب قويم |
فحان شدو الورق في سجعه | ورقة الماء ولطف النسيم |
وشدت فأيقظت الرقود بشدوها | وأعارت الأيقاظ طيب رقودها |
خود شدت بلسانها وبنانها | حتى تشابه ضربها بنشيدها |
وكأن نغمة عودها في صوتها | وكأن رقة صوتها في عودها |
إني لأحسد عودها إن عانقت | عطفيه أو ضمته بين نهودها |
وأغار من لثم الكؤوس لثغرها | وأذوب من لمس الحلي لجيدها |
وإبريق له نطق عجيب | إذا ما أرسلت منه السلاف |
كتمتام تلجلج في حديث | يردد لفظه والتاء قاف |
بحر من الحسن لا ينجو الغريق به | إذا تلاطم أعطاف بأعطاف |
ما حركته نسيم الرقص من مرح | إلا وماجت به أمواج أرداف |
هذا إناء حوى ما كان مجتمعا | في غيره فله الماعون أعوان |
كأن وقمع وإبريق ومغرفة | وصحفة وشرابي وقرغان |
وفي النيل إذ وفى البسيطة حقها | وزاد على ما جاءه من صنائع |
فماذا يقول الناس في جود منعم | يشار إلى إنعامه بالأصابع |
لي من ضميرك شاهد فيه غنى | لك عن قراءة ما حوى قرطاسي |
ولأن وقفت عليه معتبرا له | ما في وقوفك ساعة من باس |
غارت وقد قلت لمسواكها | أراك تجني ريقها بأراك |
قالت تمنيت جني ريقتي | وفاز بالترشاف منها سواك |
يا من حمت عنا مذاقة ريقها | رفقا بقلب ليس فيه سواك |
فلكم سألت الثغر وصف رضابه | فأبى وصرح لي سفيه سواك |
قالت: كحلت الجفون بالوسن | قلت ارتقابا لوجهك الحسن |
قالت: تسليت يوم فرقتنا | فقلت عن مسكني وعن سكني |
قالت: تشاغلت عن محبتنا | قلت بفرط الباء والحزن |
قالت: تناسيت، قلت: عافيتي | قالت: تناءيت، قالت: عن وطني |
قالت: تخليت، قلت: عن جلدي | قالت: تغيرت، قلت: في بدني |
قالت: تخصصت دون صحبتنا | فقلت: بالغبن فيك والغبن |
قالت: أذعت الأسرار، قلت لها: | صير سري هواك كالعلن |
قالت: سررت الأعداء، قلت لها | ذلك شيء لو شئت لم يكن |
قالت: فماذا تروم؟ قلت لها | ساعة سعد بالوصل تسعدني |
قالت: فعين الرقيب ترصدنا | قلت: فإني للعين لم أبن |
نحلتني بالصدود منك فلو | ترصدني المنون لم ترني |
ولم أنس إذ زار الحبيب بروضة | وقد غفلت عنا وشاة ولوام |
وقد فرش الورد الخدود ونشرت | بمقدمه للسوسن الغض أعلام |
أقول وطرف النرجس الغض شاخص | إلينا وللنمام حولي إلمام |
أيا رب حتى في الحدائق أعين | علينا وحتى في الرياحين نمام |
قد أضحك الروض مدمع السحب | وتوج الزهر عاطل القضب |
وقهقه الورد للصبا فغدت | تملأ فاه قراضة الذهب |
وأقبلت بالربيع محدقة | كتائب لا تخل بالأدب |
فغصنها قائم على قدم | والكرم جاث له على الركب |
رعى الله ليلتنا بالحمى | وأمواه أعينه الزاخره |
وقد زين حسن سماء الغصون | بأنجم أزهاره الزاهره |
وللنرجس الغض من بيننا | وجوه بحضرتنا ناضره |
كأن تحدق أزهارها | عيون إلى ربها ناظره |
خلياني أجر فضل برودي | راتعا في رياض عين البرود |
كم بها من بديع زهر أنيق | كفصوص منظومة وعقود |
زنبق بين قضب آس وبان | وأقاح ونرجس وورود |
كجبين وعارض وقوام | وثغور وأعين وخدود |
تغانى بالحشيش عن الرحيق | وبالورق الجديد عن العتيق |
وبالخضراء عن حمراء صرف | فكم بين الزمرد والعقيق |
في الكيس لا في الكاس لي قهوة | من ذوقها أسكر أو شمها |
لم ينه نص الذكر عنها ولا اجـ | ـتمع في الشرع على ذمها |
ظاهرة النفع لها نشوة | تستنقذ الأنفس من همها |
فشكرها أكثر من سكرها | ونفعها أكبر من إثمها |
ليهنك أن لي ولدا وعبدا | وساء في المقال وفي المقام |
فهذا سابق من غير سين | وهذا عاقل من غير لام |
تزوج جاري وهو شيخ صبية | فلم يستطع غشيانها حين جاءها |
ولو أنني بادرتها لتركتها | يرى قائم من دونها ما وراءها |
جاءت بوجه بين قرطين | شبيه بدر بين نجمين |
فامتدت الأعين منا إلى | عينين منها تحت نونين |
قالت: لكي تعبث بي لا تكن | للنفس قوتا بعد ميمين |
فقلت: إن عارضتني بعدها | قطعت سينا بين كافين |
وذات حر جادت به فصدتها | وقلت لها: مقصودي العجز لا الفرج |
فدارت وداوت سوء خلقي بالرضا | وفي قلبها مما تكابده وهج |
وظلت تقاسي من فعالي شدة | ولم يعل من فرط الحياء لها وهج |
إذا ما دفعت الأير فيه تجشأت | وذاك ضراط لم يتم له نضج |
ولي غلام كالنجم طلعته | أخدمه وهو بعض خدامي |
تراه خلفي طول النهار فإن | دجا لنا الليل صار قدامي |
جعلته في الحضور مع سفري | كفروة الحرث بن همامي |
قبل قيل، يراك ثراك، عبد عند، رخاك رجاك، أبي أبى، سؤال سواك، آمل أمك، رجاء رخاء، فألفى فألقى، جدة خده، بأعتابك بأغيابك، شرقا سرفا، لاذ بك لاد بك، مقدما مقدما، أمل آمل، يزجيه ترجيه، يبشره بيسره، وجودك وجودك، فاشتاق فاستاف، عرف عرف، منك مثل، عبير عنبر، وقدم قدم، صدقه صدقه، متجملا متحملا، بضاعة بضاعة، تبر نثر، ومنها أبيات:
سند سيد حليم حكيم | فاضل فاصل مجيد مجيد |
حازم جازم بصير نصير | زانه رأيه السديد الشديد |
أمه أمة رجاء رخاء | أدركت إذ زكت نقود نقود |
مكرمات مكرمات بنت بيـ | ـت علاء علا بجود يجود |
زار وصبغ الظلام قد نصلا=بدر جلا الشمس في الظلام ألا | فاعجب |
وأدهم الليل منه قد جفلا=وقد أتى رائد الصباح على | أشهب |
خد بلطف النعيم قد صقلا=كأنه من دمي إذا خجلا | يخضب |
فارقم الجعد يحرس الكفلا=وحارسا الخد منه قد جعلا | عقرب |
لولا أياد بها الورى شملا=لأصبح الناس كالسماء بلا | كوكب |
سحاب جود على الورى هطلا=لا برقه مبطئ الثوال | ولا خلب |
ملكا لرزق الأنام قد كفلا=فصار في الناس جوده مثلا | يضرب |
عبد على فرط حبكم جبلا=عليكم إن أقام أو رحلا | يحسب |
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 18- ص: 0
الحلي صفي الدين الشاعر عبد العزيز بن سرايا.
دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان / دار الفكر، دمشق - سوريا-ط 1( 1998) , ج: 2- ص: 295
عبد العزيز بن سرايا ابن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن أبي العز بن سرايا بن باقي بن عبد الله بن العريض، الإمام العلامة، البليغ، المفوه، الفاضل، الناظم، الناثر، شاعر عصرنا على الإطلاق، صفي الدين الطائي السنبسي الحلي.
شاعر أصبح به راجح الحلي ناقصا، وكان سابقا فأصبح على عقبه ناكصا. أجاد القصائد المطولة والمقاطيع، وأتى بما أخجل زهر النجوم في السماء، فما قدر زهر الأرض في الربيع؟ تطربك ألفاظه المصقولة ومعانيه المعلولة، ومقاصده التي كأنها سهام راشقة أو سيوف مسلولة. يغوص على المعاني ويستخرج جواهرها، ويصعد بمخيلته الصحيحة إلى السماء ويلتقط زواهرها. كلامه السحر إلا أنه خلال، ولفظه على القلب الظمآن ألذ من الماء الزلال. تلعب بالمعاني كما يتلعب النسيم بالأغصان اللدان، وولد بعضها من بعض كما يتولد الضرج من الخجل في خدود الولدان، مع بديع ما سمع بمثله البديع، وترصيع ما ألم به الصريع.
وشعره مع حلاوة الديباجة، وطلاوة التركيب التي ما فرحت بها طلاء الدن ولا سلافة الزجاجة، لا يخلو من نكت أدبية ترقص المناكب، وفوائد علمية من كل فن ينقص الكواكب. عالما بكل ما يقول، عارفا بغرائب النقول.
أجاد فنون النظم غير القريض، وأتى في الجميع بما هو شفاء القلب المريض، لأنه نظم القريض فبلغ فيه الغاية، وحمل قدامة جماعة من فحول الأقدمين الراية.
وكذلك هو في الموشحات والأزجال والمكفرات والبلاليق والقرقيات، والدوبيت والمواليا، والكان وكان والقوما، ليس له في كل ذلك نظير يجاريه، ولا يعارضه ولا يباريه.
وأما الشعر فجود فنونه، وصاد من بره ضبه ومن بحره نونه، لأنه أبدع في مديحه وهجوه، ورثائه وأغزاله، وأوصافه وتشبيهاته، وطردياته وحماسته، وحكمه وأمثاله، لم ينحط في شيء منها عن الذروة، ولم يخرج في مشاعرها عن الصفا والمروة.
وأما نثره فهو طبقة وسطى، وترسله يحتاج في ترويجه إلى أن يعلق في أذنه قرطا. وعلى الجملة فإنه:
تملل الشعر حتى ما لذي أدب | في الناس شين ولا غين ولا راء |
ورد إلى مصر وامتدح السلطان الملك الناصر، وبز بمديحه كل متقدم ومعاصر. وعاد إلى البلاد الشرقية، إلا أنه كان شيعيا، وليس هذا الأمر في الحلة بدعيا.
وكان يتردد إلى حلب وحماة ودمشق، ويعد إلى ماردين، ويعرج على بغداد.
ولم يزل على حاله إلى أن كدر الموت على الصفي عيشه، وأنساه خرقه وطيشه.
وتوفي رحمه الله تعالى تخمينا سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة.
ومولده يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وست مئة.
وقلت أنا فيه:
إن فن الشعر نادى | في جميع الأدباء |
أحسن الله تعالى | في الصفي الحلي عزائي |
يا سائلي عن رتبة الحلي في | نظم القريض وراضيا بي أحكم |
للشعر حليان ذلك راجح | ذهب الزمان به وهذا قيم |
وأما الصدر المعظم شمس الدين عبد اللطيف الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، فكان يظن بل يعتقد أنه ما نظم الشعر أحد مثله لا في المتقدمين ولا في المتأخرين مطلقا.
واجتمعت أنا به في الباب وبزاعة من بلاد حلب في مستهل ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة، كنا في الصيد مع الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى، وأجاز لي بخطه جميع ماله من نظم ونثر وتأليف مما سمعته منه، وما لم أسمعه، وما لعله يتفق له بعد ذلك التاريخ على أحد الرائين، وما يجوز له أن يرويه سماعا وأجازة ومناولة ووجاده بشرطه.
وأنشدني من لفظه لنفسه في التاريخ والمكان:
للترك مالي ترك | مادين حبي شرك |
حواجب وعيون | لها بقلبي فتك |
كالقوس يصمي وهذي | تشكي المحب ويشكو |
وإذا العداة أرتك فر | ط مذلة فإليك عنها |
وإذا الذئاب استنعجت | لك مرة فحذار منها |
لا غرو أن يصلى الفؤاد بذكركم | نارا تؤججها يد التذكار |
قلبي إذا غبتم، يصور شخصكم | فيه، وكل مصور في النار |
يقبل الأرض عبد تحت ظلكم | عليكم، بعد فضل الله، يعتمد |
ما دار مية من أسنى مطالبه | يوما وأنتم له العلياء والسند |
وأغر تبري الإهاب مورد | سبط الأديم محجل ببياض |
أخشى عليه بأن يصاب بأسهمي | مما يسابقني إلى الأغراض |
وأدهم يقق التحجيل ذي مرح | يميس من عجبه كالشارب الثمل |
مضمر مشرف الأذنين تحسبه | موكلا باستراق السمع من زحل |
ركبت منه مطاليل تسير به | كواكب تلحق المحمول بالحمل |
إذا رميت سهامي فوق صهوته | مرت بهاديه وانحطت عن الكفل |
وقوله: ’’كالقوس...’’ الأبيات، إشارة إلى قول ابن الرومي:
تشكي المحب وتشكو وهي ظالمة | كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان |
وإذا الذئاب استنعجت لك مرة | فحذار منها أن تعود ذئاب |
والذئب أخبث ما يكون إذا اكتسى | من جلد أولاد النعاج ثيابا |
وله قصيدة ميمية في مديح النبي صلى الله عليه وسلم عارض بها البردة، أتى فيها بما يزيد على المئة والأربعين نوعا من البديع، وشرحها وسماها: نتائج الألمعية في شرح الكافية البديعية. وجود في هذه القصيدة ما شاء.
وله مدائح ببني أرتق على حروف المعجم، مجلد. وله كتاب: العاطل الحالي والمرخص الغالي. وقال لي إنه وضع شيئا في الجناس، ولم أره إلى الآن. وقيل: إنه عمل مقامات يسيرة.
والذي أقوله: إن الرجل كان أديبا كبيرا عالما فاضلا قادرا على النظم والإنشاء، مهما أراد فعل.
وأنشدني له إجازة:
سوابقنا والنقع والسمر والظبي | وأحسابنا والحلم والبأس والبر |
هبوب الصبا والليل والبرق والقضا | وشمس الضحى والطود والنار والبحر |
لئن لم أبرقع بالحيا وجة عفتي | فلا أشبهته راحتي في التكرم |
ولا كنت ممن يكسر الجفن في الوغى | إذا أنا لم أغضضه عن رأي محرم |
وأنشدني له إجازة في مثله:
لا يسمع العود منا غير حاضنه | من لبة الشوس يوم الروع بالعلق |
ولا يعاطي كميتا غير مصدره | يوم الصدام بليل العطف بالعرق |
وظبي بقفر فوق طرف مفوق | بقوس رمى في النقع وحشا بأسهم |
كشمس بأفق فوق برق بكفه | هلال رمى في الليل جنا بأنجم |
ونقلت من خطه رسالة طويلة نظما ونثرا، كل كلمة منها تصحيف ما بعدها، تكون أربع مئة كلمة، وهي:
’’قبل قبل يداك ثراك عبد عند رخاك رجاك، أبي أبي سؤال سواك. آمل أمك رجاء رخاء. فألغى فألقى جدة خده بأعتابك باغيا بك شرفا سرفا. لاذبك لأدبك مقدما مقدما أمل آمل يزجيه يبشره بيسره وجودك وجودك. فاشتاق فاستاف. عرف عرف منك مثل عبير عنبر، وقدم وقدم، صدقه صدقه متجملا متحملا بصاعه بضاعة تبر نثر.
سند سيد حليم حكيم | فاضل فاضل مجيد مجيد |
حازم جازم بصير نصير | زانه رأيه الشديد السديد |
أمه أمة رجاء رخاء | أدركت إذ زكت نقود تقود |
مكرمات مكرمات بنت بيـ | ـت علاء علا بجود يجود |
وأنشدني له إجازة مضمنا.
تزوج جاري وهو شيخ صبية | فلم يستطع غشيانها حين جاءها |
ولو أنني بادرتها لتركتها | يرى قائم من دونها ما وراءها |
ليهنك أن لي ولدا وعبدا | سواء في المقال وفي المقام |
فهذا سابق من غير سين | وهذا عاقل من غير لام |
وذات حر جادت به فصددتها | وقلت لها: مقصودي العجز لا الفرج |
فدارت ودارت سوء خلقي بالرضا | وفي قلبها مما تكابده وهج |
إذا ما دفعت الأير فيها تجشأت | وذاك ضراط لم يتم له نضج |
خلياني أجر فضل برودي | راتعا في رياض عين البرود |
كم بها من بديع زهر أنيق | كفصوص منظومة وعقود |
زنبق بين قضب آس وبان | وأقاح ونرجس وورود |
كجبين وعارض وقوام | وثغور وأعين وخدود |
ولي غلام كالنجم طلعته | أخدمه وهو بعض خدامي |
تراه خلفي طول النهار فإن | دجا لنا الليل صار قدامي |
جعلته في الحضور مع سفري | كفروة الحرث بن همام |
وأنشدني لنفسه إجازة:
لما رأت علياك أني كالذي | أبدو فينقصني السقام الزائد |
وافيتني ووفيت لي بمكارم | فنداك لي صلة وأنت العائد |
انظر إلي بعين مولى لم يزل | يولي الندى وتلاف قبل تلافي |
أنا كالذي أحتاج ما أحتاجه | فاغنم ثنائي بالجيمل الوافي |
وأنشدني له إجازة:
وعود به عاد السرور لأنه | حوى اللهو قدما وهو ريان ناعم |
يغرب في تغريده فكأنه | يعيد لنا ما لقنته الحمائم |
يا جوادا أكفه في مجال الحر | ب حتف وفي النوال غمامه |
ومثل هذا قول القائل يطلب حبرا:
تصدق علي بمعكوس ضد | مصحف قولي خبت ناره |
وأنشدني إجازة لنفسه يستهدي راحا:
جاد لنا الدهر بعد ما بخلا | ومجلس الأنس قد صفا وحلا |
ونحن في مجلس يزينه | رشف طلى بيننا ولثم طلى |
فاهد لنا لا برحت ذا نعم | ما ضد تصحيف عكسه عدلا |
وأنشدني له إجازة يطلب فلفلا:
أعوزتنا إحدى العقاقير في الدر | ياق فأتحف بها تكن خير تحفه |
ضعف تصحيف ضد مشطور مثل | لمثنى معكوس ترخيم دفه |
وأنشدني لنفسه إجازة:
بأبي قذار منك وابن زرارة | أدنيت حتف المستهام العاني |
فلو أن كاسم أبي معاذ قلبه | ما كان في البلوى أبا حسان |
وأنشدني لنفسه أيضا:
ما كان ودك إذ عتبتك في الجفا | كابن الطفيل ولا أبي حسان |
وجهي أبو المقداد منك من الحيا | والقلب منك حكى أبا سفيان |
وأنشدني لنفسه أيضا رحمه الله تعالى مواليا:
تقول بسك مني يا شقيق البدر | لقول ضدك عني بالخنا والغدر |
وكان ظنك أني يا جليل القدر | يكون ذلك فني عند ضيق الصدر |
تقول بسك مني | لقول ضدك عني |
وكان ظنك أني | يكون ذلك فني |
تاء قاف واو لام باء سين كاف ميم نون يا | لام قاف واو لام ضاد دال كاف عين نون يا |
واو كاف ألف نون ظاء نون كاف ألف نون يا | ياء كاف واو نون ذال لام كاف فاء نون يا |
علمت أنك حبي يا رشيق القد | وقلت: ودك طبي يا شريق الخد |
فراع صدك لبي يا سعيد الجد | عسى يردك ربي يا مديد الصد |
علمت أنك حبي | وقلت: ودك طبي |
فراع صدك لبي | عسى يردك ربي |
عين لام ميم تاء ألف نون كاف حاء باء يا | واو قاف لام تاء واو دال كاف طاء باء يا |
فاء راء ألف عين صاد دال كاف لام باء يا | عين سين ألف ياء راء دال كاف راء باء يا |
وعدت في الخميس وصلا ولكن | شاهدت حولنا العدا كالخميس |
أخلفت في الخميس وعدي وجاءت | بعدما قبل بعد يوم الخميس |
ما يقول الفقيه أيده الله | ولا زال عنده الإحسان |
في فتى علق الطلاق بشهر | بعدما قبل بعده رمضان |
وأنشدني لنفسه ما يقرأ مقلوبا:
أنث ثناء ناضرا لك إنه | هنا كل أرض إن أنث ثناء |
أمر كلاما ألفته مظنه | له نظم هتف لأم الكرماء |
أهب لوصف لا لما هب آمل | ملما بها ملء الفصول بهاء |
أروح أطيل الدأب أبرم همة | مربى بإدلال يطاح وراء |
أرق فلا حزن ينم بمهمل | مهم بمن ينزح الفقراء |
أخر لأني نائب لقضية | تهيض قلبي أن ينال رخاء |
أفوه أراعي قوته بتكلف | لكتبة توقيع أراه وفاء |
يلذ ذلي بنضو | لو ضن بي لذ ذلي |
يلم شملي لحسن | إن سح لي لم شملي |
كم قد أفضنا من دموع ودما | على رسوم للديار والدمن |
وكم قضينا للبكاء منسكا | لما تذكرنا بهن من سكن |
معاهد تحدث للصبر فنا | إن هاجت الورق بها على فنن |
تذكارها أحدث في القلب شجا | وفي الحشا قرحا وفي القلب شجن |
لله أيام لنا على منى | فكم لها عندي أياد ومنن |
شربت فيها لذة العيش حسا | وما رأيت بعدها مرأى حسن |
كم كان فيها من فتاة وفتى | كل لقلب المستهام قد فنى |
فما ارتكبنا بالوصال مأثما | بل بعتهم روحي بغير ما ثمن |
وعاذل أضمر مكرا ودها | فنمق العيش بنصح ودهن |
لاح غدا يعرف للقلب لحا | إن أعرب القول بعذلي أو لحن |
يزيدني بالزجر وجدا وأسى | وكان ماء الود منه قد أسن |
سئمت منه اللوم إذ طال مدى | ولم أجبه بل بدوت إذا مدن |
بجسرة تشد في السير قرى | إذا لم تذلل بزمام وقرن |
لا تتشكي نصبا ولا وجى | إذا دجا الليل على الركب وجن |
حنت وأعطت في السرى خير عطا | إن حن يوما غيرها إلى عطن |
وأصبحت من بعد أين وعنا | للملك الناصر ضيفا وعنن |
ملك غدا لسائر الناس أبا | إن سار في كسب الثناء أو أبن |
الناصر الملك الذي فاض جدا | فخلته ذا يزين وذا جدن |
ملك علا قدرا وجدا وسنا | فجاء في طرق العلا على سنن |
لا جور في بلاده ولا عدى | إن عد في العدل زبيد وعدن |
كم بدر أعطى الوفود ولهى | وكان يرضيهم كفاف ولهن |
حنيت من إنعامه خير جنى | وكنت من قبل كميت في جنن |
فما شكوت في حماه لغبا | ولو أطاق الدهر غبني لغبن |
دعوته بالمدح عن صدق ولا | فلم يجب يوما بلم ولا ولن |
أنظم في كل صباح ومسا | كأنه لصارم الفكر مسن |
يا مالكا فاق الملوك ورعا | إن شان أهل الملك طيش ورعن |
أكسبني بالمجد مجدا وعلا | فصغت فيك المدح سرا وعلن |
إن أولك المدح الجزيل فحرى | وإن كبا فكر سواي وحرن |
لا زلت في ملكك خلوا من عنا | وليس للهم لديك من عنن |
ونلت فيه ما تروم من منى | وعشت في أمن وعز ومنن |
سل سلسل الريق إن لم تروحر ظلما | بل بلبل القلب لما زاده ألما |
قد قد قد حبيبي حبل مصطبري | إن آن أن أجتني جرما فلا جرما |
مذ مل ململ قلبي في تغنته | لو كف كفكف دمعا صار فيه دما |
بل رب ربرب سرب ثغره شنب | لو لؤلؤ رام تشبيها به ظلما |
لو قابل الشمس لألأ لاؤها كسفت | فإن يقل للدجازح زحزح الظلما |
كم هد هدهد واشينا بناء وفا | غداة عنعن عن أعدائنا الكلما |
مذ نم نمنم أقوالا شقيت بها | إذ زل زلزل طود الصبر فانهدما |
لم لملم الوجد عندي بعد مصرفه | عني وجمجم جم الغيث فالتأما |
مدلج لجلج نطقي عن إجابته | لو رق رقرق دمعا ظل منسجما |
إن كان دعدع دع كأس العتاب وقل | من مهمه العشق لا يطويه من سئما |
إن قيل ضعضع ضع خديك معتذرا | أو قيل قلقل قل أرضى بما حكما |
أو قيل طحطح طح بالحب ملتجئا | أو قيل دمدم دم بالود ملتزما |
سب سبسب الحب واشكر من احبتنا | لكل من من من أهل الوفا كرما |
هم همهم حفظهم للخل حق وفا | من حيث حصحص حص الهم منتقما |
إن قيل أح أحاح الغدر فارض بهم | أولا فنفسك لم لم لم تفض ندما |
إنهض فهذا النجم في الغرب سقط | والشيب في فود الظلام قد وخط |
والصبح قد مد إلى نهر الدجى | يدا بها در النجوم يلتقط |
وألهب الإصباح أذيال الدجى | بشمعة من الشعاع لم تقط |
وضجت الأطيار في أوراقها | لما رأت سيف الصباح مخترط |
وقام من فوق الجدار هاتف | متوج القامة ذو فرغ قطط |
يخبر الراقد أن نومه | عند انتباه جده من الغلط |
والبدر قد صار هلالا ناحلا | في آخر الشهر وبالصبح اختلط |
كأنه قوس لجين موتر | والليل زنجي عليه قد ضبط |
وفي يديه للثريا ندب | يزيد فردا واحدا عن النمط |
فأي عذر للرماة والدجى | قد عد في سلك الرماة وانخرط |
أما ترى الغيم الجديد مقبلا | قد مد في الأفق رداه وانبسط |
كأن أيدي الريح في تلفيقه | قد لبدت قطنا على ثوب شمط |
يلمع ضوء البرق في حافاته | كأن في الجو صفاحا تخترط |
وأظهر الخريف من أزهاره | أضعاف ما يخفي الربيع إذا شحط |
ولان عطف الريح في هبوبها | والظل من بعد الهجير قد سقط |
والشمس في الميزان موزون بها | قسط النهار بعدما كان قسط |
وأرسلت جبال دربند لها | رسلا صبا القلب إليها وانبسط |
من الكراكي الخزريات التي | تقدم والبعض بعض مرتبط |
كأنها إذ تابعت صفوفها | ركائب عنها الرحال لم تحط |
إذا قفاها سمع ذي صبابة | مثلي تقاضاه الغرام ونشط |
فقم بنا نرفل في ثوب الصبا | إن الرضا بتركه عين السخط |
والتقط اللذة حيث أمكنت | فإنما اللذات في الدهر لقط |
إن الشباب زائر مودع | لا يستطاع رده إذا فرط |
أما ترى الكركي في الجو وقد | نعم في أفق السماء ولغط |
أنساه حب دجلة وطيبها | مواطنا قد زق فيها وقمط |
فجاء يهدي نفسه وما درى | أن الجياد للحروب ترتبط |
من كل سبط من هدايا واسط | جعد التلاع منه في الكعب نقط |
أصلحه صالح باجتهاده | وكل ذي لب له فيه غبط |
وما أضاع الحزم عند حزمها | بل جاوز القيظ وللفصل ضبط |
حتى إذا حر حزيران خبا | وتم تموز وآب وشحط |
وجاء أيلول بحر فاتر | في نضج تعديل الثمار ما فرط |
أبرز ما أحرز من آلاته | وحل من ذاك المتاع ما ربط |
ومد للصنعة كف أوحد | مننره عن الفساد والغلط |
وظل يستقري بلاغ عودها | فنبر الأطراف واختار الوسط |
وجود التدقيق في لحامها | فأسقط الكرشات منه والسقط |
ولم يزل ينقلها مراتبا | تلزم في صنعته وتشترط |
فعندما أفضت إلى تطهيرها | صحح دارات البيوت والنقط |
حتى إذا قمصها بدهنها | جاءت من الصحة في أحلى نمط |
كأنها النونات في تعريقها | يعوج منها بندق مثل النقط |
مثل السيور في يد الرامي فلو | شاء طواها وحواها في سفط |
لو يقذف أليم بها مالكها | ما انتقض العود ولا الزور انكشط |
كأنما يندقها نيازك | أو من بد الرامي إلى الطير خطط |
من كل محني الضلوع مدمج | ما وهم الباري بها ولا فرط |
كأنما لام عليها ألف | وقال قوم إنها اللام فقط |
فأجل قذى عيوننا ببرزة | تنفي عن القلب الهموم والقنط |
فما رأت من بعد هور بابل | ومائه التيار عيشا يغتب |
ونحن من مروجه في نشوة | عند التحري في الوقوف للخطط |
من كل مقبول المقال صادق | قد قبض القوس وللنفس بسط |
يقدمنا فيها قديم حاذق | لا كسل يشينه ولا قنط |
يحكم فينا حكم داود فلا | تنظر منا خارجا لما شرط |
لا يسبك الأسباق من جفته | ولم يكن مثل القرلى في النمط |
إذا رأى الشر تعلى وإذا | لاح له الخير تدلى وانخبط |
ما نعم المزهر والدف إذا | فصل أدوار الضروب وضبط |
أطيب من تدفدف التم إذا | دق اكتسى الريش وهذا قد شمط |
وذاك يرعى في شواطيه وذا | على الروابي قد تحصى ولقط |
فمن جليل واجب تعداده | ومن مراع عدها لا يشترط |
تعرج منا نحوه بنادق | لم ينج منها من تعلى واختبط |
فمن كسير في العباب عائم | ومن ذبيح بالدماء يعتبط |
كيف الضلال وصبح وجهك مشرق | وشذاك في الأكوان مسك يعبق |
يا من إذا سفرت محاسن وجهه | ظلت بها حدق الخلائق تحدق |
أوضحت عذري في هواك بواضح | ماء الحيا بأديمه يترقرق |
فإذا العذول رأى جمالك قال لي | عجبا لقلبك كيف لا يتمزق |
يا آسرا قلب المحب فد معه | والنوم منه مطلق ومطلق |
أغنيتني بالفكر فيك عن الكرى | يا آسري فأنا الغني المملق |
وصحبت قوما لست من نظرائهم | فكأنني في الطرس سطر محلق |
قولا لمن حمل السلاح وخصره | من قد ذابله أرق وأرشق |
لا توه جسمك بالسلاح وحمله | إني عليك من الغلالة أشفق |
ظبي من الأتراك فوق خدوده | نار يخر لها الكليم ويصعق |
تلقاه وهو مزرد ومدرع | وتراه وهو مقرط ومقرطق |
لم تترك الأتراك بعد جمالها | حسنا لمخلوق سواها يخلق |
إن نوزلوا كانوا أسود عريكة | أو غوزلوا كانوا بدورا تشرق |
قوم إذا ركبوا الجياد رأيتهم | أسدا بألحاظ الجآذر ترمق |
قد خلقت بدم القلوب خدودهم | ودروعهم بدم الكماة تخلق |
جذبوا القسي إلى قسي حواجب | من تحتها نبل اللواحظ ترشق |
نشروا الشعور فكل قد منهم | لدن عليه من الذؤابة صنجق |
لي منهم رشأ إذا قابلته | كادت لواحظه بسحر تنطق |
إن شاء يلقاني بخلق واسع | عند السلام نهاه طرف ضيق |
لم أنس ليلة زارني ورقيبه | يبدي الرضا وهو المغيظ المحنق |
حتى إذا عبث الكرى بجفونه | كان الوسادة ساعدي والمرفق |
عانقته وضممته فكأنه | من ساعدي ممنطق ومطوق |
حتى بدا فلق الصباح فراعه | إن الصباح هو العدو الأزرق |
أسبلن من فوق النحور ذوائبا | فتركن حبات القلوب ذوائبا |
وجلون من صبح الوجوه أشعة | غادرون فود الليل منها شائبا |
بيض دعاهن الغبي كواعبا | ولو استبان الرشد قال كواكبا |
وربائب فإذا رأيت نفارها | من بسط أنسك خلتهن رباربا |
سفهن رأي المانوية عندما | أسبلن من ظلم الشعور غياهبا |
وسفرن لي فرأين شخصا حاضرا | شدهت بصيرته وقلبا غائبا |
أشرقن في حلل كأن أديمها | شفق تدرعه الشموس جلابيا |
وغربن في كلل فقلت لصاحبي | بأبي الشموس الجانحات غواربا |
حلو التعتب والدلال يروعه | عتبي، ولست أراه إلا غاتبا |
عاتبته فتضرجت وجناته | وازور ألحاظا وقطب حاجبا |
فأراني الخد الكليم وطرفه | ذو النون إذ ذهب الغداة مغاضبا |
ذو منظر تغدو القلوب بخسنه | نهبا وإن منح العيون مواهبا |
لا غرو أن وهب اللواحظ حظوة | من نوره ودعاه قلبي ناهبا |
كمواهب السلطان قد كست الورى | نعما وتدعوه القساور سالبا |
ملك يرى تعب المكارم راحة | ويعد راحات الفراغ متاعبا |
لم تخل أرض من ثناه وإن خلت | من ذكره ملئت قنا وقواضبا |
بمكارم تذر السباسب أبحرا | وعزائم تذر البحار سباسبا |
ترجى مواهبه ويخشى بطشه | مثل الزمان مسالما ومحاربا |
فإذا سطا ملأ القلوب مهابة | وإذا سخا ملأ العيون مواهبا |
كالغيث يسفح من عطائه نائلا | سبطا ويرسل من سطاه حاصبا |
كالليث يحمي غابه بزئيره | طورا وينشب في القنيص مخالبا |
كالسيف يبدي للنواظر منظرا | طلقا ويمضي في الهياج مضاربا |
كالسيل يحمد منه عذبا واصلا | ويعده قوم عذابا واصبا |
كالبحر يهدي للنفوس نفائسا | منه ويبدي للعيون عجائبا |
فإذا نظرت ندى يديه ورأيه | لم تلف إلا صيبا أو صائبا |
أبقى قلاوون الفخار لولده | إرثا ففازوا بالثناء مكاسبا |
قوم إذا سئموا الصوافن صيروا | للمجد أخطار الأمور مراكبا |
عشقوا الحروب تيمنا بلقا العدا | فكأنهم حسبوا العداة حبائبا |
وكأنما ظنوا السيوف سوالفا | واللدن قدا والقسي حواجبا |
يا أيها الملك العزيز ومن له | شرف يجر على النجوم ذوائبا |
أصلحت بين المسلمين بهمة | تذر الأجانب بالوفود أقاربا |
ووهبتهم زمن الأمان فمن رأى | ملكا يكون له الزمان مواهبا |
فرأوا خطابا كان خطبا فادحا | لهم وكتبا كن قبل كتائبا |
وحرست ملكك من رجيم مارد | بعزائم إن صلت كن قواضبا |
حتى إذا خطف المنافق خطفة | أتبعته منها شهابا ثاقبا |
لا ينفع التجريب خصمك بعدما | أفنيت من أفنى الزمان تجاربا |
صرمت شمل المارقين بصارم | تبديه مسلوبا فيرجع سالبا |
صافي الفرند حكى صباحا جامدا | أبدى النجيع به شعاعا ذائبا |
وكتيبة تدع الصهيل رواعدا | والبيض برقا والعجاج سحائبا |
حتى إذا ريح الجلاد حدت لها | مطرت وكان الوبل نبلا صائبا |
بذوابل ملد يخلن أراقما | وشوائل جرد يخلن عقاربا |
تطأ الصدور من الصدور كأنما | تعتاض عن وطء التراب ترائبا |
فأقمت تقسم للوحوش وظائفا | فيها وتصنع للنسور مآدبا |
وجعلت هامات الكماة منابرا | وأقمت حد السيف فيها خاطبا |
يا راكب الخطر الجليل وقوله | فخرا بمجدك لا عدمت الراكبا |
صبرت أسحار السماح بواكرا | وجعلت أيام الكفاح غياهبا |
وبذلت للمداح صفو خلائق | لو أنها للبحر طاب مشاربا |
فرأوك في جنب النضار مفرطا | وعلى صلاتك والصلاة مواظبا |
إن يحرس الناس النضار بحاجب | كان السماح لعين مالك حاجبا |
لم يملؤوا فيك البيوت رغائبا | إلا وقد ملؤوا البيوت غرائبا |
أوليتني قبل المديح عناية | وملأت عيني هيبة ومواهبا |
ورفعت قدري في الأنام وقد رأوا | مثلي لمثلك خاطبا ومخاطبا |
في مجلس ساوى الخلائق في الندى | وترتبت فيه الملوك مراتبا |
وافيته في الفلك أسعى جالسا | فخرا على من قال أمشي راكبا |
فأقمت أنفذ في الأنام أوامرا | مني وأنشب في الخطوب مخالبا |
وسقتني الدنيا غداة وردته | ريا وما مطرت علي مصائبا |
فطفقت أملأ من ثناك وشكره | حقبا وأملأ من نداك حقائبا |
أثني فتثنيني صفاتك مظهرا | عيا وكم أعيت صفاتك خاطبا |
لو أن أعضانا جميعا ألسن | تثني عليك لما قضينا الواجبا |
كفى البدر حسنا أن يقال نظيرها | فيزهى ولكنا بذاك نضيرها |
وحسب غصون البان أن قوامها | يقاس به ميادها ونضيرها |
أسيرة حجل مطلقات لحاظها | قضى حسنها أن لا يفك أسيرها |
تهيم بها العشاق خلف حجابها | فكيف إذا ما آن منها سفورها |
وليس عجيبا أن غررت بنظرة | إليها فمن شأن البدور غرورها |
فكم نظرة قادت إلى القلب حسرة | يقطع أنفاس الحياة زفيرها |
فواعجبا كم نسلب الأسد في الوغى | ويسلبنا من أعين الحور حورها |
فتور الظبى عند القراع يشينها | وما يرهف الأجفان إلا فتورها |
وجذوة حسن في الخدود لهيبها | يشب ولكن في القلوب سعيرها |
إذا آنستها مقلتي خر صاعقا | فؤادي وقال القلب لادك طورها |
وسرب ظباء مشرقات شموسه | على حلة عند النجوم بدورها |
تمانع عما في الكناس أسودها | وتحرس ما تحوي القصور صقورها |
تغار من الطيف الملم حماتها | ويغضب من مر النسيم غيورها |
إذا ما رأى في النوم طيفا يرودها | توهمه في اليوم ضيفا يزورها |
نظرنا فأعدتنا السقام جفونها | ولذنا فأولتنا النحول خصورها |
وزرنا وأسد الحي تذكي لحاظها | ويسمع في غاب الرماح زئيرها |
فيا ساعد الله المحب فإنه | يرى غمرات الموت ثم يزورها |
ولما ألمت للزيارة خلسة | وسجف الدياجي مسبلات سورها |
سعت بيننا الواشون حتى حجولها | ونمت بنا الأعداء حتى عبيرها |
وهمت بنا لولا حبائل شعرها | خطا الصبح لكن قيدته ظفورها |
ليالي يعديني زماني على العدا | وإن ملئت حقدا علي صدورها |
ويسعدني شرخ الشبيبة والغنى | إذا شانها أفتارها وقتيرها |
ومذ قلب الدهر المجن أصابني | صبورا على حال قليل صبورها |
فلو تحمل الأيام ما أنا حامل | لما كاد يمحو صبغة الليل نورها |
سأصبر إما أن تدور صروفها | علي وإما تستقيم أمورها |
فإن تكن الخنساء إني صخرها | وإن تكن الزباء إني قصيرها |
وقد أرتدي ثوب الظلام بجسرة | عليها من الشوس الحماة جسورها |
كأني بأحشاء السباسب خاطر | فما وجدت إلا وشخصي ضميرها |
وصادية الأحشاء غصى بآلها | يعز على الشعرى العبور عبورها |
ينوح بها الخريت ندبا لنفسه | إذا اختلفت حصباؤها وصخورها |
إذا وطئتها الشمس سال لعابها | وإن سلكتها الريح طال هريرها |
وإن قامت الحرباء ترصد شمسها | أصيلا أذاب الحظ منها هجيرها |
تجنب عنها للحذار جنوبها | وتدبر عنها في الهبوب دبورها |
خبرت مرامي أرضها فقتلتها | وما يقتل الأرضين إلا خبيرها |
بخطوة مر قال أمون عثارها | كثير على وفق الصواب عثورها |
ألذ من الأنغام رجع بغامها | وأطرب من سجع الهديل هديرها |
نساهم شطر العيش عيسا سواهما | لطول السرى لم يبق إلا شطورها |
حروفا كنونات الصحائف أصبحت | تخط على طرس الفيافي سطورها |
إذا نظمت نظم القلائد في البرى | تقلدها خصر الربا ونحورها |
طواها طواها فاغتدت وبطونها | تجول عليها كالوشاح ظفورها |
يعبر عن فرط الحنين أنينها | ويعرب عما في الضمير ضمورها |
نسير بها نحو الحجاز وقصدها | ملاعب شعبي بابل وقصورها |
فلما ترامت عن زرود ورملها | ولاحت لها أعلام نجد وقورها |
وصدت يمينا عن شميط وحاذرت | ربا قطن والشهب قد شف نورها |
وعاج بها عن رمل عاج دليلها | فقامت لعرفان المراد صدروها |
غدت تتقاضانا المسير لأنها | الى نحو خير المرسلين مسيرها |
ترض الحصى شوقا لمن سبح الحصى | لديه وحيا بالسلام بعيرها |
إلى خير مبعوث إلى خير أمة | إلى خير معبود دعاها بشيرها |
ومن بشر الله الأنام بأنه | مبشرها عن إذنه ونذيرها |
ومن أخمدت مع وضعه نار فارس | وزلزل منها عرشها وسريرها |
ومن نطقت توراة موسى بفضله | وجاء به إنجيلها وزبورها |
محمد خير المرسلين بأسرهم | وأولها في المجد وهو أخيرها |
فيا آية الله التي مذ تبجلت | على خلقه أخفى الظلال ظهروها |
عليك سلام الله يا خير مرسل | إلى أمة لولاه دام غرورها |
عليك سلام الله يا خير متشافع | إذا النار ضم الكافرين حصيرها |
عليك سلام الله يا من تعبدت | له الجن وانقادت إليه أمورها |
تشرفت الأقدام لما تتابعت | إليك خطاها واستمر مريرها |
وفاخرت الأفواه نور عيوننا | بتربك لما قبلته ثغورها |
ولو وفت الوفاد قدرك حقه | لكان على الأحداق منها مسيرها |
لأنك سر الله والآية التي | تجلت فجلى ظلمة الشرك نورها |
مدينة علم وابن عمك بابها | فمن غير ذاك الباب لم يؤت سورها |
شموس لكم في الغرب مدت شموسها | بدور لكم في الشرق حفت بدورها |
جبال إذا ما الهضب دكت جبالها | بحور إذا ما الأرض غارت بحورها |
فيا آل خير الآل والعترة التي | محبتها نعمى قليل شكورها |
إذا جولست للبذل ذل نضارها | وإن سوجلت في الفضل عز نظيرها |
وصحبك خير الصحب والغرر التي | بهم أمنت من كل أرض ثغورها |
كماة حماة في القراع وفي القرى | إذا شط قاريها وطاش وقورها |
أيا صادق الوعد الأمين وعدتني | ببشرى فلا أخشى وأنت بشيرها |
بعثت الأماني عاطلات لتبتغي | نداك فجاءت حاليات نحورها |
وأرسلت آمالا خماصا بطونها | إليك فعادت مثقلات ظهورها |
إليك رسول الله أشكو جرائما | يوازي الجبال الراسيات صغيرها |
كبائر لو تبلى الجبال بحملها | لدكت ونادى بالثبور ثبيرها |
وغالب ظني بل يقيني أنها | ستمحى وإن جلت وأنت سفيرها |
لأني رأيت العرب تخفر بالعصا | وتحمي إذا ما أمها مستجيرها |
فكيف بمن في كفه أورق العصا | يضام بنو الآمال وهو خفيرها |
وبين يدي نجواي قدمت مدحة | قضى خاطري أن لا يضيع خطيرها |
يروي غليل السامعين قطارها | ويجلو عيون الناظرين قطورها |
وأحسن شيء أنني قد جلوتها | عليك وأملاك السماء حضورها |
تروم بها نفسي الجزاء فكن لها | مجيزا بأن تمسي وأنت مجيرها |
فلا بن زهير قد أجزت ببردة | عليك فأثرى من ذويه فقيرها |
أجرني أجزني واجزني أجر مدحتي | ببرد إذا ما النار شب سعيرها |
وقابل ثناها بالقبول فإنها | عرائس فكر والقبول مهورها |
فإن زانها تطويلها واطرادها | فقد شانها تقصيرها وقصورها |
إذا ما القوافي لم تحط بصفاتكم | فسيان منها جمها ويسيرها |
بمدحك تمت حجتي وهي حجتي | على عصبة يطغى علي فجورها |
أقص بشعري إثر فضلك واصفا | علاك إذا ما الناس قصت شعورها |
وأسهر في نظم القوافي ولم أقل | خليلي هل من رقدة أستعيرها |
دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان / دار الفكر، دمشق - سوريا-ط 1( 1998) , ج: 3- ص: 68
عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر ابن أبي العز بن سرايا بن باقي بن عبد الله بن العريض السنبسي الطائي الحلي صفي الدين ولد في شهر ربيع الآخر سنة 677 وتعانى الأداب فمهر في فنون الشعر كلها وتعلم المعاني والبيان وصنف فيها وتعاني التجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في التجارة ثم يرجع إلى بلاده وفى غضون ذلك يمدح الملوك والأعيان وأنقطع مدة إلى ملوك ماردين وله في مدائحهم الغرر وأمتدح الناصر محمد بن قلاون والمؤيد إسماعيل بحماة وكان يتهم بالرفض وفي شعره ما يشعر به وكان مع ذلك يتنصل بلسان قاله وهو في أشعاره موجود وأن كان فيها ما يناقض ذلك وأول ما دخل القاهرة سنة بضع وعشرين فمدح علاء الدين ابن الأثير فاقبل عليه وأوصله إلى السلطان وأجتمع بابن سيد الناس وابي حيان وفضلاء ذلك العصر فاعترفوا بفضائله وكان الصدر شمس الدين عبد اللطيف .... يعتقد أنه ما نظم الشعر أحد مثله مطلقا وديوان شعره مشهور يشتمل على فنون كثيرة وبديعيته مشهورة وكذا شرحها وذكر فيه أنه استعد من مائة وأربعين كتابا ومن محاسن شعره
إذا لم أبرقع بالحيا وجه عفتى | فلا أشبهته راحتي في التكرم |
ولا أنا ممن يكسر الجفن في الوغى | إذا أنا لم أغضضه عن فعل محرم |
لا يسمع العود منا غير خاضبه | من لبة الشوس يوم الروع بالعلق |
ولا يعاطى كميتا غير مصدرها | يوم الصدام بليل العطف بالعرق |
يا جوادا أكفه في مجال الحرب | حتف وفى النوال غمامه |
تصدق علي بمعكوس ضد | مصحف قولي خبت تاره |
أعوزتنا إحدى العقاقير في الدر | ياق أتحف بها تكن خير تحفه |
ضعف تصحيف ضد مشطور مثل | لمثنى معكوس ترخيم دفه |
#تقول بسك منى لقول صدك عنى بالخنى والغدر يا شقيق البدر
#وكان ظنك أنى يكون ذلك فنى عند ضيق الصدر يا جليل القدر فان هذين البيتين إذا قرئا بالهجاء حرفا حرفا خرج منهما مواليا موزونة مات سنة 752 قال الصفدي تخمينا وأما زين الدين ابن حبيب فأرخه سنة خمسين
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند-ط 2( 1972) , ج: 1- ص: 0
عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر الطائي الحلي صفي الدين
ولد في شهر ربيع الآخر سنة 677 سبع وسبعين وستمائة وتعانى الأدب فمهر في فنون الشعر كلها وفي علم المعاني والبيان والعربية وتعانى التجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في التجارة ثم يرجع إلى بلاده وفي غضون ذلك يمدح الملوك والأعيان وانقطع مدة إلى ملوك ماردين وله في مدائحهم الغرر وامتدح الناصر محمد بن قلاون والمؤيد وكان يتهم بالرفض قال ابن حجر وفي شعره ما يشعر به وكان مع ذلك يتنصل بلسانه وهو في أشعاره موجود فإن فيها ما يناقض ذلك وأول ما دخل القاهرة سنة بضع وعشرين فمدح علاء الدين بن الأثير فاقبل عليه وأوصله إلى السلطان واجتمع بابن سيد الناس وأبي حيان وفضلاء ذلك العصر فاعترفوا بفضائله وكان الصدر شمس الدين عبد اللطيف يعتقد أنه ما نظم الشعر أحد مثله وهذا لا يسلمه من له معرفة بالأدب بالنسبة إلى أهل عصره فضلاء عن غيرهم وديوان شعره مشهور يشتمل على فنون كثيرة وله البديعية المشهورة وجعل لها شرحاً وذكر فيه أنه استمد من مائة وأربعين كتاباً ومن محاسن شعره وفيه الاستخدام في كلا البيتين
إذا لم أبرقع بالحيا وجه عفتي | فلا أشبهته راحتي في التكرم |
ولا كنت ممن يكسر الجفن في الوغى | إذا أنا لم أغضضه عن فعل محرم |
دار المعرفة - بيروت-ط 1( 0) , ج: 1- ص: 358
عبد العزيز بن سرايا الحلى صفي الدين.
صاحب البديعية وغيرها ولد في ربيع الآخر سنة 677.
* من نظمه:
قلوبنا مودوعة عندكم | أمانة تعجزوا عن حملها |
إن لم تصونوها بإحسانكم | ردوا الأمانة إلى أهلها |
* وله أيضاً:
تناسيت وعدى وأهملته | وغرك في ذاك منى السكوت |
إلى أن علاه الربى والمطال | وخيم من فوقه العنكبوت |
* وله أيضاً:
دبت عقارب صدغه في خده | وسعى على الأرداف أرقم جعده |
صنم أضل العاشقين فلن يرى | مذ لاح بدا من عبادة قده |
ما بين إقبال الحياة ووصله | فرق ولا بين الممات وضده!! |
ظبي من الأتراك ليس بتارك | حسنا لمخلوق أتى من بعده |
عض الحياء حال الرداء كما | نحلت بشاشة وجهه بزروده |
حمل السلاح على قوام مترب | كاد الحديد يمده بمراده |
فترى حمائل سيفه في نحره | أبهى وأزهر من جواهر عقده |
من آل خاقان الذين رضيعهم | في سرجه فكأنما في مهده |
جعلوا ركوب الخيل حد بلوغهم | شأن الفتى منهم بلوغ أشده |
وإذا صغيرهم أتى متخضبا | بدم الفوارس قيل بالغ رشده |
من كل مسنون الحسام كلحظه | أو كل معتدل القناة كقده |
ومخلق بدم الكماة كأنما | صبغت أنامل كفه من خده |
ومقابل يد العجاج بوجهه | فكأنما غشى الظلام بضده |
ومواجه صدر الحسام ووجهه | يبدى صقالا مثل ماء فرنده |
ما زلت أجهد في رياضة خلقه | وأجول في هزل العتاب وجده |
حتى تيسر بعد عسر صعبه | وافتر مبسم لفظه عن وعده |
وأتى يبشر سالفيه بسرعة | حدر.... بسطها في بعده!؟ |
وغدا يزف من المدامة مثلها | في فيه [من] خمر الرضاب وشهده |
لا عبته بالبردتين وبيننا | رهن قد ارتضت النفوس بفقده |
حتى رأيت نعوش سعدي قد بدت | ويداي قد خلت لششر زنده |
فأجل شطرنج هناك لعبته | بأقل ما أبدته لعبة نرده |
توفي في آخر سنة 749.
دار التراث العربي - القاهرة-ط 1( 1972) , ج: 3- ص: 0