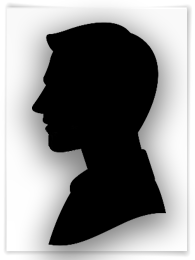الرحالة الحكيم ناصر خسرو القبادياني العلوي البلخي المروني
الرحالة الحكيم ناصر خسرو القبادياني العلوي البلخي المروني ولد في ذي القعدة سنة 394 في قصبة قباديان وتوفي سنة 481 في غار (يمكان) هو أبو معين الدين السيد ناصر بن خسرو بن الحارث بن عيسى بن حسن بن محمد (الأعرج) بن أحمد بن موسى (المبرقع) ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا عليهما السلام الرحالة والشاعر الفارسي المعروف والحكيم المشهور. وبلده (قباديان) من توابع مدينة (مروشاهجهان) الواقعة بشمال إقليم خراسان من نواحي مدينة (بلخ) وتقع (قباديان) شمالي شرقي (بلخ) وهي الآن من إقليم تركستان الروسية. وقد كانت (مروشاهجهان) عاصمة السلاطين السلاجقة ردحا من الزمن. وذكر المترجم تاريخ ميلاده في البيت التالي من شعره الفارسي:
بكذشت زهجرت بس سيصد نودوجار | بنهاد مرامادر برمركز أغبر |
وقبيل بلوغه السادسة والعشرين من عمره التحق ببعض الوظائف الديوانية العالية في بلاطي كل من السلطان محمود الغزنوي وابنه السلطان مسعود الغزنوي ثم في ديوان أبو سليمان جفري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق من أمراء السلاجقة الذين استولوا على بلخ سنة 432 وكانت تعهد إليه في الغالب الشؤون المالية في البلاد. وانتقل المترجم من (بلخ) إلى (مرو) التي كان يحكمها أبو سليمان المذكور وكان من المقربين للسلاطين والأمراء فيجالسهم ويحضر محافل أنسهم وطربهم. وكان السلطان يسميه عادة (خواجة خطير)، وكان يعد من أثرياء زمانه، وقضى عهد شبابه كله منتقلا من وظائف دواوين وبلاطات الملوك والسلاطين والأمراء حتى بلغ الثالثة والأربعين من عمره حيث اعتزل الوظائف أثر رؤيا حلم بها: وهي أنه رأى فيما يرى النائم من يدعوه إلى ترك شرب الخمر التي كان يدمنها، والبحث عن الحقيقة والتزهد في الحياة والقيام برحلة إلى مكة لأداء فريضة الحج.
لذلك ترك الإقامة في موطنه واعتزم القيام برحلات في بعض الأمصار قاصدا فيها مكة يرافقه أخوه أبو سعيد خسرو العلوي وغلام هندي.
ففي الثالث من شهر شعبان 437 ترك (مرو) وسافر إلى إقليم أذربيجان مارا (بنيسابور) و(دامغان) و(سمنان) و(الري) و(قزوين) ثم (تبريز) حاضرة إقليم (أذربيجان) حيث وصلها في 20 صفر سنة 438 وكان أميرها (سيف الدولة أبو منصور وهودان بن محمد مولى أمير المؤمنين) وبعد أن مكث فيها مدة من الزمن بارحها إلى (مرند) و(خوى) وانتقل منها إلى بعض مدن أرمينية مثل (وان) و(اخلاط) و(بطليس) و(آمد) ومنها سافر إلى أسيا الصغرى ثم (حران) والبلاد السورية ومر (بمعرة النعمان) حيث كان أبو العلاء المعري حيا فيها ولكنه لم يجتمع به. وزار (حلب) و(طرابلس الشام) و(صيدا) و(صور) و(بيروت) و(دمشق) ومنها سافر إلى (القدس) التي وصلها في الخامس من شهر رمضان 438 ومكث فيها مدة تنوف على الشهرين وفي حوالي منتصف شهر ذي القعدة من السنة نفسها رحل منها إلى مكة لأداء فريضة الحج. وبعد الانتهاء منها عاد إلى القدس فوصلها في الخامس من المحرم سنة 439 ومنها سافر إلى (طينه) برا ثم إلى (القيروان) في تونس بحرا ومنها سافر إلى القاهرة فوصلها في السابع من شهر صفر 439 فمكث فيها مدة تناهز ثلاث سنوات حج خلالها مرتين أخريين إلى بيت الله الحرام وزار في إحداها المدينة المنورة.
وفي يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة سنة 441 خرج من القاهرة متجها نحو الحجاز بالسفينة بطريق نهر النيل مارا (بأسيوط) التي مكث بها مدة عشرين يوما ومنها سافر إلى (أسوان) التي تركها في الخامس من شهر ربيع الأول سنة 442 نحو (عيذاب) الميناء السوداني على البحر الأحمر التي وصلها في الثامن من ربيع الأول سنة 442 ومكث فيها مدة ثلاثة أشهر ومنها رحل إلى مكة حيث أقام بها إلى أن حان موسم الحج مؤديا فيه فريضته للمرة الرابعة في ذي الحجة من سنة 442 وبارح مكة في 19 ذي الحجة من السنة ذاتها إلى الطائف ومنها رحل إلى تهامة واليمن والإحساء التي شاهد فيها تشكيلات القرامطة وسافر منها إلى (البصرة) التي وصلها في العشرين من شهر شعبان 443 وكان يحكمها (ابن أبا كاليجار الديلمي). وقد أقام بها حتى منتصف شهر شوال سنة 443 حيث بارحها إلى (عبادان) ثم ميناء (مهروبان) على ساحل الخليج الفارسي ومنها إلى مدينة (أرجان) في إقليم فارس بجنوب إيران. وفي أول المحرم من سنة 444 رحل منها إلى (أصفهان) فوصلها في الثامن من شهر صفر من هذه السنة وغادرها في 28 من الشهر نفسه واتجه نحو (نائين) و(طبس) و(تون) بشمالي شرقي إيران ووصل محلا يدعى (الرقة) ومنها سافر إلى (تون) ومنها إلى (قاين) التي وصلها في 23 ربيع الثاني عام 444 ومكث فيها مدة شهر واحد ثم رحل منها إلى (سرخس) وبارحها نحو (مرو الرود) ثم رحل منها إلى (بلخ) التي وصلها بصحبة أخيه أبو سعيد في السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 444 واجتمع فيها بأخيه الآخر أبو الفتح عبد الجليل الذي كان من كبار موظفي بلاط السلاجقة، وقد بلغ المترجم عندئذ من العمر خمسين عاما، وقطع في رحلته هذه التي طالت سبع سنوات مسافة (2220) فرسخا.
وقد لقي (ناصر خسرو) في هذا الرحلة أهوالا جساما ومشاق كثيرة ومتاعب وفيرة خاصة أثناء اجتيازه جزيرة العرب، وقد ذكرها كلها في رحلته المعروفة باسم (سفرنامه ناصر خسرو) التي ضمنها وصفا ضافيا لما شاهده في هذه الرحلة من مدن وقرى وأديرة ومعابد وقصور وبلاطات ولمن اجتمع بهم من العلماء والفقهاء والشعراء والأمراء والملوك والحكام والزهاد وغيرهم.
وأثناء إقامة (ناصر خسرو) في مصر وخاصة (القاهرة) حوالي ثلاث سنوات توطدت الصلات بينه وبين الخليفة الفاطمي بمصر المستنصر بالله أبو تميم معد بن علي الذي حكم مصر من سنة 427 إلى سنة 478، كما تعززت العلاقات بينه وبين علماء المذهب الإسماعيلي الفاطمي وقادته، وقد أثرت فيه دعوتهم له لاعتناق مذهبهم فاعتنقه على يد أحد حجاب الدعوة في القاهرة الذي لم يذكر المترجم اسمه وكان يسميه (الباب) وكان أحد النقباء في هذا المذهب. واجتاز المترجم المقامات والدرجات الخاصة بكبار قادة هذا المذهب حتى بلغ درجة (الحجة) واعتبر أحد الحجج الاثني عشر الذي أنيط به أمر نشر الدعوة للخلفاء الفاطميين في إحدى الجزر الاثني عشر حسب تقسيمات الفاطميين عهدئذ وعين من قبل المستنصر بالله الفاطمي (حجة) على جزيرة (خراسان) وأصبح من الداعين له ومن المتحمسين في هذا المذهب وتعهد بالدعوة له في إيران وخاصة (خراسان) وما وراء النهر ولذلك نجده يطلق على نفسه في بعض مؤلفاته اسم (الحجة) أو (حجة خراسان) أو (حجة ابن النبي) و(الحجة المستنصرية) أو (حجة نائب النبي) أو (مأمور) أو (أمين إمام الزمان) أو (مختار إمام العصر) أو (المستعين بمحمد) أو (المنتخب من علي المرتضى).
وحين عودة المترجم إلى (بلخ) أخذ يدعو علنا للمذهب الإسماعيلي الفاطمي ويناقش العلماء والفقهاء وخاصة علماء المذهب السني فيه، مما دعا هؤلاء إلى معارضته ومحاجته ورفع راية الخلاف ضده. الأمر الذي حدا بسلاطين السلاجقة وأمراء خراسان لمطاردته أينما وجد. فهرب من (بلخ) قبيل سنة 453 وأصبح من جراء ذلك مشردا متنقلا سرا من مدينة إلى أخرى ومن قصبة إلى قرية في أقاليم خراسان ومازندران إلى أن انتهى به المطاف سنة 456 إلى (غارايمكان) الواقع قرب مدينة (بدخشان) وهي اليوم من مدن أفغانستان. وأقام فيها مختفيا بعيدا عن الأنظار إلى أن توفاه الله في (غارايمكان) حيث دفن فيه. ومزاره الآن معروف هناك يزار لا سيما من قبل الإسماعيليين.
وقد قضى المترجم الشطر الأخير من عمره في التأليف والتصنيف ونظم الشعر بلغته الفارسية وبأسلوبه الخاص به، كما أنه زهد في الحياة واتخذ جانب العزلة ولكنه لم يترك دعوته للفاطميين حيث واصل جهاده في الدعوة لهم بحرارة وفي إرسال دعاته إلى الأطراف لبث دعوته. وكان قوي الحجة بارعا في الجدل العلمي والنقاش الديني، وأوقف معظم وقته في عزلته للمناقشات الدينية والمذهبية وتعتبر المدة التي قضاها في هذا الغار من أنشط أيام حياته الذهنية.
(مؤلفاته)
مؤلفاته كثيرة وقد كتبها كلها إلا ما ندر باللغة الفارسية. وعرف منها حتى الآن (1) رحلته التي ألفها بعد عودته من مصر إلى بلخ مباشرة. وقد طبعت عدة مرات. (2) زاد المسافرين الذي انتهى منه في سنة 453 وهو من أضخم مؤلفاته، مطبوع (3) وجه دين، مطبوع (4) خوان إخوان مطبوع (5) روشنائي نامة مطبوع (6) سعادت نامة مطبوع (7) دليل المتحيرين الذي أراد أن يثبت فيه أحقية المذهب الفاطمي مخطوط ونادر (8) ديوان شعره الذي قيل إنه كان يضم بين دفتيه 30 ألف بيت من الشعر الفارسي ولكن المطبوع منه لا يحتوي إلا على ما يربو على ال11 ألف بيت بقليل (9) دبستان العقول مخطوط نادر، وقد نسبت إليه كتب أخرى ورد ذكرها في بعض المخطوطات القديمة ولم يعثر عليها، منها (10) أكسير أعظم في المنطق أو الفلسفة (11) قانون أعظم في السحر وعلوم ما وراء الطبيعة (12) رسالة المستوفي في الفقه (13) رسالة في علم اليونان (14) رسالة دستور أعظم (15) رسالة كنز الحقائق (16) تفسير القرآن.
ورغم أنه جاء ذكر في بعض أبياته الفارسية أنه نظم الشعر باللغة العربية أيضا ولكنه لم يعثر حتى الآن على نظم له بالعربية ولا على ديوان له بهذه اللغة في حين أنه قال إن له ديوان شعر بهذه اللغة.
هذا وقد ذكرت بعض المصادر أن (ناصر خسرو) جاب الهند ورحل إلى الأفغان في شرخ شبابه على زمن السلطانين محمود ومسعود الغزنوي، ولكنه نفسه لم يشر إلى هذا الأمر في إنشاآته.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 10- ص: 202