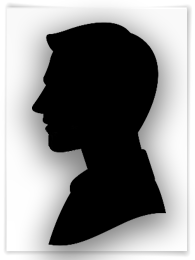محمد بن أحمد بن طباطبا الحسني، أبو الحسن
أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا الحسني
كان شاعرا أديبا من ذرية أبي هاشم محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فأما أن يكون غير المترجم وأما أن يكون وقع خلل في ذكر نسبته في أحد الموضعين. وذكره ابن خلكان في أثناء ترجمة أبي القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا فقال بعد ذكر بيتين نسبهما لأبي القاسم: ثم وجدت هذين البيتين في ديوان أبي الحسن بن طباطبا ولا أدري من هذا أبو الحسن ولا وجه النسبة بينه وبين أبي القاسم المذكور ومما مر يعلم من هو أبو الحسن هذا ويعلم وجه النسبة بينه وبين أبي القاسم وأنه من أبناء عمه مساولة في قعدد النسب. وفي رياض العلماء في باب الكنى: أبو الحسن بن طباطبا العلوي الشاعر كان من أكابر قدماء علماء الشيعة وشعرائهم قال ابن خلكان إنما سمي طباطبا لأنه كان ألثغ إلى آخر ما مر في أحمد بن محمد بن إسماعيل ثم قال وتوفي سنة 345 وعمره 64 سنة ثم قال صاحب الرياض طباطبا لقب لوالده بل لجده أما تاريخ الوفاة فله، ثم قال: أبو الحسن بن طباطبا العلوي كان شاعرا وقد ينقل الشيخ أبو الفتوح الرازي بعض أشعاره في ذم الخمر في كتاب شرح الشهاب ولم أعلم عصره بخصوصه بل ولا اسمه ومذهبه أقول: صاحب الرياض كان يعلق أشياء في مسودة كتابه حسبما يراها قبل تمحيصها وبقيت كذلك في المسودة ولذلك قد يقع فيها تناقض وخلل كما وقع هنا: (أولا) إن ابن خلكان لم يجعل طباطبا لقبا لأبي الحسن بل جعله لإبراهيم كما هو الصواب (ثانيا) جزمه بأن تاريخ الوفاة لأبي الحسن بل هو في كتاب ابن خلكان تاريخ لوفاة أحمد بن محمد بن إسماعيل كما مر هناك وأما أبو الحسن فتوفي سنة 322 كما مر هنا والذي أوقعه في الاشتباه أن ابن خلكان ذكر أبا الحسن في أثناء ترجمة أحمد بن محمد ثم ذكر تاريخ وفاة أحمد فظن أنه تاريخ لوفاة أبي الحسن (ثالثا) أنه ذكر أولا: الحسن بن طباطبا العلوي الشاعر وجزم أن تاريخ الوفاة المنقول عن ابن خلكان له ثم ذكر أبو الحسن بن طباطبا العلوي الشاعر وجزم أن تاريخ الوفاة المنقول عن ابن خلكان له ثم ذكر أبو الحسن بن طباطبا العلوي وقال كان شاعرا ولم أعلم عصره بخصوصه ولا اسمه ولا مذهبه مع أنه هو المذكور أولا بعينه الذي قال إنه من قدماء علماء الشيعة وشعرائهم وهذا يدل على ما قلناه بأنه كان يعلق أشياء في المسودة قبل تمحيصها. وفي معجم الشعراء للمرزباني: شيخ من شيوخ الأدب وله كتب ألفها في الأشعار والآداب وكان ينزل أصبهان وهو قريب الموت وأكثر شعره في الغزل والآداب وفي فهرست ابن النديم: ابن طباطبا العلوي له في الشعر والشعراء وله من الكتب: كتاب سنام المعالي. كتاب عيار الشعر. كتاب الشعر والشعراء. ديوان شعره.
أخباره
في معجم الأدباء: ذكر أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهاني قال سمعت جماعة من رواة الأشعار ببغداد يتحدثون عن عبد الله بن المعتز أنه كان لهجا بذكر أبي الحسن مقدما له على سائر أهله ويقول ما أشبهه في أوصافه إلا محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك إلا أن أبا الحسن أكثر شعرا من المسلمي وليس في ولد الحسن من يشبهه، بل يقاربه علي بن محمد الأفوه قال وحدثني أبو عبد الله بن أبي عامر قال كان أبو الحسن طول أيامه مشتاقا إلى عبد الله بن المعتز متمنيا أن يلقاه أو يرى شعره فأما لقاؤه فلم يتفق له لأنه لم يفارق أصبهان قط وأما ظفره بشعره فإنه اتفق له في آخر أيامه وله في ذلك قصة عجيبة: وذلك أنه دخل إلى دار معمر وقد حملت إليه من بغداد نسخة من شعر عبد الله بن المعتز فاستعارها. . فسوف بها فتمكن عندهم من النظر فيها وخرج وعدل إلي كالا معيبا كأنه ناهض بحمل ثقيل فطلب محبرة وكاغدا وأخذ يكتب عن ظهر قلبه مقطعات من الشعر فسألته لمن هي فلم يجبني حتى فرغ من نسختها وملأ منها خمس ورقات من نصف المأموني وأحصيت الأبيات فبلغت 187 بيتا تحفظها من شعر ابن المعتز في ذلك المجلس واختارها من بين سائرها. وكتب عنه الدكتور أحمد أحمد بدوي:
في مدينة أصبهان ولد ابن طباطبا. ولا يحفظ التاريخ عام ميلاده. وإن ذكر وفاته سنة 322ه، أي أنه عاش في الشطر الثاني من القرن الثالث، وجزء من القرن الرابع للهجرة. ولم تكن الحياة السياسية يومئذ للدولة العباسية قوية مستقرة، بل أصابها الضعف والانحلال منذ قتل الأتراك الخليفة المتوكل سنة 247ه فضاعت هيبة الخلافة، ولم يعد للخليفة سلطان ولا نفوذ إلا في قليل من الأحيان، وكثيرا ما شب الخلاف بين أبناء الأسرة العباسية على الخلافة، أو ولى أمرها صبي لا يستطيع أن يلي شؤون الخلافة. في هذا العهد عاش ابن طباطبا، ولكن هذا الاضطراب السياسي لم يحل دون الازدهار العلمي، وانكباب العلماء على الكتب يجمعون فيها خلاصة تجاربهم، وما وصلوا إليه من آراء، بل يبدو أن هذه الحياة السياسية الصاخبة المضطربة جعلته ينصرف عنها إلى الدراسة والإنتاج، فأنا لا تعرف له مشاركة في الأحداث السياسية، وكل ما عرفه له التاريخ أنه كان شيخا من شيوخ الأدب. ولم يحدثنا من أرخ له عن ثقافته، ولكننا نستطيع أن نعرف هذه الثقافة من المنهج الثقافي الذي وضعه، وأوجب على الشعراء أن يأخذوا به، فقد كان شاعرا، ومن المرجح أن يكون قد عمل بهذا المنهج، فإنه يراه ضروريا للشاعر، إذ يقول: "وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه، فمن تعصت عليه أداته لم يكمل له ما يتكلفه، وبأن الخلل فيما ينظمه، ولحقته العيوب من كل جهة".
"فمنها التوسع في علم اللغة" والبراعة في فهم الإعراب، والرواية لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم، ومناقبهم، ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب في نظم الشعر، والتصرف في معانيه، في كل فن قالتها العرب فيه، وسلوك مناهجها في صفاتها، ومخاطباتها، وحكاياتها، وأمثالها. ولابد أن يكون قد درس ذلك، وأن يكون قد أضاف إليه معرفة واسعة بتقاليد العرب وعاداتها. ويمضي "ابن طباطبا" في إيراد الشواهد الكثيرة المنبئة عن تلك التقاليد ويظهر أن "ابن طباطبا" كان رجلا مشغوفا بالعلم، مكبا على تحصيله مقبلا على العلماء يأخذ عنهم ما رووه في حب واستزادة، حتى صح له أن يفتخر ويقول:
حسود مريض القلب يخفى أنينه | ويضحي كئيب البال منى حزينه |
بلوم على أن رحت في العلم راغبا | أجمع من عند الرواة فنونه |
وأسلك أبكار الكلام وعونه | وأحفظ مما أستفيد عيونه |
ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى | ويحسن بالجهل الذميم ظنونه |
فيما لائمي، دعني أغالي بقيمتي | فقيمة كل الناس ما يحسنونه |
إذا عدا غنى الناس لم أك دونه | وكنت أرى الفخر المسود دونه |
إذا ما رأى الراؤون وعيه | رأوا حركاتي قد هتكن سكوته |
وما ثم ريب في حياتي وموته | فأعجب لميت كيف لا يدفنونه |
أبى الله لي من صنعة أن يكونني | إذا ما ذكرنا فخرنا وأكونه |
وكان مغرما بالكتب يعدها أغلى من الأصدقاء، ويقول:
إذا فجع الدهر امرأ بخليله | تسلى، ولا يسلى لفجع الدفاتر |
بل إن له كتابا في تقريظ الدفاتر. وهو يؤمن بأن "من صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به".
ولكنك تعجب أن يذكر له ياقوت ضمن ما صنفه كتابا في العروض لم يسبق إلى مثله، فلعل كراهيته لهذا العلم دعته إلى أن يصمم على تذليله، إلى درجة تمكنه من التأليف فيه، أو لعل وصف كتابه بأنه لم يسبق إلى مثله يؤذن بأنه نهج في عرض هذه المادة تهجا جديدا يسهل جناها للدارسين. ولست أدري موقفه من علم القوافي، وهو ملازم لعلم العروض وشقيق له في التأليف، غير أنه قد وصل في كتابه "عيار الشعر" إلى حصر قوافي الشعر. وأعان "ابن طباطبا" على طلب العلم ما عرف به من "الذكاء والفطنة، وصفاء القريحة، وصحة الذهن". ومما يروى للدلالة على سرعة حفظه أن أحد الرواة ذكر أن "ابن طباطبا" دخل إلى دار حملت إليها من"بغداد" نسخة من شعر "عبد الله بن المعتز" فطلب استعارتها، فسوف بها، فتمكن في الدار أن ينظر فيها، ثم طلب محبرة وقرطاسا، ثم أخذ يكتب عن ظهر قلبه مقطعات من الشعر، حتى إذا فرغ من نسختها أحصيت الأبيات التي قيدها، فبلغ عددها مائة وسبعة وثمانين بيتا حفظها من شعر"ابن المعتز" في ذلك المجلس، واختارها من بين سائرها، وكان ذلك في آخر أيامه. وساعده عليه أيضا أنه كان غنيا يستطيع أن يفرغ للدراسة والاطلاع، ويدلنا على غناء أنه يقول لمن يزهده في طلب العلم بحجة أنه لا يجلب الغنى:
إذا عد أغنى الناس لم أك دونه | وكنت أرى الفخر المسود دونه |
فهو غني، ولكنه لا يكتفي من الحياة بالغنى وحده، بل يريد إلى جانبه مجدا علميا يجلب له الفخر والسؤدد. وإذا كان "ابن طباطبا" غنيا يكره الفقر، ويرى أن الحر يؤثر الموت عليه، إذ يقول:
قد يصبر الحر على السيف | ويجزع الحر من الحيف |
ويؤثر الموت على حالة | يعجز فيها عن قرى الضيف |
فإنه كان يحب القصد في الغنى، ويكره الإسراف فيه، ويرى الشراهة في جمع المال مهلكة لصاحبها، إذ تصرفه عن المجد العلمي، ولعلنا ندرك ذلك من قوله:
إن في نيل المنى وشك الردى | وقياس القصيد ضد السرف |
كسراج دهنه قوت له | فإذا غرقته فيه طفي |
ومما لا ريب فيه أن ذلك خير الأوضاع لطلب العلم والتفرغ له: غنى لا تصحبه شراهة إلى الازدياد. ولم يقصر "ابن طباطبا" على التحصل وحده، بل ترك لنا إنتاجا أدبيا بقي بعضه وباد بعضه، فمن ذلك:
1 - كتاب "عيار الشعر" الذي جمع آراءه في النقد الأدبي، وقد حققه وعلق عليه، وقدم له، ونشره سنة 1956م الدكتور طه الحاجري، والدكتور محمد زغلول سلام.
2 - وكتاب "تهذيب الطبع" ولعل هو كتاب "الشعر والشعراء" الذي نسبه إليه "ابن النديم" في كتابه: "الفهرست". أما كتاب "تهذيب الطبع" فقد أشار إليه الناقد في أكثر من موضع في كتابه: "عيار الشعر"، فهو يبين الغرض من تأليفه إذ يقول: "وقد جمعنا ما اخترناه من أشعار الشعراء في كتاب سميناه "تهذيب الطبع" يرتاض من تعاطى قول الشعر بالنظر فيه، ويسلك المنهاج الذي سلكه الشعراء ويتناول المعاني اللطيفة كتناولهم إياها، فيحتذي على تلك الأمثلة في الفنون التي طرقوا أقوالهم فيها".
3 - وله "كتاب في العروض" قال عنه ياقوت: "إنه لم يسبق إلى مثله" وقد سبقت الإشارة إليه.
4 - وكتاب "سنام المعالي" ولا أدري عنه شيئا.
5 - وكتاب "في المدخل في معرفة المعمي من الشعر"، وعنوانه يدل على موضوعه، فهو شرح لأبيات غامضة المعنى، يدل على تعمق صاحبه في فهم غريب الأشعار، وإدراك معانيها الغامضة.
6 - وكتاب في "تقريظ الدفاتر" سبق أن أشرنا إليه.
7 - وكتاب في "الشعر والشعراء" نسبه إليه "ابن النديم"، ولعله كتاب "تهذيب الطبع" الذي لم يذكره صاحب الفهرست.
8 - وديوان شعره.
ولم يبق لنا من ذلك اليوم، فيا أعرف، سوى كتاب "عيار الشعر"، وبضع قصائد وأبيات متناثرة أوردها معجم الأدباء، ومحاضرات الأدباء وتحفة العجائب وطرفة الغرائب، وكتاب التشبيهات، والمحمدون من الشعراء وأشعارهم، والمصون في الأدب. وقد يورد بعض هؤلاء بيتا أو بيتين، ثم يقول: "وهي أبيات كثيرة ذات أوصاف" ويقول القفطي في كتابه: "المحمدون من الشعراء" "وأكثر شعره في الغزل والآداب". ومما يذكر أن ابن طباطبا كان يؤمن، لتمكنه من اللغة، بمقدرته على أن يتجنب من الكلمات ما يصعب النطق به على من بلسانه عيب يحول بينه وبين النطق ببعض الحروف، ويروى عنه أنه قال: "والله أنا أقدر على أبي الكلام من واصل بن عطاء". ويروون للتدليل على ذلك أن ولدا لأحد أعيان الرجال كانت به لكنة شديدة حتى كان لا يجري على لسانه حرفان من حروف المعجم، هما: الراء، والكاف، يضع الغين مكان الراء، والهمزة مكان الكاف، فكان إذا أراد أن يقول: "كركى" يقول: (أ غ أ ى) فعمل "ابن طباطبا" قصيدة في مدح أبيه، حذف منها حرفي لكنة الولد، ولقنه إياها، حتى رواها لأبيه، ففرح بها فرحا شديدا. ومن تلك القصيدة:
يا سيد دانت له السادات | وتتابعت في فعله الحسنات |
وتواصلت نعماؤه عندي، فلي | منه هبات خلفهن هبات |
وهي قصيدة طويلة تبلغ تسعة وأربعين بيتا ختمها بقوله:
لو واصل بن عطاء الباني لها | تليت، توهم أنها آيات |
لولا اجتنابي أن يمل سماعها | لأطلتها ما خطت التاءات |
وليس شعره ما يرفعه، حتى إلى درجة أوساط الشعراء، ولكنه مما لا شك فيه أن معالجته لنظم الشعر جعلت له نظرات صائبة في النقد الأدبي، لأنها ناشئة عن ممارسة وتجربة. وكثير من آرائه في النقد الأدبي لم تفقد مع الزمن صحتها وجدتها. بل إن له بعض التعبيرات التي تشبه إلى حد كبير تعبيراتنا الحديثة.
1 - فمن أثر ممارسته لنظم الشعر هذا الرأي الذي أبداه في طريقة قرض الشعر، وأغلب الظن أنه كان يتبع هذا النهج في صنع قصائده. يقول ابن طباطبا: إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه، فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقضيه من المعاني، على غير تنسيق للشعر، وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه، على تفاوت ما بينه وبين ما قبله، فإذا كملت له المعاني، وكثرت الأبيات، وفق بينها بأبيات تكون نظاما لها، وسلكا جامعا لما تشتت منها. ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه، ونتجته فكرته، فيستقضي انتقاده، ويرمي ما وهى منها، ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية. وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من المعاني، واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول، وكانت تلك القافية أوقع في المنى الثاني منها في المعنى الأول، نقلها إلى المعنى المحار الذي هو أحسن، وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضه وطلب لمعناه قافية تشاكله، ويكون كالنساج الحاذق. . وكالنقاش الرفيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه. ويشيع كل صبغ منها، حتى يتضاعف حسنه في العيان". تلك هي الخطة التي أوصى "ابن طباطبا" بانتهاجها في نظم القريض أن يختار الشاعر الوزن و القافية، ثم يتقبل ما يجود به خاطره من شعر يتعلق بالمعنى الذي يريد النظم فيه، ثم يقوم تثقيفه وترتيبه، حتى تصبح القصيدة مترابطة منسقة. واختيار الشاعر للوزن والقافية مما يطالب به "ابن طباطبا" صانع الشعر، حتى لا يقع في وزن يصعب عليه المعنى فيه. وقد كرر الدعوة إلى اختيار القافية في موضع آخر من كتبه بعد أن حصر ألوان القوافي، فقال: "اختر من بينها أعها، وأشكلها للمعنى الذي تروم بناء الشعر عليه"، وذلك حتى لا يقع الشاعر في قافية لا تسلس لخواطره، ولا تنقاد لمعانيه.
2 - وإذا كان "ابن طباطبا" قد دعا إلى أن يضع الشاعر ين أبياته ما يربط بين هذه الأبيات حتى تتسق القصيدة، فذلك لأنه دعا إلى وحدة القصيدة دعوة حارة، وهو في ذلك يشبه آراء النقاد المحدثين إذ يقول: "وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما ينسق ه أوله مع آخره. . " فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل. . فإن العشر إذا أسس تأسيس كلمات الحكمة المستقلة بذاتها، والأمثال السائرة الموسومة باختصارها، لم يحسن نظمه، بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة، في اشتباه أولها بآخرها، نسجا حسنا، وفصاحة وجزالة ألفاظ، ودقة معان، وصواب تأليف، ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خروجا لطيفا،. . حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة أفراغا. . تقتضي كل كلمة ما عدها. ويكون ما بعدها متعلقا بها، مفتقرا إليها". ولكن ينبغي أن نشير هنا إلى أن "ابن طباطبا" مع دعوته إلى وحدة القصيدة والتلاؤم بين أجزائها، لم يمنع أن تشتمل القصيدة على الغزل والمدح، على أن يتخلص من أحدهما إلى الآخر بألطف تخلص. بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصلا به، وممتزجا معه.
ج - وإذا كان ابن طباطبا قد ألح على ضرورة وحدة القصيدة حتى تصبح كالكلمة، فإنه قد ألح على ضرورة الصدق، وهو ما نسميه اليوم بصدق التجربة ونكاد اليوم نعبر كما عبر ناقدنا العربي القديم عندما قال بعد حديثه عن أسباب تأثير الشعر في النفس:" فإذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات تضاعف حسن موقعها عند مستمعها، لاسيما إذا أيدت مما يجلب القلوب من الصدق عن ذات النفس، بكشف المعاني المختلجة فيها، والتصريح بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها". هذه النظرة الصائبة، إلى الصدق في الشعر يرى ابن طباطبا أنها كانت متحققة في شعراء الجاهلية الجهلاء وصدر الإسلام.
د - غير أن شيئا يحتمل الكذب فيه في حكم الشعر، ذلك هو الإغراق في الوصف، والإفراط في التشبيه، ويورد الناقد أمثلة للأبيات التي أغرق قائلوها في معانيها. ويبدو لي أن ابن طباطبا لم يكن راضيا عن هذا الإغراق، فإنه يقول بعد أن أورد أمثلة: "وقد سلك جماعة من الشعراء المحدثين سبيل الأوائل في المعاني التي أغرقوا فيها"، فالتعبير بجماعة يشعر باتجاهه الذي لا يرضى عن هذا الإغراق، كما أنه عندما تحدث عما يجب على الشاعر أن يتبعه، كان من ذلك أن يتعمد الصدق والوفق في تشبهاته وحكاياته. وأن حرارته في الحديث عن الصدق تدل على نفرته من المبالغة والإغراق.
ه - وللشعر الجيد صفات يجب أن تتحقق فيه، وأخرى يجب أن يبرأ منها، فمما ينبغي أن يتحقق في الشعر: جودة معناه، فالكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه، كما قال بعض الحكماء: الكلام جسد وروح، فجسده النطق وروحه معناه. وإن تشاكل الألفاظ المعاني، معنى أن يتأنق الشاعر في اختيار ألفاظه حتى تبدو المعاني في صورة قوية رائعة، فإن الألفاظ للمعاني كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض. وكم من معنى حسن شين بمعرضه الذي أبرز فيه، وكم معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه، وكم من زائف وبهرج قد نفقا على نقادهما، وكم من حكمة غريبة قد ازدريت لرثاثة كسوتها ولو جليت في غير لباسها ذلك لكثر المشيرون إليها. وهو بذلك كنقاد العرب الذين يعنون عناية كبرى بالصياغة وجمال عرض المعاني. ولم يحدد ناقدنا، أعني ابن طباطبا، معنى القبح في المعنى، ولكنه ضرب الأمثلة للمعاني الواهية سوف نوردها في مكانها. وأحسن الشعر ما وضعت فيه كل كلمة موضعها. حتى تطابق المعنى الذي أريدت له، من غير حو يجتلب، كأنما جيء ه لإكمال الوزن، ومن غير تفريق بين الكلمة وأختها، وأن تكو سهلة على اللسان، غير مستكرهة في مكانها ولا متعة. ومن الكلمات التي ينبغي أن توضع في مكانها قافية البيت، فينبغي أن تكون قد جاءت لمعنى يكمل به معنى البيت، لا ليتم بها وزن الشعر ليس غير، فيكون ما قبلها مسوقا إليها، ولا تكون مسوقة إليه، فتقلق في مواضعها، ولا توافق ما يتصل بها، ومعنى ذلك أن القافية ينبغي أن يسوق إليها البيت، فتأتي لتكمل معناه، وتكون لذلك مستقرة في مكانها غير قلقة ولا متعبة، أما إذا تم المعنى بدونها، واستجلبت القافية قسرا، ليكمل وزن البيت من الشعر فحسب، فأنها تكون قلقة لا تتصل بما قبلها. أما ما ينبغي اجتنابه في الشعر، فالتفاوت في نسجه، فإذا أسس الشاعر شعره على أن يأتي فيه بالكلام البدوي الفصيح لم يخلط به الحضري المولد، وإذا أتى بلفظة غريبة اتبعها أخواتها وكذلك إذا سهل ألفاظه لم يخلط بها الألفاظ الوحشية النافرة الصعبة القياد. ودعا ابن طباطبا الشاعر أيضا إلى اجتناب سفساف الكلام، وسخيف اللفظ، والمعاني المستبردة، والتشبيهات الكاذبة، والإشارات المجهولة، والأوصاف البعيدة، والعبارات الغثة، وجعل هذه الأشياء كأنما هي رقعة تزرى بالثوب الجميل. ودعا إلى أن يستعمل الشاعر من المجاز ما يقارب الحقيقة، ولا يبعد عنها ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني الحقيقة، ولا يبعد عنها ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بها.
و - وعاب "ابن طباطبا" أن تزيد قريحة الشاعر على عقله، ومعنى زيادة القريحة أن يستغرق الشاعر في فنه، يبحث عن معنى له قيمته في حد ذاته، يقطع النظر عن الظروف الأخرى، ومن الأمثلة التي ساقها الناقد العربي لذلك قول جرير:
هذا ابن عمي في دمشق خليفة=لو شئت ساقكم إلى قطينا
فالشاعر هنا قد استغرق في فن الفخر بنفسه، ومما لا شك فيه أن فخره يزداد قوة بأن يكون قريبا لخليفة دمشق، وأن يكون الخليفة بحيث لا يرد له طلبا، فلو أنه طل منه أن يجعلهم خدما له لنفذ الخليفة له ما يريد. ونسي جرير في غمرة الفخر أن الخليفة أكبر من أن يؤمر ولذلك يروي أن الخليفة قال له: جعلتني شرطيا لك. أما لو قلت "لو شاء ساقكم إلي قطينا" لسقتهم إليك عن آخرهم.
(ز) وابن طباطبا في هذا المقام يشبه النقاد المحدثين في نظرتهم الموضوعية إلى الشعر، فإن الشعر إذا كان ذاتيا، يصور تجربة ذاتية للشاعر، يختص بها، ولها سماتها ومعالهما التي تخصه وحده، فإن على الشاعر أن يتخذ هذه التجربة الذاتية موضوع تأمله، يحكم فيها عقله، وتنفذ فيها ببصيرته، ويعرضها على تفكيره، ليقبل منها ما يرضاه عقله، ويرفض منها ما لا يرضاه. ولذلك جعل "ابن طباطبا" جماع الأدوات التي يحتاج إليها الشاعر كمال العقل الذي به تتميز الأضداد، وعليه أن يحضر لبه عند كل مخاطبة ووصف، ويعد لكل معنى ما يليق به، ولكل طقة ما يشاكلها.
(ح) وجعل "ابن طباطبا" مقياس قول الشعر ورفضه أن يورد على الفهم الثاقب، فما قلبه واصطفاه فهو واف، وما مجه ونفاه فهو ناقص.
ويعلل "ابن طباطبا" لقبول الفهم الناقد للشعر الحسن، ونفيه للقبيح منه، واهتزازه لما يقبله، وتكرهه لما ينفيه، بأن كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل ما يتصل بها مما طبعت له إذا كان وروده عليها ورودا لطيفا اعتدال لا جور فيه، فالعين تألف المرأى الحسن، وتقذى المرأى القبيح الكريه، والأنف يقل المشم الطيب، ويتأذى النتن الخبيث، والفم يلتذ بالمذاق الحلو، ويمج البشع المر، والأذن تتشوف للصوت الخفيض الساكن، وتتأذى الجهير الهائل، واليد تنعم بالملمس اللين الناعم، وتتأذى الخشن المؤذي، وكذلك الفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق ويتوف إليه، ويستوحش من الكلام الجائر، والخطأ الباطل، والمحال المجهول المنكر.
وعلة كل حسن مقول الاعتدال، كما أن علة كل قبيح منفى الاضطراب.
ويذكر لقبول النفس للشعر علة أخرى، تلك هي أنها تجد الشعر مترجما عما تحس به، فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له، وحدثت لها أريحية وطرب.
ولا ينسى ما للوزن من أثر في النفس، فللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه.
فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر ثم قبوله له، وإن نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها، وهي اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه.
ومثال ذلك الغناء المطرب الذي يتضاعف له طرب مستمعه المتفهم لمعناه ولفظه، مع طيب ألحانه، فأما المقتصر منه على طيب اللحن منه دون ما سواه فناقص الطرب. ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى، وهي موافقته للحال التي يعد معناه لها، كالتحريض على القتال عند طلب المغالبة، وكالغزال والنسيب عند شكوى العاشق، واهتياج شوقه، وحنينه إلى من يهواه.
ويسجل "ابن طباطبا" أثر الشعر في النفس، فيرى أنه يمازج الروح، ويكون أنفذ من نفث السحر، وأخفى دبيبا من الرقى، وأد أطرابا من الغناء.
(ط) وله مقياس يقيس به الشعر المحكم المتقن، هو أن ينثر، فالأشعار الأنيقة الألفاظ، الحكيمة المعاني، العجيبة التأليف، هي التي إذا نقضت وجعلت نثرا، لم تبطل جودة معانيها، ولم تفقد جزالة تأليفها، أما الأشعار المموهة فهي التي لا يصلح نقضها لبناء يستأنف منه.
(ي) وهو كثيرا ما يعقد الموازنة بين الشعر والنثر، فللشعر فصول كفصول الرسائل، ل يرى الشعر رسائل معقودة، والرسائل شعرا محلولا.
ويرى الشعر المتقن هو الذي يخرج خروج النثر في سهولة، وعدم استكراه قوافيه. أو التكلف في معانيه.
ويورد من الأمثلة ما يبين به ما بين الشعر والنثر من أخذ وعطاء.
وكل ذلك مع اعترافه ما لموسيقى الشعر من أثر عميق في النفوس.
(ك) والشعر عند "ابن طباطبا" أنواع:
فمنه عر محكم النسج، متمكن القوافي، كقول أبي ذؤيب:
أمن المنون وريها تتوجع | والدهر ليس بمعتب من يجزع |
وإذا المنية أنت أظفارها | ألفيت كل تميمة لا تنفع |
والنفس راغبة إذا رغبتها | وإذا ترد إلى قليل تقنع |
ومنه شعر حسن الألفاظ المستعذبة الرائقة سماعا، الواهية معنى، كقول جرير:
إن الدين غدوا بلبك غادروا | ولا بعينك لا يزال معينا |
غيضن من عراتهن، وقلن لي: | ماذا لقيت من الهوى ولقينا |
(ل) "وابن طباطبا" لا يكتفي بما يرد على الخاطر من أول الأمر، ولكنه يدعو إلى أن يعاود الشاعر شعره التهذيب والتثقيف والنقد، وقد سق أن رأيناه عندما كان يتحدث عن الإنتاج الأدبي يدعو الشاعر إلى أن يتأمل ما قد أداه إله طبعه. فيستقصي انتقاده، ويرم ما وهى منه.
وفي موضع آخر يدعوه إلى إلا يظهر للناس شعره إلا بعد إصلاحه، وثقته من جودته.
ويرى الشاعر قديرا على التثقيف والتهذيب، حتى يسلس له القول، ويطرد له المعنى.
(م)ويدعو الشعراء إلى الابتكار، ويكره أن يعيش الشاعر كلا على الشعراء، يغير على معانيهم، فيودعها شعره، ويخرجها في أوزان مخالفة لأوزان الأشعار التي يتناول منها ما يتناول، ويتوهم أن تغييره للألفاظ والأوزان مما يستر سرقته، أو يوجب له فضيلة.
على أنه مع ذلك لا يحرم على الشاعر أن يأخذ معنى سبق على شريطة أن يبرزه في أحسن من الكسوة التي كان عليها، وحينئذ لا يعاب، بل يكون له فضله وإحسانه، فلا د من عمل يبذله الشاعر، وجهد يؤديه، وإلا صار شعره كالشيء المعاد المملول.
وهو، مع دعوته إلى الابتكار نبه إلى ضرورة أن تكون عين الشاعر يقظة متنبهة لما يجد في الزمن من أمور تخالف الأعصر السابقة، ليكون في الشعر غرائب مستحسنة، وعجائب بديعة مستطرفة من فات وحكايات ومخاطبات في كل فن توجيه الحال التي ينشأ قول الشعر من أجلها.
(ن) وعني "ابن طباطبا" عناية خاصة مطلع القصيدة، وحسن التخلص فيها، ولعل ذلك راجع إلى أن المطلع له أثره في السامع وجذ انتباهه إلى ما يلقيه الشاعر، وللأثر الأول في النفس عمقه وبقاؤه.
وعنايته بحسن التخلص ليبقي للقصيدة انسجامها وترابطها.
فينبغي للشاعر أن يحترز في مفتتح أشعاره مما يتطير به، أو يستجفى من الكلام والمخاطبات، كذكر البكاء، ووصف أقفار الديار، وتشتت الآلاف، ونعي الشباب، وذم الزمان، ولاسيما في القصائد التي تضمن التهاني، وتستعمل هذه المعاني في المراثي، ووصف الخطوب الحادثة، حذرا أن يتطير السامع، وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه.
ويرى أن حسن التخلص، والتلطف في وصل مقدمة القصيدة بالغرض منها، مما أبدعه المحدثون من الشعراء، دون من تقدمهم.
(س) وناقدنا العري هذا يحمل للمتقدمين كل تقدير وإكبار، ويؤمن ما وهبوه من طبع دقيق، فإذا اتفق لك في أشعار العرب التي يحتج بها تشبيه لا تتلقاه بالقبول فابحث عنه، وتفر عن معناه، فإلك لا تعدم أن تجد تحته خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها، وعلمت أنهم أدق طبعا من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته.
ولكنه مع ذلك ينقدهم، كما رأيناه عند تصريحه بأننا نجد عندهم أبياتا لا يلتئم شطراها، كما سبق أن مثلنا.
ولا يتعصب ضد المحدثين من الشعراء، ويراهم قد سلكوا منهاج من تقدمهم ل يراهم قد أبدعوا وأجادوا، ويعرف ذلك خاصة في بحسن التخلص وجمال القوافي. وهو صريح في تقريره أن تقدم الزمن لا يكسب الشعر مزية وفضلا. ويقدر كذلك أن الموالدين أتوا في أشعارهم بعجائب، وإن كانوا قد استفادوها ممن تقدمهم،
ولكنها تسلم لهم إذا دعوها للطيف سحرهم فيها.
غير أن له في القدماء والمحدثين رأيا لا نتفق معه فيه، وربما كان متأثرا في ذلك بابن قتيبة، إذ يرى أن أشعار المحدثين متكلفة غير صادرة عن طبع صحيح كأشعار العرب التي سبيلهم في منظومها سبيلهم في منثور كلامهم الذي لا مشقة عليهم فيه.
فالحكم أن أشعار المحدثين غير صادرة عن طبع صحيح، لا مكان له من الصحة، فكثير من الشعراء المحدثين مطوع يصدر شعره عن قريحة فياضة لا شك فيها.
والحكم أن العرب لم يكونوا يجدون مشقة في إنتاج شعرهم مما لا يقره تاريخ أدهم، فمن شعرائهم من كان يتوفر على إنتاجه وقتا طويلا، حتى يخرج إنتاجه مهذبا مصفى.
ويعترف:ابن "ابن طباطبا" بأن صناعة الشعر أشق على شعراء زمانه منها على من كان قلبهم، يعلل ذلك بأن القدماء قد سبقوا إلى كل معنى بديع، ولفظ فصيح، وكان من نتيجة ذلك أن المحدثين إذا أتوا بما يقصر عن معاني السابقين، لم يتلق شعرهم بالقبول. ولعل السر في هذه المشقة أن المحدثين لم يفتحوا من أبواب الشعر غير تلك الأبواب التي كانت للسابقين، ولو أنهم طرقوا أبوابا أخرى لوجدوا مجال القول واسع الميدان.
عليه السلام ومنهجه في تربية الذوق والتدريب على الإنتاج الأدبي الجيد هو الاتصال بالنصوص الأدبي، لتأملها وتقويم اللسان بها. لا ليعيش كلا عليها، ومن أجل ذلك ألف كتابه:"تهذيب الطبع". وأكثر من الشواهد في "عيار الشعر"، فعلى الشاعر، كما قال: "أن يديم النظر في الأشعار التي قد اخترناها، لتلتصق معانيها بفهمه، وترسخ أصولها في قلبه، ويذهب في ذلك إلى ما يحكى عن خالد بن عبد الله القسري قال: "حفظني أبي ألف خطبة، ثم قال لي: تناسها، فتناسيتها، فلم أرد بعد ذلك شيئا من الكلام إلا سهل علي، فكان حفظه لتلك الخطب رياضة لفهمه، وتهذيبا لطبعه، وتلقيحا لذهنه، ومادة لفصاحته، وسببا لبلاغته، ولسنه وخطابته. ولا يزال لهذا الرأي وجاهته في تربية الذوق، وتثقيف الشاعر، وتقويم طبعه. وشهد العصر الذي عاش فيه "ابن طباطبا" بعض الكتب التي ألفت في النقد الأدبي، وورث بعضها منها:
(أ) فمن ذلك كتاب "الشعر والشعراء" لابن قتيبة، ويظهر أنه قرأ هذا الكتاب، وتأثر ببعض آرائه، رغبة منه في تقسيم الشعر، فإننا نجد بين التقسيميين كثيرا من التشابه.
(ب) ومن كتب ذلك العصر كتاب "قواعد الشعر" لثعلب، ولا نكاد نجد صلة تربط بين الكتابين، لا من حيث المادة، ولا من حيث الاتجاه، ولا من حيث المعالجة لما اتفقا فيه من بعض الموضوعات.
(ج) أما صلته بابن المعتز فيقول عنها ياقوت: ذكر أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهاني قال: سمعت جماعة من رواة الأشعار ببغداد يتحدثون عن عبد الله بن المعتز أنه كان لهجا بذكر أبي الحسن "(ابن طباطبا)، مقدما له على سائر أهله، ويقول: "ليس في ولد الحسين من يشبهه". وكان يعرف شعر "ابن طباطبا". وكان "ابن طباطبا" أيضا طول أيامه مشتاقا إلى "عبد الله بن المعتز" متمنيا أن يلقاه، أو يرة شعره، فأما لقاؤه فلم يتفق له، لأنه لم يفارق "أصبهان" قط، وأما ظفره بشعره، فإنه اتفق له في آخر أيامه. ومن الجائز أن يكون "ابن طباطبا" قد عرف بعض شعر "عبد الله بن المعتز" وعرف كتابه في "البديع" وربما كان لذلك أثره في إكثار "ابن طباطبا" من الشعر في الطبيعة، وفي تأليف كتبه، فهو أمير علوي، ليس بغريب أن يتشبه بأمير عباسي. غير أن هناك فرقا كبيرا في اتجاه كتابي الرجلين، فإذا كان اتجاه "ابن طباطبا" اتجاها علميا لبيان نظم الشعر، وما ينبغي أن يتحقق فيه ليكون جيدا، ودراسة أسباب تأثير الشعر في النفس، فإن كتاب البديع لابن المعتز يحدد صاحبه هدفه بقوله: "قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون "البديع"، ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس، ومن تقبلهم وسلك سبيلهم، لم يسبقوا إلى هذا الفن، ولكنه كثر في أشعارهم، فعرف في زمانهم، حتى سمي بهذا الاسم. . ".
(د) وتحدث "المبرد" في كتابه: "الكامل" عن التشبيه، قبل "ابن طباطبا" ولكن لم يبد أثر واضح لهذا الفصل في كتاب "عيار الشعر".
(ه) ونجد أيضا كتاب نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، وقد تعرض الناقدان لأمور اشتركا في الحديث عنها: فمن ذلك حديثهما عن العروض، وأن وزن الشعر يعود إلى طبع في الشاعر، لا إلى تعلم ذلك العلم، ولا يحتاج أحدهما في ذلك أن يأخذ عن صاحبه.
أثر ابن طباطبا فيمن جاء بعده
وظهرت آراء "ابن طباطبا" وبدا أثره فيمن جاء بعده من النقاد
(أ) فرأينا "المرزباني" في كتابة الموشح يروي آراءه في الشعر، وقد ينقل عنه عدة صفحات متوالية.
(ب) وأما صلته بأبي هلال العسكري صاحب الصناعتين، فقد رأيناه بعض شعره، كقوله:
فيا لائمي، دعني أغالي بقيمتي | فقيمة كل الناس ما يحسنونه |
(ج)ونجد المرزوقي في مقدمته لشرح الحماسة ينقل بعض آرائه. موافقا لها، كنقله رأيه في أن الشعر هو ما أن غري من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة، وما خالف هذا فليس بشعر.
(د)ويشارك:ابن خلدون" "ابن طباطبا" رأيه في تربية الذوق الأدبي إذ يرى وسيلة ذلك مخالطة كلام العرب، فيها تحصل الملكة لتذوق الكلام، ويستعان على نظمه.
(ه) ووجدنا صدى لآرائه في طريقة نظم الشعر، وضرورة تثقيفه وتنقيحه عند ابن الأصبع المصري، فرأيناه يوصي الراغب في نظم القريض أن يحصل المعنى قبل اللفظ، وأن يعمل الأبيات مفرقة بحسب ما يجود بها الخاطر. ثم ينظمها بعدئذ.
(و) ويظهر أن آراء "ابن طباطبا" كان لها صدى في أوساط النقد الأدبي وكان كثير من العلماء يحتجون بها، وكان بعض النقاد يعارض النقاد يعارض بعضها ويخطئه. وقد رأينا صدى ذلك في كتاب ألفه الآمدي في "إصلاح ما في عيار الشعر، ابن طباطبا"، كما حدثنا بذلك "ابن النديم" في كتابه: الفهرست:
ولسنا ندري مآخذ الآمدي على الناقد العلوي، لأن الكتاب لم يرد إلينا. ولسنا ندعي أن آراء "ابن طباطبا" في النقد الأدبي وإنتاج الشعر صحيحة كلها، ولكننا إنها آراء جديرة بأنعام النظر والعناية.
وبعد فهذه دراسة لناقد عربي مضى عليه أكثر من ألف عام، ولا تزال لآرائه جدتها وحيويتها، لها مكانتها في مجاله المناقشة والموازنة بين ما اهتدى إليه الباء منذ القدم، وما وصلنا إليه في العصر الحديث.
أشعاره
قد سمعت قول ابن خلكان أنه له ديوان شعر وقد رآه، وفي معجم الأدباء عن حمزة بن الحسن الأصبهاني أنه قال ذكر عنه حكايات منها ما حدثني به أبو عبد الله بن أبي عامر قال من توسع أبي الحسن في أتي القول وقهره لأبيه أن أبا عبد الله فتى أبي الحسين محمد بن أحمد بن يحيى بن أبي البغل كانت به لكنة شديدة حتى كان لا يجري على لسانه حرفان من حروف المعجم الراء والكاف فيقلب الراء غينا والكاف همزة أراد يقول(كركي) يقول (ا غ إ ي) وإذا أراد أن يقول (كركرة) يقول (اغ ا غة) وينشد للأعشى (قالت) (اغي غجلا في افة اتف) يريد (قالت أرى رجلا في كفه كتف) فعمل أبو الحسن قصيدة في مدح أبي الحسين حذف منها حرفي لكنة الحسين ولقنه حتى رواها لأبيه أبي الحسن وقال أبو الحسن والله أنا أقدر على أبي الكلام من واصل بن عطاء والقصيدة:
يا سيدا دانت له السادات | وتتابعت في فعله الحسنات |
وتواصلت نعماؤه عندي فلي | منه هبات خلقهن هبات |
نعم ثنت عني الزمان وخطبه | من بعدما هيبت له غدوات |
فأدلت من زمن منيت بغشمه | أيام للأيام بي سطوات |
فلميت آمالي لديه حياته | ولحاسدي نعمي يديه ممات |
أوليتني مننا تجل وتعتلي | عن أن يحيط بوصفهن صفات |
عجنا عن المدح التي استحققتها | والله يعلم ما تعي النيات |
يا ماجدا فعل المحامد دينه | وسماحه صوم له وصلاة |
فيبيت يشفع راجيا بتطوع | منه وقد غشي العيون سبات |
فالجود مثل قيامه وسجوده | إن قيس والتسبيح منه عدات |
ما زال يلفي جائدا أو واعدا | وعدا تضايق دونه الأوقات |
ليمينه بالنجح عند عفاته | في ليل ظنهم البهيم ثبات |
ذو همة علوية توفي على الجـ | ـوزاء تسقط دونها الهمات |
تنأى عن الأوهام إلا أنها | تدنو إذا نيطت بها الحاجات |
وعزيمة مثل الحسام مصونة | عن أن يفل به الزمان شباة |
فإذا دها خطب مهم أيد | خلي العداة وجمعهم أشتات |
لأبي الحسين سماحة لو أنها | للغيث لم تجدب عليه فلاة |
وله مساع في العلا عدد الحصى | في طي من جلها مسعاة |
كحيا السحاب على البقاع سماحة | وله على عافي نداه سمات |
يحيى بنائله نفوسا مثلما | يحيا بجود الهاطلات نبات |
شاد العلاء أبو الحسين وحازه | عن سادة هم شائدون بنات |
سباق غايات تقطع دونها | سباقها إن مدت الحلبات |
فإذا سعوا نحو العلا وسعى لها | متمهلا حيرت له القصبات |
مستوفز عند السماح وإن تقس | أحدا به في الحلم قلت حصاة |
طود يلوذ به الزمان وعنده | لجميع أحداث الزمان أداة |
بيمينه فلم إذا ما هزه | في أوجه الأيام قلت قناة |
في سنة بأس السنان وهيبة السـ | ـيف الحسام وقد حوته دواة |
سحبان عيا وهو عيا بأقل | عجل إلى النجوى وفيه أناة |
وسنان إلا أنه متنبه | يقظان منه الزهو والأجنات |
لم يخط في ظلمات ليل مداده | إلا انجلت عنا به الظلمات |
وأبو علي أحمد بن محمد | قد نمقت عني لديه هنات |
فتقاعست دوني عوائد فضله | وسعت سعاة بيننا وعداة |
فاقتله عن طول العقوق وهزه | فله لدى فعل العلا هزات |
والله ما شأني المديح وبذله | لمؤمل ليمينه نفحات |
إلا مجازاة لمن أضحت له | عندي يد أغذى بها واقات |
والمسمعي له لدي صنائع | أيامهن لطيبها ساعات |
فأخالها عهد الشباب وحسنه | إذ طار لي في ظله اللذات |
خذها الغداة أبا الحسين قصيدة | ضيمت بها الرآت والكافات |
غيبن عنها ختلة أخواتها | عند النشيد فمالها أخوات |
ولو أنهن شهدن لازدوجت لها الـ | ـغينات في الأنشاد والألفات |
فأسعد أبا عبد الإله بها إذا | شقيت بلثغة منشد أبيات |
نقصت فتمت في السماح وألغيت | منها التي هي بينها آفات |
صفيتها مثل المدام له فما | فيها لدى حسن السماع قذاة |
معشوقة نسبي العقول بحسنها | ياقوتة في اللين وهي صفاة |
علوية حسنية مزهوة | تزهى بحسن نشيدها اللهوات |
ميزانها عند الخليل معدل | "متفاعلن متفاعلن فعلات" |
لو واصل بن عطاء الباني له | تليت توهم أنها آيات |
لولا اجتنابي أن يمل سماعها | لأطلتها ما خطت التاءات |
قال ياقوت: وجد في كتاب شعراء أصبهان لحمزة الأصبهاني قال وجدت بخط أبي الحسن الله يعني ابن طباطبا أن أبا علي يحيى بن علي بن المهلب وصف له دعوة لأبي الحسن أحمد بن محمد بن إبراهيم الكراريسي ذكر أنهم قربوا فيها مائدة عليها خيار وفي وسطها جامات عليها فطر بخشت فسميتها مسيحية لأنها آدم النصارى وقربوا بعد ذلك سكباجة بعظام عارية فسميتها شطرنجية وقربوا بعدها مضيرة في غضائر بيض فسميتها معتدة وكانت بلا دسم والمعتدة لا تمس الدهن والطيب وقدموا بعدها زيرباجة قليلة الزعفران فسميتها قنبية وقربوا بعدها زبيبة سوداء فسميتها موكبية وقبروا بعدها قلية بعظام الأضلاع فسميتها حسكية ثم قربوا بعدها فالوذجة بيضاء فسميتها صابونية، وأنه اعتل على الجماعة بأنه عليل فحولهم من منزله إلى باغ (بستان) قد طبق بالكراث فهيأ المجلس هناك وأحضرهم جرة منثلمة وكانوا يمزجون شرابهم منها فإذا أرادوا الغائط نقلوها معهم فكانت مرة في المجلس ومرة في المخرج وإن الباغيان (البستاني) ربط بحذائهم عجلة كنت تخور عليهم خوارا مناسبا لقول القائل يا فاطمة فقلت في ذلك:
يا دعوة مغبرة قائمه | كأنها من سفر قادمه |
قد قدموا فيها مسيحية | أضحت على إسلامها نادمه |
نعم وشطرنجية لم تزل | أيد وأيد حولها حائمه |
فلم نزل في لعقها ساعة | ثم نفضناها على قائمه |
وبعدها معتدة أختها | عابدة قائمة صائمه |
في حجرها أطراف مؤودة | قد قتلها أمها ظالمه |
والقنبيات فلا تنسها | فحيرتي في وصفها دائمه |
أقنب ما امتد في أصبعي | أم حية في وسطها نائمه |
والموكبيات بسلطانها | قد تركت آنافنا راغمه |
والحسكيات فلا تنس في | خندقها أوتادها القائمه |
وجام صابونية بعدها | فامخر بها إذ كانت الخاتمين |
ظل الكراري مستعبرا | من عصبة في داره طاعمه |
وقال إن ابني عليل ولي | قيامة من أجله قائمه |
وولولت داياته حوله | وليس إلا عبرة ساجمه |
قال والقصيدة طويلة باردة نشبت في كتابتها فكتبت منها هذا وله:
لا تنكرن إهداءنا لك منطقا | منك استفدنا حسنه ونظامه |
فالله عز وجل يشكر فعل من | يتلو عليه وحيه وكلامه |
وقال: وقد صادف على باب ابن رستم عثمانيين أسودين معتمين بعمامتين حمراوين فامتحنهما فوجدهما من الأدب خاليين فدخل إلى مجلس أبي علي وتناول الدواة والكاغد من بين يديه وكتب بديها:
رأيت بباب الدار أسودين | ذوي عمامتين حمراوين |
كجمرتين فوق فحمتين | قد غادرا الرفض قرير العين |
جدكما عثمان ذو النورين | فما له انسل ظلمتين |
يا قبح شين صادر عن زين | حدائد تطبع من لجين |
ما أنتما إلا غرابا بين | طيرا فقد وقعتما للحين |
وخليا الشيعة للسبطين | الحسن المرضي والحسين |
لا تبرما إبرام رب الدين | ستعطيان في مدى عامين |
وقال لأبي عمر بن عصام وكان ينتف لحيته:
يا من يزيل خلقة الر | حمن عما خلقت |
تب وخف الله على | ما قد جنت واجترحت |
هل لك عذر عنده | إذا الوحوش حشرت |
في لحية إن سئلت | بأي ذنب قتلت |
وله:
ما أنسى لا أنسى حتى الحشر مائدة | ظلنا لديك بها في أشغل الشغل |
إذ أقبل الجدي مكشوفا ترائبه | كأنه متمط دائم الكسل |
قد مد كلتا يديه لي فذكرني | بيتا تمثلته من أحسن المثل |
(كأنه عاشق قد مد بسطته | يوم الفراق إلى توديع مرتحل) |
وقد تردى بأطمار الرقاق لنا | مثل الفقير إذا ما راح في سمل |
وله:
لنا صديق نفسنا | في مقته منهمكة |
أبرد من سكونه | وسط الندي الحركة |
وجدري وجهه | يحكيه جلد السمكة |
أو جلد أفعى سلخت | أو قطعة من شبكة |
أو حلق الدرع إذا | أبصرتها مشتبكة |
أو سفن محبب | أو كرش منفركة |
أو منخل أو عرض | رقيقة منهتكة |
أو حجر الحمام كم | من وسخ قد دلكه |
أو كور رنبور إذا | أفرخ فيه تركة |
أو سلحة يابسة | قد نقرتها الديكة |
وله:
لا وانسي وفرحتي بكتاب | أتي منه في عيد أضحى وفطر |
ما دجا ليل وحشتي قد إلا | كنت لي فيه طالعا مثل بدر |
بحديث يقيم للأنس سوقا | وابتسام يكف لوعة صدري |
وله يصف القلم:
وله حسام باتر في كفه | يمضي لنقض الأمر وتوكيده |
ومترجم عما يجن ضميره | يجري بحكمته لدى تسويده |
فلم يدور بكفه فكأنه | فلك يدور بنحسه وسعوده |
وله:
بانوا وأبقوا في حشاي لبيتهم | وجدا إذا ظعن الخليط أقاما |
لله أيام السرور كأنما | كانت لسرعة مرها أحلاما |
لو دام عيش رحمة لأخي هوى | لأقام لي ذاك السرور وداما |
يا عيسنا المفقود خذ من عمرنا | عاما ورد من الصبا أياما |
وله من الأبيات المشهورة:
يا من حكى الماء فرط رقته | وقلبه في قساوة الحجر |
يا ليت حظي كحظ ثوبك من جسـ | ـمك يا واحدا من البشر |
لا تعجبوا من بلى غلالته | قد زر أزراره على القمر |
والبيت الأخير من الثلاثة المتقدمة الذي استشهد به المصنف على أن إطلاق اسم المشبه على المشبه به بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه فيكون استعمال الاستعارة في المشبه استعمالا فيما وضعت له.
وله في القلم:
وإذا انتضى قلما لخطـ | ـب خلت في يمناه نصلا |
يردي به من زاغ عن | سبيل الهدى كيدا وختلا |
كم رد عادية الخطو | ي وكم أعز وكم أذلا |
يجري فيؤمن خائفا | ويصيب في الأعداء تبلا |
وله في رد الجواب على ظهر الكتاب:
قد فهمت الكتاب طرا وما زا | ل نجيي ومؤنسي وسميري |
وتفألت بالظهور على الوا | شي فصارت إجابتي في الظهور |
وتبركت باجتماع الكلاميـ | ـن رجاء اجتماعنا في سرور |
وله يهجو أبرص ويرميه بالدعوة:
أنت أعطيت من دلائل رسل اللـ | ـه آيا بها علوت الرؤسا |
جئت فردا بلا أب وبيمنا | ك بياض فأنت عيسى وموسى |
وله:
يا من يخاف أن يكو | ن ما يكون سرمدا |
أما سمعت قولهم | أن مع اليوم غدا |
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 9- ص: 72