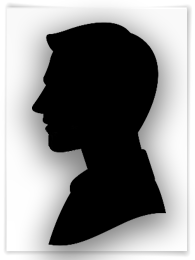ابن النحوي
ابن النحوي يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل، التلمساني، أبو الفضل، المعروف بابن النحوي: ناظم (المنفرجة) التي مطلعها:
#اشتدي أزمة تنفرجي)
كان فقيها يميل إلى الأجتهاد، من أهل تلمسان. اصله من توزر. سكن سجلماسة، وتوفى بقلعة بني حماد (من أعمال فسنطينة) قرب بجاية. وله تصانيف. قلت: والمنفرجة شرحها كثيرون، وخمسها بعضهم، وفي نسبتها إلى صاحب الترجمة خلاف.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 8- ص: 247
ابن النحوي يوسف بن محمد بن يوسف التوزري المعروف بابن النحوي، أبو الفضل، الفقيه الصوفي، ولد بتوزر، وأقام في قلعة بني حماد في الجزائر، ولم يكد يجاوز طور المراهقة حتى تدفقت على البلاد سيول أعراب بني هلال وسليم ناشرة وراءها الخراب والدمار، ولاقت منهم مدينة القيروان عاصمة الدولة الزيرية الصنهاجية ما لم تلاقه مدينة أخرى من الويلات والنكبات حتى اضطر علماؤها وأدباؤها إلى الهجرة خارج القطر التونسي أو الاستقرار ببعض مدن الساحل التونسي، ولم يبق بها إلا عبد الخالق السيوري المتوفى في 460/ 1068 من تلامذة أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، وانفرد في عصره برواية المدونة والإمامة في الفقه، ومن أشهر تلامذته عبد الحميد الصائغ الذي انتقل إلى سوسة وتوفي بها سنة 486/ 1093، وأبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي الذي انتقل إلى صفاقس حيث توفي بها سنة 478/ 1086، وكان يقصده الطلاب من أطراف البلاد ليأخذوا عنه تعليقه على المدونة المسمى بالتبصرة، ويرووا عنه صحيح البخاري، ومن أشهر تلامذته الإمام المازري دفين المنستير، والمترجم له.
وكانت توزر في عصر المترجم بها أعلام أمثال عبد الله بن محمد الشقراطسي الذي كان إماما في الحديث والعربية والفقه، أديبا شاعرا، وهو من شيوخ المترجم، ثم ارتحل المترجم إلى صفاقس للأخذ عن شيخ فقهاء وقته الشيخ أبي الحسن اللخمي فقرأ عليه كتاب «التبصرة» وروى عنه صحيح البخاري، ولما لقي اللخمي سأله ما جاء بك؟ فقال جئت لأنسخ تأليفك التبصرة، فقال له إنما تريد أن تحملني في كفك إلى المغرب أو كلاما هذا معناه مشيرا إلى أن علمه كله في هذا الكتاب.
وأخذ عن الإمام المازري فقرأ عليه أصول الفقه، وعلم الكلام، وكان المازري إماما مبرزا فيهما. في هذا الجو العلمي تنفس المترجم، وتأثر به، فكان مثل شيخه اللخمي مائلا إلى الاجتهاد في الفقه، متمكنا من الأصلين أصول الدين (علم الكلام) وأصول الفقه مثل شيخنا الإمام المازري، شاعرا أديبا لغويا مثل شيخه الشقراطسي وإذا كانت تونس قبيل ذلك العصر نبتت فيها طلائع متأثرة بتعاليم شيخ أهل السنة أبي الحسن الأشعري في علم الكلام مع العناية بأصول الفقه، وميل بعض فقهائها إلى الاجتهاد المذهبي، فإن الطابع الغالب لدى فقهاء المغربين الأوسط والأقصى في عهد المرابطين هو النفور من علم الكلام، وأصول الفقه، ولقد لقي المترجم المتاعب والمقاومة من الفقهاء والرؤساء زمن استقراره بالمغرب الأقصى عند ما أقرأ علم الكلام، وعلم أصول الفقه.
وبعد أن استكمل المترجم رحلته العلمية رجع إلى بلده توزر ثم بارحها في ظروف غامضة لظلم الوالي له، ولبث متجولا بين مدن الجزائر والمغرب الأقصى مدرسا للنحو، والفقه، والأصول، وعلم الكلام، سالكا طريق الزهد والتقشف، ففي الجزائر أخذ عنه النحو عبد الملك بن سليمان التاهرتي، وفي فاس أقرأ «اللمع» في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، ودرس علم الكلام وذلك سنة 490/ 1097.
دخل ابن دبوس قاضي فاس الجامع والمترجم يدرس علم الكلام، فأمر بإبطال الدرس، ولما انتقل إلى سجلماسة جنوبي المغرب الأقصى استمر في تدريس الأصلين، فأمر ابن بسام أحد رؤساء البلد بطرده من المسجد قائلا: «هذا يريد أن يدخل علينا علوما لا نعرفها».
وقد تأثر المترجم بهذه المضايقة والمعاملة السيئة من أجل نشره لعلمين غير معروفين في المغرب ودعا على مضطهديه ولعله في هذه الفترة قال بيتيه المشهورين:
أصبحت في من له دين بلا أدب | ومن له أدب خال من الدين |
أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا | كبيت حسان في ديوان سحنون |
وهان على سراة بني لؤي | حريق بالبويرة مستطير |
ولعل هذه المضايقات المستمرة دعت المترجم إلى الخروج من المغرب الأقصى والاستقرار بالقطر الجزائري منتقلا بين مدنه كبجاية وقلعة بني حماد، ولم يسلم من إيذاء الفقهاء الرسميين بهذا القطر، وظهر تأثير التربية الصوفية لدى المترجم في صبره على تحمل صنوف الأذى من أجل أفكاره ومبادثه، وعزوفه عن تقلد المناصب، وقبول الهدايا، مقتصرا في معاشه على ما يرد إليه من بلده توزر مع ميله إلى الإنصاف من نفسه بالرجوع إلى الحق دون أن يرى في ذلك غضاضة عليه، والعفو عن البوادر الصادرة عن البعض بدون سوء نية وقصد.
ولما كانت تعاليم المترجم الأصولية والكلامية لم تصادف نجاحا يذكر بالمغربين الأوسط والأقصى لم تتخرج عليه إلا طائفة محصورة العدد من الفقهاء والصوفية وعلى رأس هؤلاء الأخيرين علي بن حرزهم المتوفى سنة 559/ 1164 الذي قال عنه الساحلي الأندلسي في «بغية السالك» (خط) «أنه أحكم كتاب الإحياء وضبط مسائله وكان يستحسنه ويثني عليه»، ومن تلامذته الفقهاء عبد الرحمن بن محمد الكتامي المعروف بابن العجوز السبتي. والمترجم قام بدور الرائد المصلح الذي هيأ الأذهان، وأيقظ العقول لتلقي تعاليم الغزالي التي أصبحت بعد وفاة المترجم بزمن غير طويل من دعائم مذهب دولة الموحدين التي قضت على دولة المرابطين وحلت محلها.
أدبه:
إن عاطفة التدين ألهمت المترجم نظم الشعر الجيد الرقيق مثلما ألهمت شيخه الشقراطسي من قبل نظم لاميته في مدح الرسول - عليه السلام - وذكر معجزاته، ومن أطول وأجود شعر المترجم القصيدة المنفرجة التي نظمها على إثر ضائقة لحقته، والتي صحح نسبتها إليه كثير من أهل العلم ومطلعها:
اشتدي أزمة تنفرجي | قد آذن ليلك بالبلج |
الشدة أودت بالمهج | يا رب فعجل بالفرج |
فهاجت لدعاك خواطرنا | والويل لها إن لم تهج |
واغلق باب الضيق وشدته | وافتح ما سد من الفرج |
عجنا لحماك نقصده | والأنفس في أوج الوهج |
يا من يشكو ألم الحرج | ويرى عسره قرب الفرج |
أبشر بشذى أوج الفرج | اشتدي أزمة تنفرجي |
ويوجد ضمن مجموعة قصائد بالمتحف البريطاني رقم 1393، وخمسها عبد الله بن نعيم الحضرمي القرطبي التونسي المولد المتوفى بقسنطينة سنة 636/ 1239 وطالعه:
لا بد لضيق من فرج | والصبر مطية كل شجي |
وبدعوة أحمد فالتهجي | اشتدي أزمة تنفرجي |
وتخميسه أورده كاملا الغبريني في «عنوان الدراية ».
ومن شعر ابن النحوي ذي النزعة الصوفية:
عطاء ذي العرش خير من عطائكم | وسيبه واسع يرجى وينتظر |
أنتم يكدر ما تعطون منكم | والله يعطي ولا من ولا كدر |
لا حكم إلا لمن تمضي مشيئته | وفي يديه على ما شاءه القدر |
يا فاس منك جميع الحسن مسترق | وساكنوك ليهنهم ما رزقوا |
هذا نسيمك أم روح لراحتنا | وماؤك السلسل الصافي أم الورق |
أرض تخللها الأنهار داخلها | حتى المجالس والأسواق والطرق |
المصادر والمراجع:
- الاستقصاء لدول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري السلاوط (الدار البيضاء 1954) 1/ 153، 2/ 67 - 68، الأعلام 9/ 325 - 326، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ص 390، البستان 299 - 304، بغية الوعاة 2/ 362، تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 3/ 93، التشوف إلى رجال التصوف تحقيق أحمد التوفيق (الرباط 1405/ 1984) ص 95 - 101، توشيح الديباج لبدر الدين القرافي 265، الجديد في أدب الجريد 55 - 61، جذوة الاقتباس 346 - 347، الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي 299 - 301، الخريدة قسم شعراء المغرب (تونس 1966) 1/ 110، سيرة القيروان لمحمد العروسي المطوي 67 - 68، شجرة النور الزكية 126، العلاقات بين تونس وإيران لعثمان الكعاك 199 - 200، عنوان الأريب
1/ 50 - 52، كشف الظنون 2/ 1946 - 47، مجمل تاريخ الأدب التونسي 172 - 175، معجم المؤلفين 13/ 334، المقتضب من تحفة القادم 908، نيل الابتهاج 349 - 351، هدية العارفين 2/ 551، الوفيات لابن قنفذ 40، ومن الملاحظ أن ابن قنفذ نسبه بسكريا لكن في مصادر ترجمته النص على أنه توزري، ومن الحكايات المثبتة لهذا أنه لما كان بقلعة بني حماد مر بالفقيه أبي عبد الله بن عصمة فلم يسلم عليه لشغل باله فلما رجع ناداه محتقرا يا يوسف، فجاءه فقال له يا توزري اصفرت وجهك ورققت ساقيك وصرت تمر ولا تسلم فاعتذر فلم يقبل وأغلظ له في القول فقال له غفر الله لك يا فقيه، يا أبا محمد وانصرف، توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ص 285، بلاد البربر الشرقية على عهد الزيريين (بالفرنسية) 2/ 732 - 798، الحياة الأدبية بإفريقية في عصر الزيريين (بالفرنسية) 197 - 199، بلاد البربر الإسلامية لجورج مارسي (الجزائر 1946) 190 - 201.
دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان-ط 2( 1994) , ج: 5- ص: 19