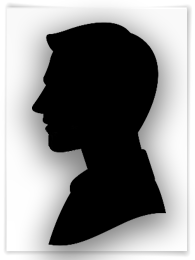الكندي
الكندي يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي، أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصره، وأحد أبناء الملوك من كندة. نشأ في البصرة. وانتقل إلى بغداد، فتعلم، واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. وألف وترجم وشرح كتبا كثيرة، يزيد عددها على ثلاثمائة. ولقي في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم. ولقي في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم، فوشي به إلى المتوكل العباسي، فضرب وأخذت كتبه، ثم ردت إليه. وأصحاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراما. قال ابن جلجل: (ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في تواليفه حذو أرسطاطاليس) من كتبه (رسالة في التنجيم-ط) و (اختيارات الأيام-خ) و (تحاويل السنين-خ) و (إلهيات أرسطو-خ) و (رسالة في الموسيقى-خ) و (الأدوية المركبة) ترجمت إلى اللاتينية وطبعت بها، و (رسم المعمور) خرائط وصور عن الأرض، ذكره المسعودي، و (الترفق، في العطر-خ) في العطور، و (السيوف وأجناسها-ط) رسالة، و (القول في النفس-ط) رسالة نشرت في مجلة الكتاب، و (المد والجزر-خ) و (ذات الشعبتين-خ) وهي آلة فلكية، و (خمس رسائل، أولاها في ماهية العقل-ط) ترجمت إلى اللاتينية، و (الشعاعات-خ) و (الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد-ط) نشر باسم (كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى). ونشر الدكتور أبو ريدة (رسائل الكندي-ط) في جزأين، اشتملا على بعض رسائله. وللشيخ مصطفى عبد الرزاق: كتاب (فيلسوف العرب والمعلم الثاني-ط) صغير، في سيرته وسيرة الفارابي.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 8- ص: 195
يعقوب بن إسحاق الكندي قال الشيخ عبد الكريم الزنجاني:
نسبه
هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي، ينتهي نسبه إلى ’’يعرب بن قحطان’’ ولد في ’’واسط’’ وعاش في القرن الثالث الهجري، أي في القرن التاسع الميلادي، وقيل أن (الكندي) ولد في البصرة، وقد يقال أنه ولد في (الكوفة) حيث كان أبوه واليا على الكوفة زهاء عشرين عاما، وسنة ولادته غير معلومة، مثل سنة وفاته.
درج الكندي بين أحضان أسرة ماجدة كان لها السيادة والإمارة منذ زمن بعيد. فأبوه إسحاق بن الصباح كان أميرا على الكوفة في عهدي ’’المهدي’’ و’’الرشيد’’ وجده ’’أشعث بن قيس’’ كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام. وكان في الجاهلية ملكا على ’’كندة’’ كلها ورث المملكة من آبائه وأجداده.
دراسته
بدأ ’’الكندي’’ حياته العلمية في البصرة ثم ارتحل إلى ’’بغداد’’ عاصمة العلم والثقافة العالمية إذ ذاك ففيها تهذب وتأدب ومن معارفها انتهل حتى أصبح رأسه دائرة معارف كبرى حوت من الفلسفة والأدب والطب والفلك وفن الألحان والعلوم الرياضية والطبيعيات والكيميائيات ما تعجز عن احتوائه عشرات الرؤوس.
ولقد دفعه تطلعه إلى أن يستقيها من مناهلها إلى أن تعلم اللغتين، ’’اليونانية’’ و’’السريانية’’ وكان ينقل منها إلى العربية، حتى أصبح من ’’حذاق الترجمة في الإسلام ’’ وهم، (حنين بن إسحاق، ويعقوب بن إسحاق الكندي وثابت بن قرة الحراني، وعمر بن الفرخان الطبري’’.
وكان ’’الكندي’’ معجبا بالفلسفة اليونانية والحكمة الهندية والمعارف الفارسية إعجابا شديدا حتى أنه عكف على كل هذه المنتجات القيمة يلتهمها في نهم لم يعرف العرب له نظيرا من قبل. ولهذا كان هو أول من دعي بالفيلسوف العربي.
مؤلفاته
أوصل بعض المؤرخين مؤلفات ’’الكندي’’ إلى ثلاثمائة وخمسة عشر كتابا ورسالة. والبعض الآخر إلى مائتين وواحد وثلاثين كتابا ورسالة ذكرها ’’ابن النديم’’ في الفهرست وقد سرد الكثير منها ’’ابن أبي أصيبعة في كتابه ’’عيون الأنباء’’ سردا بلا ترتيب ولا نظام وقد قسمت في كتاب ’’تاريخ الحكماء’’ تقسيما أفردت كل فصيلة منها على حدة.
ووضع بعض المؤرخين لهذه الفصائل الأرقام الآتية:
(الفلسفة 22 كتابا) (نجوم 19) (فلك 16) (جدل 17) (أحداث 14) (الكريات 8) (فن الألحان 7) (نفس 5) (تقدمة المعرفة 5) (حساب 11) (هندسة 23) (طب 22) (سياسة 12) (طبيعيات 33) (منطق 9) (أحكام 15) (أبعاد 8). ولكن من المؤسف أن هذه الكتب لم يبق منها إلا النزر اليسير الذي لا يستطيع أن يعطي للمؤرخ صورة واضحة عن فلسفة ’’الكندي’’، وإن قال بعض الثقات من المؤرخين أنها مزيج من فلسفات ’’أفلاطون’’ و’’أرسطو’’ و’’أفلوطين’’ منسوبة كلها إلى أرسطو.
ولكن عندنا سند متصل إلى ’’الكندي’’ عن طريق معاصره ’’الفارابي’’ و’’ابن سينا’’ يعطينا صورة حقيقية واضحة من ’’فلسفة الكندي’’ وسنعطيكم صورة موجزة منها في هذه الكلمة.
أهم أسباب تفلسفه
إن أهم أسباب تفلسف (الكندي) خاصة وتفلسف العرب والمسلمين عامة وهو ’’الإسلام’’ الذي هو دين الفطرة والطبيعة، و(القرآن) الكريم الذي هو أول كتاب سماوي فرض تعلم العلم والفلسفة على أتباعه فرضا، وأوجب عليهم التفكير في أسرار الكون وخفايا الوجود ليصلوا من هذا التفكير إلى معرفة المبدع الأول والإيمان به والتيقن بخلود الروح وبالعودة إلى حياة أخرى تتحقق فيها عدالة الخالق بمجازاة الخير والشرير بما يستحقانه على عمليهما، وهل الفلسفة الحقة شيء غير هذا؟ وهل هناك فرق بين دعوة الفلسفة معتنقيها إلى الفكر والتأمل في نشأة العالم ومصيره وفي عظمة الكون ونظام تسييره، وبين قوله تعالى: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء} وقوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب}، وسائر الآيات القرآنية الصريحة في أن الإسلام حول العقل الفطري السليم من شوائب الأوهام كامل سلطانه ولم يشترط للنظر العقلي وجهة معينة ولم يحد له حدا مخصوصا مقررا، بل ترك العقول السليمة حرة لبلوغ الحقيقة المجردة في العقائد وفي عالم الوجود والتكوين من مبدأ وجود العالم إلى مصيره (أي معرفة المبدأ والمعاد) حسبما تتطلبه غريزة الشعور الديني في الإنسان، وهذا التخويل إن شوهد في الفلسفة والعلم والحكمة وكان من مقوماتها وهو الذي ضمن لها الاحترام العام والخلود ودوام الارتقاء فلم يشاهد في دين من الأديان ما عدى الإسلام، واعتماد الإسلام على العقل هو الذي حفز العرب والمسلمين إلى الجد في تحصيل العلوم والتنقيب عن المعارف، وإلى وضع الفلسفة الإسلامية وكثير من العلوم وإبداعها وإنشائها. والسر في ذلك هو أنه لا شك في أن الحياة العقلية أساس طبيعي تستند إليه أنواع الحياة العامة وفروع الشؤون الحيوية وهي أساس الرقي والنهوض فكان من شأن الإسلام الذي هو دين الطبيعة والفطرة والاجتماع أن يشيدها وأن يجعل طلب العلم فريضة على معتنقيه.
ولا ريب في أن كل من يلقي نظرة فاحصة على القرآن الكريم ويتأمل في آياته الدافعة إلى التدبر والتفكير في شيء عظيم من الجد يتضح له أن هذا الكتاب السماوي الكريم هو أول أسباب تغلغل الفلسفة في البيئات العربية وهو العامل الأول الذي فتح للعرب باب البحوث الفلسفية المؤسسة على المنطق والتأمل فظهر لهم شيء من هذه البحوث التي لم يكن لهم بها عهد قبل نزول القرآن وكانت هذه البحوث تدور حول علوم الكون وعلوم الدين من توحيد وتفسير وتشريع.
ولا شك أن هذا طليعة سافرة من طلائع الفلسفة ظهرت في صدر الإسلام وأخذت تنمو وتتزايد إلى أن بدئ في الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية. وكان العربي المسلم يمتاز بذكاء طبيعي وبقوى عقلية دفينة، وبرغبة في الاطلاع على الجديد فأصبح بعد وقت قصير وريث حضارة الشعوب العريقة في القدم التي تغلب عليها أو احتك بها، وتبع دور الترجمة الطويل بما كان فيه من إنتاج دور الابتكار والابتداع المؤسس على الثقافة الإسلامية.
صورة موجزة من فلسفة الكندي
(تمهيد) وقع بعض الباحثين في الحيرة والارتباك وخيل إليهم أن (الكندي) لم يزد على علوم اليونان وفلسفتهم جديدا، وإنه قد هوى في حضيض الأسلوب الغامض الذي يحول بينه وبين الجدارة بالخلود، وإن النزر اليسير الباقي، من كتبه لا يعطي صورة واضحة عن فلسفته، ولكنا عرفنا (فلسفة الكندي) من كتبه ومؤلفاته، ومن إلهاماته المسجلة شهب مؤلفات معاصره ومستودع أسرار فلسفته وهو ’’الفارابي’’ المعلم الثاني، واقتفى ’’ابن سينا’’ أثر الفارابي في ذلك، وتبعه كثيرون من أبرع المؤلفين في الفلسفة وتاريخها العام من العرب والمسلمين، فلا نشك في أن ’’الكندي’’ عاش في القرن الثالث الهجري، وأتم ترجمة الفلسفة اليونانية والمعارف الفارسية والثقافة الهندية، وفرغ من شرحها والتعليق عليها بما يدل على أنه هضمها ونضج في فهمها، وبرز فيها تبريزا يستوجب الاحترام والإجلال والخلود، فأصبح فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرها، ثم استعان بثقافته الإسلامية والقرآنية على تعديلها وتقويمها وتصحيح أخطائها فأبدع مذهبا مستقلا في الفلسفة ابتناه على أساس استعمال البراهين المنطقية والحجج النظرية التي ينتهي أول قضاياها إلى البديهيات المسلمة فظل مصدر إلهام أسمى الأفكار وأعلى النظريات إلى معاصريه ومن جاء من بعده من فلاسفة العرب والإسلام، ولقب بحق (أول فلاسفة العرب والإسلام) وهو أول فيلسوف عربي وإسلامي حاول التوفيق بين آراء (أفلاطون) و(أرسطو)، واقتفى أثره ’’الفارابي’’ في ذلك ثم ’’ابن سينا’’ فألف كتاب ’’الشفاء’’ في الحكمة المشائية، ثم كتاب ’’الإشارات’’ في الحكمة الأشراقية، و’’الكندي’’ حكيم آلهي وعقلي وتأكيدي وخلقي وديني وقائل بوجود المجردات والموجودات الغير المحسوسة ومعتقد بشرف الإنسانية واحترام النواميس الفطرية.
ثقافة قرآنية تاريخية
قرأ (الكندي) في القرآن الكريم قوله تعالى:{هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب}، فتحير الكندي في المتشابهات فقال له بعض تلامذته: ’’إنما يعرف القرآن من خوطب به’’ وهو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ’’وأهل البيت أدرى بما في البيت’’ وعندنا في سامراء رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حفيده وسبطه الإمام الحسن العسكري وقد أجبره الخليفة على الإقامة في سامراء، فأسأله عن تفسير الآيات وتأويل المتشابهات، فاستحسن (الكندي) كلامه وهكذا ساعده التوفيق الآلهي على تحصيل الثقافة القرآنية الكاملة من الإمام الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منقبة تاريخية تفرد بها الكندي ولا يشاركه فيها أحد من فلاسفة العرب والمسلمين.
فلسفة الكندي الإلهية
يرى (الكندي) أن العالم - أي ما سوى الله - كله حادث ومخلوق لله الواحد الأحد وهو المبدع الأول وعلة العلل وأن سلسلة الموجودات الإمكانية التي أفاضها المبدأ الأول بقدرته الأزلية وبعلمه العنائي بالنظام الأحسن تبتدئ من أكملها وأتمها وجودا وهو العقل المجرد من المادة ذاتا وفعلا فهو ليس ماديا ولا زمانيا بل هو فوق المادة وفوق الزمان، خلق الله العقل الأول مزودا بالقدرة على التأثير في ما يليه، وهو العقل الثاني وعلى تصوير مادة المخترعات الفلكية كما أراده الله تعالى، وتنتهي سلسلة العقول الطولية - التي جعل الله كل سابق منها علة مكانية للاحق - إلى العقل العاشر المدبر في عالم التكوين المادي بأمر الله تعالى. والعقول العشرة الطولية كلها جواهر مجردة عن المادة ومستغنية عنها في ذواتها وفي أفعالها ولكن النفس جوهر مجرد عن المادة في ذاتها ومحتاج إليها في أفعالها، وعالم العقول يسمى (عالم الإبداع) المنزه عن المادة والزمان، والعقول العشرة هي (المرتبة الأولى) في سلسلة الوجود الإمكاني المرتب على نظام الأشرف فالأشرف، وتسمى العقول العشرة (المبدعات) كما تسمى (المرتبة الثانية) المخترعات، وهي موجودات مادية لا تقترن بالزمان وهي الأفلاك والفلكيات ونفوسها الكلية، والموجودات المثالية، وعالمها (عالم الاختراع) والاختراع في مصطلح الفلاسفة، إيجاد شيء لا في زمان عن مادة لطيفة غير مادة المكونات، تسمى ب (الأثير).
وأما (المرتبة الثالثة) فهي (المكونات) وعللها (عالم التكوين) وهي موجودات مقترنة بالمادة والزمان، وهي العناصر، والطبع، والصورة الجسمية، والهيولى - العنصر المادي - التي هي خاتمة القوس النزولي للوجود والعنصريات من الأجسام، والمواليد الثلاث، أي النبات، والحيوان والإنسان.
وفي رأي (الكندي) للنبات نفس نباتية مع قواها، وللحيوان نفس حيوانية مع قواها، والإنسان مخصوص بالنفس الناطقة التي هي مجردة عن المادة في ذاتها وأما في أفعالها فهي محتاجة إلى البدن والجوارح، وللنفس الناطقة الهابطة من عالم الملكوت إلى عالم الملك (قوتان) (إحداهما) قوة نظرية بها تستكمل الفيض الذي تأخذه من عالم الملكوت، وللنفس بحسب هذه القوة العلامة مراتب أربع وهما (العقل الهيولاني) فا(لعقل بالملكة) و(العقل المستفاد) و(العقل بالفعل) ووجه الضبط أن مراتب النفس من بداية الاستكمال إلى نهايته أما استعداد الكمال أو نفس الكمال، والاستعداد، (إما) استعداد محض فهو (العقل الهيولاني)، تشبيها في خلوه من جميع الصور العقلية الكمالية بالهيولى الأولى الخالية في ذاتها عن جميع الصور االجسمية، و(إما) استعداد الاكتساب، فهو (العقل بالملكة) وهو كقل استعداد كسب النظريات المعقولة من أوليات معقولة، بالفكر أو بالحدس، و(أما) استعداد الاستحضار، وهو (العقل بالفعل) وهو عقل استعداد استحضار النظريات المكتسبة المخزونة متى شاء بمجرد الالتفات إليها من دون حاجة إلى تجديد النظر، وأما مرتبة (نفس الكمال) فهي بعد انتهاء درجات الاستعداد إلى درجة الفعلية الكاملة فمتى صارت النظريات حاصلة لدى النفس واستحضرت المعلومات مشاهدة إياها مستفادة من العقل الفعال يقال لها (العقل المستفاد).
و(الثانية) قوة عملية، بها تستنبط النفس واجبها فيما يجب أن تفعل وللنفس بحسب هذه القوة العمالة أيضا أربع مراتب وهي (التجلية) ’’فالتخلية’’ ’’فالتحلية’’، ’’فالفناء’’. و’’التجلية’’، تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبوية والنواميس الإلهية، و’’التخلية’’ تهذيب الباطن عن الأخلاق السيئة والملكات الردية، و’’التحلية’’ أن تتحلى النفس الناطقة المهذبة بالفضائل النفسية ومكارم الأخلاق، و’’الفناء’’ هو الوصول في العمل إلى ما ينطبق عليه الاعتقاد بمراتب التوحيد من توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد الآثار.
هذه صورة مصغرة من بعض آراء الكندي في الفلسفة، ولكن بعض مؤرخي الفلسفة وقع تحت تأثير دعايات أعداء ’’الكندي’’ فلا يميل إلى الأخذ بالرأي القائل بأن ’’الكندي’’ أبدع مذهبا مستقلا في الفلسفة.
أعداء الكندي
كان للكندي أعداء كثيرون، شأن كل العباقرة المبرزين في العلوم والفنون، وقد استطاعوا أن يضروه في سمعته العلمية والدينية وفي حياته الخاصة، فمن هؤلاء الأعداء ’’أبو معشر المنجم’’، جعفر بن محمد بن عمر البلخي قال ’’ابن النديم’’، ’’كان أبو معشر أولا أصحاب الحديث، وكان يضاغن الكندي ويغري به العامة، ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة فدس عليه الكندي من حسن له النفر في علوم الحساب والهندسة فدخل في ذلك فلم يكمل له فعدل إلى النجوم وانقطع شره عن الكندي وقيل إنه أصبح أحد تلاميذه الممتازين ويقال: إنه تعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره وكان فاضلا حسن الإصابة وضربه المستعين العباسي أسواطا لأنه أصاب في شيء خبره بكونه قبل وقوعه، فكان يقول: (أصبت وعوقبت).
ومن (أعداء الكندي) العالمان العلمان محمد وأحمد ابنا موسى بن شاكر، اللذان دسا للكندي عند المتوكل، وساعدهما أولا ما نسب إلى الكندي من الآراء الاعتزالية، وثانيا حماقة المتوكل وتسرعه، فضربة وأرسل إلى منزله من استولوا على كتبه، ثم ردت إليه كل هذه الكتب بعد زمن كما ذكر ذلك ابن أبي أصيبعة في قصة طويلة ولكن فاته أن غضب المتوكل على الكندي كان لأجل اتهامه بالتشيع، حيث أخبر أن الكندي تعلم من الإمام الحسن العسكري تفسير القرآن وأصول الإسلام.
ومن الذين تأثروا بكتابة أعدائه المعاصرين له (أبو القاسم) صاعد بن أحمد الذي حمل على الكندي فيما بعد في كتاب ’’طبقات الأمم’’ ووصف كتبه بأنها لا تفيد المطلعين عليها لكونها تشتمل على كليات غامضة ليس فيها تحليل للجزئيات، ولكون تراكيبها غامضة معماة لا تستفيد منها إلا من مرن على دراسة المنطق حتى أصبح عنده مقدمات عتيدة تمكنه من فهمها، ويضيف إلى هذه المعاني قوله: ولا أدري ما حمل يعقوب على الإضراب عن هذه الصناعة الجليلة، هل جهل مقدارها أو ضن على الناس بكشفه؟ وأي هذين كان فله نقص فيه، وله بعد هذا رسائل كثيرة في علوم جمة ظهرت له فيها آراء فاسدة، ومذاهب بعيدة عن الحقيقة’’. ويعلق ’’ابن أبي أصيبعة’’ على رأي هذا القاضي المغرض أو المقلد في الجزء الأول من كتاب (عيون الأنباء) بقوله: ’’أقول: هذا الذي قد قاله القاضي ’’صاعد’’ عن ’’الكندي’’ فيه تحامل كثير عليه، وليس ذلك مما يحط من علم، ولا مما يصد الناس عن النظر في كتبه والانتفاع بها. وعلى الرغم من هذه الدسائس التي حاكها أعداء (الكندي)، فإن اسمه ظل نجما ساطعا في تاريخ الفلسفة العربية، وبقي إمام الفلاسفة وأول المتبحرين في الحكمة. وقال بعض المغرضين: ’’كان الكندي’’ يقول بوحدة واجب الوجود وبساطة وجوده ومعنى هذا إنكار الصفات بتاتا كما يقول المعتزلة لأنها تجر إلى تعدد القدماء الذي هو لازم مذهب الأشاعرة، فتأثر ’’الكندي’’ بالمعتزلة وصرح بأن الله قادر بذاته عالم بذاته وهلم جرا. ولا شك أن أرسطو قد سبق المعتزلة إلى نفي جميع الصفات عن الباري.
وزاد عليه بعض آخر بقوله: ’’إن إنكار الصفات بتاتا إنكار لنصوص القرآن العظيم، وخروج عن الإسلام واتجاه إلى الكفر والإلحاد’’.
أقول: إن المغرضين اعترفوا بأن الكندي قائل بوحدة واجب الوجود وبساطة وجوده، وإن الله قادر بذاته وعالم بذاته ولم يتفطنوا أن الكندي يقول أيضا: ’’إن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فصفاته الحقيقية كالحياة والبقاء والعلم والقدرة وغيرها كلها صفات واجبة وذاتية وليست من قبيل صفات الممكنات زائدة على الذات. وهذا الرأي للكندي اتجاه إلى التوحيد الكامل وهو توحيد الذات وتوحيد الصفات، وليس فيه اتجاه إلى الإلحاد وإنكار الخالق العظيم فالمعترضون على الكندي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها فيحق عليهم قوله تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}
وقال الدكتور قدري طوقان:
رأى الكندي بثاقب نظره أن الاشتغال في الكيمياء للحصول على الذهب مضيعة للوقت والمال في عصر كان يرى فيه الكثيرون غير ذلك.
وذهب إلى أكثر من ذلك فقال إن الاشتغال في الكيمياء بقصد الحصول على الذهب يذهب العقل والجهد والمشتغل في ذلك يخدع الناس كما يخدع نفسه، والكيمياء من هذه الناحية علم خادع وزائف. وقد وضع رسالة سماها (رسالة في بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة وخدعهم). ومن الغريب أن بعضا من رجال الفكر في عصره والعصور التي تلته قد هاجموه وطعنوا رأيه الذي ضمنه هذه الرسالة.
وكذلك كان الكندي لا يؤمن بأثر الكواكب في أحوال الناس، ولا يقول بما يقول به المنجمون من التنبؤات القائمة على حركة الكواكب. ولكن هذا لا يعني أنه لم يشتغل في الفلك، فقد وجه إليه اهتمامه من ناحيته العلمية وقطع شوطا في علم النجوم وإرصادها. وله في ذلك مؤلفات ورسائل. وقد اعتبره بعض المؤرخين واحدا من ثمانية هم أئمة العلوم الفلكية في القرون الوسطى. وقد يكون الرأي الذي قال به من عدم تأثير الكواكب في الإنسان صورة من نظرياته التي توصل إليها بما يتعلق بالنفس الإنسانية وعالم الأفلاك.
ومن دراسة لرسائله في ’’العلة القريبة الفاعلة للكون والفساد’’، يتجلى أنه كان بعيدا عن التنجيم لا يؤمن بأن للكواكب صفات معينة من النحس أو السعد أو العناية بأمم معينة. وهو حين يبحث في العوامل الكونية وفي ’’نظرية الفعل’’ وأوضاع الأجرام السماوية يبدع ويكون العالم بمعنى الكلمة الدقيق. فلقد لاحظ أوضاع النجوم والكواكب - وخاصة الشمس والقمر - بالنسبة للأرض، وما لها من تأثير طبيعي وما ينشأ عنها من ظاهرات ’’يمكن تقديرها من حيث الكم والكيف والزمان والمكان...’’.
وضع الكندي تفسيرا علميا بصفات الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان، وقال إن اختلاف خصائصها يرجع إلى المناطق التي تعيش فيها هذه الكائنات وإلى فعل الجو في التركيب البدني والوظائف البدنية وفي المزاج النفسي والأخلاق والاستعداد العقلي. لأن بدن كل كائن ’’يجعل لهذا الكائن الأخلاق التي تلحقه، وذلك منذ تولد النطف واستقرارها في الأرحام، لأن مزاجات النفس متبعة مزاجات الأجسام بوجه عام’’.
وتبعا لذلك كله ’’تكثر الكائنات الحية أو تقل وتزداد معالم العمران أو تنقص’’ ويعلق الدكتور أبو ريده على ذلك بقوله ’’وكان الكندي يريد أن يفسر التاريخ على ضوء هذه النظرية’’. فهو يقول إن العوامل الكونية التي يتكلم عنها تؤدي في كل دهر بحسب المزاج العام للنوع والمزاج الخاص للأفراد، إلى ظهور استعدادات نفسية وخلقية فتحدث أنواع جديدة من الإرادات والهمم تؤدي بدورها إلى أحوال وسنن جديدة وإلى تغير الدول وما يشبه الدول.
وهنا لا بد من التعليق بأن العلماء في هذا العصر قد توصلوا إلى أن هناك صلة بين العوامل الجوية وبين مزاج الإنسان كما قال الكندي. فدرس العلماء العلاقة بين إشعاع الشمس وكلفها والتقلب في أحوال الجو وبين كهربة الجو والشحنات التي يحملها وظهر لهم أن علاقة وثيقة بين الهواء الذي نتنفسه وبين المزاج. فالشعور بالنشاط أو الفتور يتصل بالجو وبما يحويه من دقائق مكهربة، إذ لا يخفى أن الهواء يحتوي على دقائق مكهربة بعضها يحمل شحنات موجبة وبعضها يحمل شحنات سالبة. وهذه الشحنات تؤثر على الإنسان في مزاجه وفي نشاطه وفي فتوره وتعبه وأعيائه، كما تؤثر على تفكيره ونتاجه وأعماله واستعداداته النفسية والخلقية. وهذه الشحنات تتأثر بالشمس وكلفها، أي أن الأساس في تقلبات الجو وكهربته يعود إلى الشمس. وهذا ما يراه الكندي من الشمس هي التي تسبب الظواهر الجوية ’’وهي التي تؤثر في الكائنات الحية على ظهر الأرض من نبات وحيوان وإنسان’’ وهو ما يسميه الكندي بالحرث والنسل وفي خصائصها’’.
وأتى الكندي فوق ذلك بآراء خطيرة وجريئة في نشأة الحياة على الأرض مما دفع الكثيرين إلى الاعتراف بأن الكندي مفكر عميق من الطراز الحديث. وتتجلى آراؤه هذه في رسالته ’’في العلة القريبة الفاعلة للكون والفساد’’. فدلل بها على بصيرة نافذة وعمق في التفكير وإعمال للعقل دون التقيد بآراء من سبقوه من علماء اليونان وفلاسفتهم، فكان في استنتاجاته واستقصائه وبحثه وما توصل إليه مثال العالم المبتكر والمفكر الملهم.
ودرس الكندي الرسائل والمؤلفات التي وضعها علماء اليونان في البصريات وانتقد بعضها وفي رأيه أنه لا ينبغي للعالم أن يبدي رأيا لا يستطيع إثباته بالأدلة.
وقال ’’الدكتور فرانتز روزنتال’’: ’’وكان الكندي على صواب عندما أظهر استياءه من العالم اليوناني الذي أعتمده عندما كان يصنف رسالة من رسائله في البصريات، وذلك لأن هذا العالم اليوناني لم يراع الأساليب العلمية المعترف بها...’’ وقد أخرج الكندي رسائل قيمة في البصريات والمرئيات وله فيها مؤلف لعله من أروع ما كتب. وهو يلي كتاب الحسن بن الهيثم مادة وقيمة. وقد انتشر هذا الكتاب في الشرق والغرب وكان له تأثير كبير على العقل الأوروبي كما تأثر به باكون وواتيلو.
وللكندي رسالة بسبب زرقة السماء. وتقول دائرة المعارف الإسلامية: إن هذه الرسالة قد ترجمت إلى اللاتينية، وهي تبين أن اللون الأزرق لا يختص بالسماء، بل هو مزيج من سواد السماء والأضواء الأخرى الناتجة عن ذرات الغبار وبخار الماء الموجود في الجو. ويمتدح ’’دي بور’’ رسائل أخرى صغيرة وضعها الكندي في ’’المد والجزر’’ ويقول بصددها: ’’.. وعلى الرغم من الأخطاء التي تحويها هذه الرسالة إلا أن نظرياتها قد وضعت على أساس من التجربة والاختبار..’’ فقد كان الكندي يلجأ إلى التجربة ويرى فيها سبيلا للوصول إلى الحقيقة والوقوف عليها. والكندي يلجأ في طريقة العرض إلى عرض رأي من تقدمه على أقصر السبل وأسهلها سلوكا، وأن يكمل بيان ما لم يستقصوا القول فيه ’’.. اعتقادا منه أن الحق الكامل لم يصل إليه أحد، وإنه يتكامل بالتدريج بفضل تضامن الأجيال من المفكرين..’’ ولا تخلو رسائل الكندي من أفكار تشبه ما عند المعتزلة بحسب طريقتهم في التعبير غير أن الكندي - كما يقول الدكتور أبو ريدة - ’’يطبقها على نظام الكون في جملته وتفصيله. وأن تفكيره يتحرك في التيار المعتزلي الكبير في عصره، دون أن يفقد طابعه الفلسفي القوي وشخصيته المميزة وروحه الخاصة..’’.
ويتجلى تفكيره المعتزلي هذا عند بحثه في الإسلام وفيما جاء به النبي الكريم وهو يرى أنه يمكن فهم هذا كله ’’بالمقاييس العقلية التي لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل’’ على حد تعبيره. ويشترط لفهم معاني القران أن يكون ’’المفسر’’ من ’’ذوي الدين والألباب’’ عارفا بخصائص اللغة وتعبيراتها وأنواع دلالاتها عند العرب. فلقد طلب الأمير أحمد بن المعتصم من أستاذه الكندي أن يشرح له معنى الآية ’’والنجم والشجر يسجدان’’ فوضع تفسيره في رسالة سماها: ’’رسالة في الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عز وجل ’’ وشرح في هذه الرسالة معنى السجود والطاعة في اللغة حقيقة ومجازا وينتهي إلى أن سجود النجوم أو الشجر لله يعني طاعتها للأنظمة والقوانين التي وضعها الباري عز وجل وألزم بها المخلوقات جميعها بما فيها الشجر والنجم - مؤيدة وظيفتها المعينة لها في نظام العالم والكون، وبذلك تحقق إرادة بارئها وتنتهي إلى أمره. وهذا ما يمكن أن يعبر عنه مجازا بأنه سجود.
وللكندي أثر كبير في العقليات، تناولها الأوربيون من بعض مؤلفاته التي طبعت في أوروبا منذ عهد العالم بالطباعة. وقد وضع نظرية في العقل، دمج فيها آراء الذين سبقوه من فلاسفة اليونان بآراء له. فجاءت نظرية جديدة ظلت تتبوأ مكانا عظيما عند فلاسفة الإسلام الذين أتوا من بعده من غير أن ينالها تغيير يذكر. ويرى بها بعض الباحثين أنها من المميزات التي تتميز بها الفلسفة الإسلامية في كل عصورها. فهي تدل على اهتمام العرب والمسلمين بالعقل إلى جانب رغبتهم في التوسع في البحوث العلمية الواقعية.
وللكندي رسالة في أن الفلسفة لا تنال إلا بالرياضيات. أي أن الإنسان لا يكون فيلسوفا إلا إذا درس الرياضيات. ويظهر أن فكرة اللجوء إلى الرياضيات وجعلها جسرا للفلسفة، قد أثرت على بعض تآليفه فوضع رسائل في الإيقاع الموسيقي قبل أن تعرف أوروبا الإيقاع بعدة قرون......
وطبق الحروف والأعداد على الطب، ولا سيما في نظرياته المتعلقة بالأدوية المركبة. ويقول دي بور: ’’... والواقع أن الكندي بنى فعل الأدوية كما بنى فعل الموسيقى على التناسب الهندسي. والأمر في الأدوية أمر تناسب في الكيفيات المحسوسة. وهي الحار والبارد والرطب واليابس......) إلى أن يقول: ’’ويظهر أن الكندي عول على الحواس ولا سيما حاسة الذوق في الحكم على هذا الأمر حتى لقد نستطيع أن نرى في فلسفته شيئا من فكرة التناسب بين الإحساسات......’’. وهذا الى أي من مبتكرات الكندي لم يسبق إليه على الرغم من كونه خيالا رياضيا.
وكانت هذه النظرية محل تقدير عظيم عند ’’كاردانو’’ أحد فلاسفة القرن السادس عشر فأعمال العقل وحده لا يكفي في كثير من الحالات بل يجب أن يقترن ذلك بالتجربة والاختبار لتكون النتائج مستوفاة وصحيحة وموصلة إلى الحقيقة الكاملة.
واشتغل الكندي في الفلسفة، وله فيها تصانيف ومؤلفات جعلته من المقدمين ويعتبرها المؤرخون نقطة تحول في تاريخ الفكر العلمي عند المسلمين.
وهو في واقع الأمر عالم موسوعي جماع للعلوم. وكثير من كتبه يتصل بالعلوم والفلسفة اتصالا مباشرا. وقد ترجم ’’جيرارد أوف كريمونان وغيره’’ قسما كبيرا منها فأثرت تأثيرا عميقا في الشعوب اللاتينية.
وتمتاز رسائله ومؤلفاته بشمولها العام لميادين المعرفة، وقد دللت على اهتمامه بكل الاتجاهات والتيارات الفكرية في عصره معتمدا على العقل والبحث والدرس فما خالف العقل أهمله ونأى عنه حتى لو قال به أرسطو أو أفلاطون غير عابئ بقداسة الماضي وسلطانه، وما ساير العقك تمسك به وأخذه ودافع عنه.
ويعترف الأقدموق بأثره في الفلسفة وفضله عليها. فقال ابن أبي أصيبعة: ’’.. وترجم الكندي من كتب الفلسفة الكثير وأوضح منها المشكل، ولخص المستعصب وبسط العويص..’’ وهذا يدل على أنه قد فهم الفلسفة، وعلى أن فهمه وصل درجة أخرجتها من اليونانية إلى العربية. وكان يهدف من دراسته الفلسفية أن يجمع بينها وبين الشريعة، وقد تجلى هذا في أكثر مصنفاته.
وقال البيهقي: ’’... وقد جمع في بعض تصانيفه بين أصول المعقولات.. وقد وجه الفلسفة الإسلامية وجهة الجمع بين أفلاطون وأرسطو’’.
ويتبين منها أن الكندي يقف في أرض الين بقدم ثابتة كما يقول الأستاذ أبو ريدة، فقد دافع عن النبوة بالإجمال وعن النبوة المحمدية خاصة وفهم الوحي الإسلامي فهما فلسفيا ’’ولا تفتأ تظهر في رسائله عبارات واضحة تدل على روح الإيمان العميق’’ وقد اضطرته روح الإيمان هذه إلى مخالفة أرسطو في قدم العالم وإلى تأكيد العناية الإلهية وصفات الإله المبدع الفعال المدير الحكيم’’ ويخرج من نظره الفلسفي بوجهة نظر عامة تقوم على فهم الدين بالعقل الفلسفي وتنتهي إلى مذهب ديني فلسفي معا......’’.
ويمكن القول أن الكندي كما يقول ماسينيون إمام مذهب فلسفي إسلامي. وقد أثرت الفلسفة على اتجاهات تفكيره، فكان ينهج منهجا فلسفيا يقوم على العناية بسلامة المعنى من الوجهة المنطقية واستقامته في نظر العقل.
وله منهج خاص به ’’... يقوم أولا على تحديد المفهومات بألفاظها الدالة عليها تحديدا دقيقا بحيث يتحرر المعنى......’’. وهو لا يستعمل ألفاظا لا معنى لها لأن ’’... مما لا معنى له فلا مطلوب فيه. والفلسفة إنما تعتمد على ما كان فيه مطلوب. فليس من شأن الفلسفة استعمال ما لا مطلوب فيه..’’. وكذلك يقوم منهج الكندي على ذكر المقدمات، ثم يعمل على إثباتها على منهج رياضي استدلالي. ’’.. قطعا لمكابرة من ينكر القضايا البينة بنفسها، وسد الباب اللجاج من جانب أهل العناد..’’ ومن يطلع على رسائله يجد أن الطريقة الاستنباطية تغلب عليها، ’’.. وإن منهجه منطقي رياضي يدهش الإنسان من إتقانه في ذلك العصر البعيد......’’ للميلاد مما جعله يقول: ’’.. إن الكندي من الاثني عشر عبقريا الذين هم من الطراز الأول في الذكاء......’’.
والكندي مخلص للحقيقة يقدس الحق، ويرى في معرفة الحق كمال الإنسان وتمامه، ويتجلى ذلك في رسالة الكندي إلى ’’المعتصم بالله’’ في الفلسفة الأولى. فقد جاء في هذه الرسالة: ’’... أن أعلى الصناعات الإنسانية وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة. ولماذا..؟ لأن حدها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، ولأن غرض الفيلسوف في عمله، إصابة الحق، وفي عمله، العمل بالحق......’’.
ويعرف الكندي للحق قدره، ويقول في هذا الشأن: ’’.. وينبغي أن لا نستحي من الحق واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة لنا، فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق.. وليس ينبغي بخس الحق ولا تصغير قائله والآتي به. ولا أحد بخس بالحق بل كان يشرفه الحق......’’.
وفي رأي الكندي إن الحياة قصيرة وإنها لا تكفي لمعرفة الحقيقة الكاملة. فمهما طالت حياة الفرد وعكف على البحث وحصر نفسه وجهوده في الدرس والتفكير فلن يصل إلى الحقيقة الكاملة بل هو في بحثه ودراسته وتفكيره إنما يعمل لها ويسعى للوصول إليها، وحسبه في هذا شرفا وسعادة.
ويرى الكندي أن معرفة الحق ثمرة لتضامن الأجيال الإنسانية، فكل جيل يضيف إلى التراث الإنساني ثمار أفكاره، ويمهد السبيل لمن يجيء بعده، ويدعو إلى مواصلة البحث عن الحق والمثابرة في طلبه، وشكر من يشغل نفسه وفكره في ذلك. وهو يعتبر طالبي الحق شركاء وأن بينهم نسبا ورابطة قوية هي رابطة البحث عن الحق والاهتمام به.
وقد دفعه اهتمامه بالحق وطالبيه إلى الشعور بمسؤوليته، وإن عليه أن يساهم في بناء الحقيقة ويدعو إلى الإخلاص لها، ويحدب على طالبها والتفاني في إسعافه. وبذلك يدفع المجهود الفلسفي إلى الأمام.
يقول الكندي في هذا الشأن في كتابه إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ما يلي:
’’... ومن أوجب الحق الأندم من كان أحد أسباب منافعنا العظام الصغار. فكيف بالذين هم من أكبر أسباب منافعنا العظام الحقيقية الجدية، فإنهم وإن قصروا عن بعض الحق، فقد كانوا لنا أنسابا وشركاء فيما أفادونا من ثمار فكرهم التي صارت لنا سبالا وآلات مؤدية إلى علم كثير.
فينبغي أن يعظم شكرنا للآتين بيسير الحق، فضالا عمن أتى بكثير من الحق، إذ أشركونا في ثمار فكرهم وسهلوا لنا المطالب الخفية الحقية، بما أفادونا من المقدمات المسهلة لنا سبل الحق، فإنهم لو لم يكونوا، لم تجتمع لنا مع شدة البحث في مددنا كلها هذه الأوائل الحقية، التي بها تخرجنا إلى الأواخر من مطلوباتنا الخفية. فإن ذلك إنما اجتمع في الأعصار السالفة المتقادمة عصرا بعد عصر إلى زماننا هذا، مع شدة البحث ولزوم الدأب وإيثار التعب في ذلك......’’.
والكندي أدرك بحدة نظره وثاقب تفكيره بأن الثبات والدوام في هذا العالم غير موجودين وأن قانون التغير يسيطر على عوامل الكون، ومن يرفض هذه القانون فهو في واقع الأمر يرفض الحياة نفسها ويدلل على فكر سقيم وعقلية عقيمة.
ولم يقف الكندي عند هذه الحدود بل نفذ عقله إلى الخروج بالقول ’’إن مقتنيات الحياة مشتركة بين جميع الناس وأنه لا يصح للإنسان الاستئثار بها أو أن يحسد غيره عليها......’’.
والكندي في حياته كان منصرفا إلى جد الحياة، عاكفا على الحكمة ينظر فيها التماسا لكمال نفسه.
وفوق ذلك فالكندي ذو روح علمي صحيح، أبعد عنه الغرور، وجعله يرى الإنسان العاقل مهما يبلغ في العلم، فهو لا يزال مقصرا، وعليه أن يبقى عاملا على مواصلة البحث والتحصيل. وقد قال في هذا الشأن:
’’... العاقل من يظن أنه فوق عمله، فهو أبدا بتواضع لتلك الزيادة، والجاهل يظن أنه تناهى فتمقته النفوس لذلك......’’.
يرى الكندي أن على الإنسان أن يستعمل عقله في تدبير نفسه وسياستها والاهتمام بمطالبتها الحقيقية دون أن يعطي هذه الحياة أكثر مما تستحق. وأنه بالعقل والفضيلة والحكمة يمكن للإنسان أن يخلص من الأحزان ويحرر نفسه من القلق.
وفي رأي الكندي أن مفهوم الفلسفة يجب أن يقوم على المعرفة والسيرة العلمية. فلا يكفي أن يفهم الإنسان الفلسفة من حيث هي معرفة فقط بل يجب أن تقترن هذه المعرفة بسيرة عملية، فيعرف الإنسان نفسه ويخلصها من أدران الأنانية والطمع والحسد، ويجعل العقل رائده وقائده وحكما في الفصل بين الحق والباطل. وبذلك يؤدي رسالة الحياة على أتم ما يكون الأداء ويمهد للحياة الخالدة التي يرنو إليها الحكماء والفلاسفة في كل زمان ومكان.
وقال محمد كاظم الطريحي:
عقيدته:
اختلف المؤرخون في ديانته، وعقيدته اختلافا كبيرا، فمنهم من رفعه إلى مصاف علماء الدين، ومنهم من رماه بالكفر والإلحاد، ومنهم من قال إنه كان يهوديا ثم أسلم، والآخر قال: كان نصرانيا، وكل واحد من هؤلاء ينسب له رواية أو قصة يؤيد فيها ما ذهب إليه في عقيدة الكندي وملته، على أن عقيدته تستفاد من قراءة ما تبقى من مؤلفاته، وترجمته، وتعرف بما مر عليه من الأحداث التي كان مشاركا فيها، ونكب من أجلها، ثم دراسة أخبار تلاميذه، ومعتقداتهم، والخلفاء الذين عاصرهم، وكان عندهم عظيم المنزلة، وينفرد البيهقي بذكر الخلاف في ملة الكندي، ويتابعه الشهرزوري ثم يذكره السمرقندي في حكاية أكثرها أوهام، منها قوله ’’كان يعقوب بن إسحاق الكندي يهوديا، ولكنه كان فيلسوف زمانه، وحكيم عصره، وكان مقربا عند المأمون، وقد دخل عليه يوما فاتخذ لنفسه مجلسا أعلى من مجلس أحد أئمة الإسلام، فقال هذا’’: ’’إنك رجل ذمي، فكيف تتخذ مكانا أعلى من مكان أئمة الإسلام، فأجاب يعقوب: ’’لأني أعلم ما تعلم، وأنت تجهل ما أعلم، وتوهم مؤلف اكتفاء القنوع عند ذكره لمؤلفات الكندي المطبوعة فقال: كان في أيام الخليفة العباسي المأمون بن الرشيد، عالم نبيل من أقاربه، وهو عبد الله بن إسماعيل الهاشمي له الاطلاع الواسع، والبحث المدقق في الأديان، وكان صديقا للكندي الذي اشتهر بحب النصرانية، والتمسك بها يحاكي تمسك الهاشمي بالإسلام، وشدة إغراقه فيه، فكتب الهاشمي للكندي رسالة بليغة في محاسن دينه، وكتابه دعاه فيها إلى الإسلام، فرد عليه الكندي النصراني، رسالة أظهر له فيها وجوه صحة النصرانية بالأدلة القوية، طبعت الرسالتان معا سنة 1888م في 180 صحيفة، وهما بليغتا العبارة، قويتا الحجة. عظيمنا الفائدة في هذا الباب، وعند رجوعي إلى الرسالة وجدت أنها تنسب إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي، وتوهم أيضا الأب لويس شيخو فقال في كتابه مجاني الأدب، ’’يعقوب بن إسحاق النصراني، له رسالة مشتهرة فند فيها اعتراضات ابن إسماعيل الهاشمي على النصرانية، ذكرها أبو الريحان البيروني في تاريخه، فرد عليه الأب انستاس الكرملي في مجلة لغة العرب بعد أن أورد نص عبارته، قال: يظهر من هذا الكلام أنه نقل كلامه هذا عن أبي الفرج، والحال أن أبا الفرج قال: ولم يكن في الإسلام من اشتهر عند الناس بمعاناة علم الفلسفة حتى سموه فيلسوفا غير يعقوب هذا، وقال الكرملي: يظهر هو زيادة الأب شيخو، فقوله له اليد الطولى بعلوم اليونان، والهند، والعجم، لا ينطق به ابن العبري، ولا العربي الفصيح، وأما دسه لم يكن في العرب، فالذي في الأصل، لم يكن في الإسلام، ثم لا نفهم كيف يكون أبو يعقوب أميرا على الكوفة لو كان نصرانيا، وأهل الكوفة منذ صدر الإسلام كانوا متمسكين بدينهم الحنيف، فكيف يقبلون عليهم أميرا نصرانيا، هذا من جهة هذه الترجمة، وأما من جهة ابن العبري بإسلامية الكندي فصريح من قوله لم يكن في العرب، وبين الكلامين فرق لا يخفى على المطالع’’.
والظاهر أن الأب شيخو اقتبس كلامه من اكتفاء القنوع المار الذكر بدون الإشارة إليه، فظن الأب الكرملي أنه مقتبس من كلام ابن العبري للتشابه بالعبارات، واتهم الكندي أيضا في التشكيك بالقرآن الكريم قال كليموفيتش: ’’وكان فيلسوف العرب الكندي الذي كان يتجه بآرائه نحو فلسفة أرسطو يشك بالقرآن لأنه كان يجد فيه متناقضات، وضعف أسلوب، وعدم تناسق، وترتيب، ومن الممكن أن كليموفيتش اطلع على ما ذكره الحافظ العسقلاني فظن العكس، قال في لسان الميزان عن ابن النجار قال: ’’وكان أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي متهما في دينه، ثم ساق من طريق أبي بكر النقاش المفسر عن أبي بكر بن خزيمة قال: قال أصحاب الكندي له أعمل لنا مثل القرآن؟ فقال: نعم، فغاب عنهم طويلا، ثم خرج عليهم فقال: والله لا يقدر على ذلك أحد’’.
وقيل أنه كان يذهب في نسب يونان إلى أنه أخ لقحطان، فاتخذ من رأيه هذا حجة في اتهامه بالإلحاد، قال المسعودي: ’’كان يذهب في نسب يونان إلى أنه أخ لقحطان، ويحتج لذلك بأخبار يذكرها، ويوردها من حديث الآحاد، والأفراد، لا من حديث الاستفاضة والكثرة، وقد رد عليه أبو العباس الناشي في قصيدة طويلة قال:
أبا يوسف إني نظرت فلم أجد | على الفحص رأيا صح منك ولا عقدا |
وصرت حكيما عند قوم إذا امرؤ | بلاهم جميعا لم يجد عندهم عندا |
أتقرن ألحادا بدين محمد | لقد جئت شيئا يا أخا كندة أدا |
وتخلط يونانا بقحطان فضلة | لعمري لقد باعدت بينهما جدا |
وذكره السيد ابن طاووس فقال: ’’وقيل أن من علماء الشيعة الشيخ الفاضل إسحاق بن يعقوب الكندي’’، وزاد عليه صاحب الذريعة فقال: ’’من علماء الشيعة العارفين’’ والنص الوحيد الذي عثرت عليه والذي يمكننا بواسطته التعرف إلى آراء الكندي الدينية، هو ما ذكره أحمد بن ’’النظيم’’ السرخسي قال: قال الكندي: ’’لا يفلح الناس وعين تطرف رأت المتوكل، قال: وكان المتوكل أمر بضرب الكندي سنة اثنتين وأربعين ومائتين، وكانت خمسين سوطا، فضرب وكان منسوبا إلى الزيدية’’.
والزيدية من أصور الشيعة، ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، وهم ثلاث طوائف، يشترطون في الإمام أن يكون هاشميا، ورعا، تقيا، عالما سخيا، يخرج داعيا لنفسه، والإمام بعد علي عليه السلام يشترط أن يكون فاطميا، ذكرا، بالغا، عاقلا، سليم الحواس والأطراف، شجاعا لم يمارس مهنة مرذولة، عادلا، ورعا كريما، حسن الدراية بتصريف الأمور، مجتهدا، ويكون أفضل أهل زمانه. وإذا تساهلوا في بعض الشروط، فإنهم لا يتساهلون في كونه علويا، فاطميا، وأن يبلغ مرتبة الاجتهاد، وأن يكون أفضل أهل زمانه، وهم يتفقون مع المعتزلة في أصول الدين والمذهب الز
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 10- ص: 307
الكندي الفيلسوف يعقوب بن إسحاق.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 24- ص: 0
الكندي الفيلسوف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس: أبو يوسف الكندي الكوفي الفيلسوف.
كان والده شاعرا. وكان يعقوب واحد عصره في المنطق، والهندسة، والطب والنجوم، وعلم الأوائل. لا مدافع له عن تقدمه ورياسته في ذلك.
وهو معدود في فلاسفة الإسلام، وقد تقدم ذكرهم في ترجمة الرئيس أبي علي الحسين بن سينا.
وله مصنفات كثيرة وتلاميذ، وله مع معرفة بالأدب وشعر حسن، وكان مفرط البخل، وكان يأكل التمر ثم يدفع النوى إلى داية له ويقول: تجزي بما بقي عليه من حلاوة التمر.
وجاءت إليه يوما جارية سوداء من عند أمه ومعها كوز فقالت له: أمك تطلب منك ماءا باردا فقال: ارجعي فأملي الكوز من عندها وجيئي به فلما جاءت به قال: فرغيه عندنا وأعطيها ملأه من المزملة فلما مضت قال: أخذنا منها جوهرا بلا كيفية وأعطيناها جوهرا بكيفية لتنتفع به.
قال محب الدين ابن النجار: قرأت في كتاب أبي عبد الله بن محمد بن محمود بن الجراح الكاتب قال: حدثني محمد بن شيبان عن أبي علي عبد الرحمن بن يحيى بن خافان: ما رأيته حيا قط، يعني يعقوب الكندي فرأيته في المنام بنعته وصفته فسألته: ما فعل الله بك؟
فقال: ما هو إلا أن رآني فقال: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. نعوذ من غضبه.
وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أصحاب الكندي للكندي: اعمل لنا مثل القرآن:
..... نعم أو بعضه.
فغاب دهرا طويلا ثم خرج إليهم فقال: والله لا يقدر عليه ولا على بعضه فإني فتحت المصحف فخرج المائدة، فنظرت أولها فإذا هو بعدما نبه ونادى وحض تعظيما للإيمان به: أمر بالوفاء ونهى عن النكث والغدر، وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى من الجميع بعضا وبعضا شروطا فيه لموجب، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطر ونصف، وهذا مما لا يتأتى لأحد من المخلوقين.
ومن شعر الكندي:
أنا الذبابى على الأرؤس | فغمض جفونك أو نكس |
وضايل سوادك واقبض يديك | وفي قعر بيتك فاستجلس |
وعند مليكك فابغ العلو | وبالوحدة اليوم فاستأنس |
فإذا الغنى في قلوب الرجال | وإن التعزز للأنفس |
وكائن ترى من أخي عسرة | غنى وذي ثروة مفلس |
ومن قائم شخصه ميت | على أنه بعد لم يرمس |
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 28- ص: 0
ويعقوب بن إسحاق ابن الصباح، الكندي الأشعثي الفيلسوف، صاحب الكتب، من ولد الأشعث بن قيس، أمير العرب.
كان رأسا في حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم والطب وغير ذلك. لا يلحق شأوه في ذلك العلم المتروك، وله باع أطول في الهندسة والموسيقى.
كان يقال له: فيلسوف العرب، وكان متهما في دينه، بخيلا، ساقط المروءة، وله نظم جيد وبلاغة وتلامذة، هم بأن يعمل شيئا مثل القرآن، فبعد أيام أذعن بالعجز.
قال عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: رأيته في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: ما هو إلا أن رآني، فقال: {انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون}.
وقد روى عن أبيه أبو داود.
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 10- ص: 46