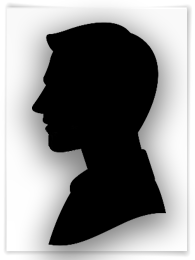منظور بن زبان
منظور بن زبان منظور بن زبان بن سيار الفزاري: شاعر مخضرم، من الصحابة. كان سيد قومه. وتزوج امرأة ابيه مليكة بنت خارجة المزنية، فقيل: ان ابا بكر، لما ولى الخلافة، بحث عنه فعلم انه ومليكة في البحرين، فأقدمهما المدينة وفرق بينهما، وقيل: كان ذلك في خلافة عمر، واراد عمر قتله فحلف بأنه ما علم ان الله حرم ذلك، ففرق بينهما. وله بعد فراقها اشعار رقيقة. ويظن انه عاش إلى خلافة عثمان.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 7- ص: 308
منظور بن زبان منظور بن زبان بن سيار بن عمرو- وهو العشراء بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي ابن مازن بن فزارة الفزاري.
وهو الذي تزوج امرأة أبيه، فأنفذ إليه النبي صلى الله عليه وسلم خال البراء ليقتله. وهو جد الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لأمه، أمه خولة بنت منظور، وهي أيضا أم إبراهيم ابن محمد بن طلحة.
ذكره ابن ماكولا هكذا، ولو لم يكن مسلما لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لنكاحه امرأة أبيه، ولكان قتله على الكفر.
دار ابن حزم - بيروت-ط 1( 2012) , ج: 1- ص: 1172
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1994) , ج: 5- ص: 260
دار الفكر - بيروت-ط 1( 1989) , ج: 4- ص: 496
منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمى بن مازن بن فزارة.
ذكر الدار الدارقطني وعبد الغني بن سعيد في المشتبه، عن المفضل الغلابي- أنه قال في حديث البراء بن عازب: أتيت خالي ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه. قال: هذا الرجل هو منظور بن زبان.
وحكى عمر بن شبة أن هذه الآية، وهي قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف}... - نزلت في منظور بن زبان، خلف على امرأة أبيه واسمها مليكة، وأن أبا بكر الصديق طلبهما لما ولي الخلافة إلى أن وجدهما بالبحرين، فأقدمهما المدينة، وفرق بينهما، وأن عمر أراد قتل منظور، فحلف بالله أنه ما علم أن الله حرم ذلك.
وفي ذلك يقول الوليد بن سعيد بن الحمام المري من أبيات:
بئس الخليفة للآباء قد علموا | في الأمهات أبو زبان منظور |
وقال أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني»: كان منظور سيد قومه، وهو أحد من طال حمل أمه به، فولدته بعد أربع سنين، فسمي منظورا لطول ما انتظروه، قال: وذكر الهيثم بن عدي، عن عبد الله بن عياش المنتوف، وعن هشام بن الكلبي، قال: وذكر بعضه الزبير بن بكار عن عمه، عن مجالد، قالوا تزوج منظور بن زبان امرأة أبيه وهي مليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة المزني، فولدت له هاشما وعبد الجبار وخولة، ولم تزل معه إلى خلافة عمر، فرفع أمره إلى عمر، فأحضره وسأله عما قيل فيه من شربه الخمر ونكاحه امرأة أبيه، فاعترف بذلك، وقال: ما علمت أن هذا حرام، فحسبه إلى قرب صلاة العصر، ثم أحلفه أنه لم يعلم أن الله حرم ذلك، فحلف فيما ذكروا أربعين يمينا، ثم خلى سبيله، وفرق بينه وبين مليكة، وقال: لولا أنك حلفت لضربت عنقك.
وقال ابن الكلبي في روايته: قال عمر: أتنكح امرأة أبيك وهي أمك؟ أو ما علمت أن هذا نكاح المقت، ففرق بينهما، فاشتد ذلك عليه، فرآها يوما تمشي في الطريق فأنشد:
ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر | إذا منعت مني مليكة والخمر |
فإن تك قد أمست بعيدا مزارها | فحي ابنة المري ما طلع الفجر |
لعمر أبي دين يفرق بيننا | وبينك قسرا إنه لعظيم |
وذكر الزبير بن بكار في «أخبار المدينة»: قال: قال عمر لما فرق بين منظور ومليكة: من يكفل هذه؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا، فأنزلها داره، فعرفت الدار بعد ذلك بها، فكان يقال لها دار مليكة.
وذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة»: أن ذلك كان في خلافة عمر كما سأذكره في ترجمة مليكة في النساء.
وذكر ابن الكلبي في كتاب «المثالب» أنها كانت تكنى أم خولة، وأنها كانت عند زبان، فهلك عنها ولم تلد له، فتزويجها ولده نكاح مقت... فذكر القصة مطولة.
وذكر أبو موسى في ذيله في ترجمة مليكة هذه، من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن عكرمة، قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء بعولتهن، فذكر منهن مليكة، خلف عليها منظور بعد أبيه.
وقال أبو الفرج أيضا: خطب الحسن بن علي خولة بنت منظور هذا، وأبوها غائب فجعلت أمرها بيده، فتزوجها فبلغه فقال: أمثلي يفتات عليه في ابنته؟ فقدم المدينة فركز راية سوداء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبق في المدينة قيسي إلا دخل تحتها، فبلغ ذلك الحسن، فقال: شأنك بها. فأخذها وخرج، فلما كان بقباء جعلت تندبه، وتقول: يا أبت الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة! فقال: تلبثي هنا فإن كان له بك حاجة فسيلحقنا. قال: فأقام ذلك اليوم، فلحقه الحسن ومعه الحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن عباس، فزوجها من الحسن، ورجع بها.
وأظن هذه البنت هي التي ذكرت في ترجمة الفرزدق الشاعر، أو هي أختها، وذلك أن زوجته النوار لما فرت منه إلى ابن الزبير بمكة، وهو يومئذ خليفة، قدم مكة، فنزل على بني عبد الله بن الزبير، فمدحهم، وكانت النوار نزلت على بنت منظور بن زبان، فقضى ابن الزبير للنوار على الفرزدق في قصة مذكورة، وفي ذلك يقول الفرزدق:
أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم | وشفعت بنت منظور بن زبانا |
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا | مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا |
وذكر ابن الأثير في ترجمته، عن الأمير أبي نصر بن ماكولا، أنه ذكر في الإكمال منظور بن زبان بن سنان الفزاري هو الذي تزوج امرأة أبيه، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقتله، قال ابن الأثير: لو لم يكن مسلما لما قتله على ذلك، بل كان يقتله على الكفر. انتهى.
وقصته مع أبي بكر وعمر ثم مع الحسن بن علي تدل على أنه عاش إلى خلافة عثمان، والله أعلم.
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 1( 1995) , ج: 6- ص: 174