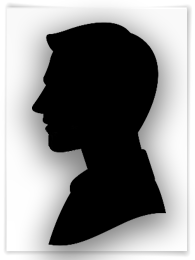مقديش
مقديش محمود بن سعيد مقديش، ابو الثناء الصفاقسي: مؤرخ. اشتهر بتونس، وزار مصر له كتب، منها (نزهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار-ط) جزآن، في مجلد، معظمه في صفاقس وعلمائها.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 7- ص: 172
مقديش محمود بن سعيد مقديش (بفتح الميم والقاف المعقدة الساكنة والدال المهملة المكسورة) الفقيه المؤرخ المشارك في علوم.
ولد بصفاقس، ونشأ في عائلة نبيهة نبيلة من أنبه بيوت صفاقس أصلها من أنشلة Ucella إحدى قرى صفاقس من الجهة الشرقية، وتربى تربية صالحة، فقضى معظم حياته بين طلب العلم والتدريس والتأليف معتمدا على نفسه، مستهينا بالصعاب والعقبات في عصامية نادرة لا يثبطها ولا يثني عزمها أحرج الظروف المادية.
تلقى العلم في مبتدأ أمره عمن أدركه ببلده من تلامذة الشيخ علي النوري كالشيخ محمد الزواري، والمحدث المفسر الشيخ رمضان بو عصيدة، وأخذ الفقه عن المقرئ الفقيه الرياضي الشيخ علي الأومي، وشاركه في شيوخه التونسيين والمصريين، والشيخ محمد الدرناوي الليبي عند إقامته بصفاقس قبل أن يستقر نهائيا بالحاضرة، ثم التحق بجامع الزيتونة، ولقي أعلامه كالشيخ قاسم المحجوب، والشيخ محمد الشحمي كبير علماء المعقولات في عصره والشيخ المحدث الفقيه الرحالة عبد الله السوسي السكتاني المغربي، وهو من شيوخ الشيخ علي الأومي، وعاقته قلة ذات اليد عن إرواء غلته من طلب العلم والإقامة بتونس، فانتقل إلى الزاوية الجمنية بجربة التي تتكفل بالإنفاق على الطلبة المقيمين بها من ريع أوقافها ومن تبرعات أهل الفضل والإحسان، وقرأ هناك مختصر الشيخ خليل بشرح الشيخ محمد الخرشي وشرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على الشيخ إبراهيم الجمني الحفيد، والشيخ أحمد بن عبد الصادق الجبالي العيادي الليبي، ثم جاور بالأزهر وهو كهل متزوج له ذرية، فأخذ العلوم الرياضية عن الشيخ أحمد الدمنهوري وحسن الجبزتي والد المؤرخ عبد الرحمن، وأخذ عن الشيخ علي الصعيدي الفقه والحديث، وقرأ على غيرهم من شيوخ الأزهر.
ولا نعلم تاريخ التحاقه بالأزهر، ومدة إقامته بمصر سوى ما ذكره في القسم الأول من تاريخه الخاص بالجغرافيا أنه كان موجودا بالإسكندرية سنة إحدى ومائتين وألف 1786/، ولعل ذلك كان لغرض التجارة وكان مدة مجاورته بالأزهر ينسخ الكتب الثمينة، ثم يئوب إلى بلده صفاقس، ويبيع ذلك إلى علماء المدينة، ويترك محصول ذلك لزوجته وذريته، ويرجع إلى القاهرة لاستكمال قراءته، وبعد تخرجه من الأزهر انتصب للتدريس مجانا ببلده، قال الشيخ ابن أبي الضياف: «ولما تضلع من العلوم رجع إلى بلده صفاقس فأفاد وأجاد ونفع العباد، وتزاحمت على منهله الوراد، وأفنى عمره في هذا المراد، وأتى بما يستجاد فتلاميذه بصفاقس أعلام وأيمة في الإسلام، وكان متخلقا بالإنصاف سمح بما عهد فيه من محمود الأوصاف».
وكان لا يقتصر في تدريسه على أسلوب الإلقاء والتلقين، بل يستخدم الأسئلة عن المشاكل والقواعد في قالب قصصي مخترع لاختبار ذكاء الطلبة، ومعرفة ما هضموه من معلومات وتروى له حكايات يرويها بعضهم إلى اليوم.
ولبث ببلده مقسما أوقاته بين التدريس والتأليف واحتراف التجارة لكسب قوته متجافيا عن الوظائف الرسمية إلى أن هاجر إلى القيروان في آخر حياته حيث توفي بها. وحمل جثمانه إلى صفاقس.
قال كراتشكوفسكي: «وأمضى معظم حياته بمسقط رأسه ولو أنه - كما يبدو - ساح كثيرا، وزار مواضع كالبندقية مثلا».
تآليفه:
1 - حاشية على العقيدة الوسطى للسنوسي ينقل فيها من كتب قليلة الوجود في عصره كالصحائف للسمرقندي مطبوعة على الحجر بتونس سنة 1321/ 1903 جزءان في مجلد واحد.
2 - حاشية على تفسير أبي السعود العمادي سماها «مطالع السعود» في تفسير أبي السعود، في 13 مجلدا بمكتبة المرحوم الشيخ محمد الصادق النيفر.
3 - شرح على المرشد المعين لابن عاشر 2 جزءان.
4 - شرح جانب من التذكرة للقرطبي، وهذا انفرد بذكره الشيخ محمد المهيري في بحثه الذي سنشير إليه.
5 - شرح على كشف الأستار للقلصادي سماه «إعانة ذوي الاستبصار على كشف الأستار عن علم حروف الغبار» وهو مختصر من كتاب القلصادي كشف الجلبات في علم الحساب، وهذا مختصر من كتابه التبصرة. وهو أول مؤلفات المترجم، توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس (مكتبة ح. ح. عبد الوهاب بخط محمد المصمودي في أواسط ذي الحجة 1283 في 312 ورقة 21 سطرا، قياس 16 * 22 سم، وتوجد منه قطعة أخرى في 50 ورقة بنفس المكتبة وأصلها من مكتبة الشيخ علي النوري.
ذكر في الخطبة قيمة علم الحساب، وحالته في عصره، والإقبال على تآليف القلصادي في القطر التونسي وخصائص كتابه «كشف الأستار» وتأليفه لهذا الشرح باقتراح من بعض الإخوان، فقال: «أما بعد فإن المآثر وإن تكاثرت، والمفاخر وإن تفاوتت، فأشرقها رفعة، وأعلاها رتبة العلم، ثم هو وإن قد تفننت أفنانه وبسقت فروعه وأغصانه، فأبينها تبيانا، وأوضحها حجة وبرهانا - بعد علم الهندسة - علم الحساب، الذي هو أول التعاليم القديمة، وأمتن العلوم المستقيمة، ثم هو مع ذلك قد صارت آثاره خفية وأسراره مطوية، ولم يبق منه إلا بقايا لا تبل الصدى، ولا تجيب النداء وإن وجد منه رسوم دارسة استولى عليها داء العجل من أصحابها ولا يمكن الإفصاح عنها من أربابها، ومع هذا فالطلب فيه حثيث شديد والباعث عليه من النفوس أكيد، فلما تعلقت همتي به، وطمحت نفسي في تحصيله رأيت تآليفه بحرا لا ساحل له وبعدا لا منتهى له، غير أن علماء العصر من إفريقية - حماها الله من كل أذية - قد أكبوا على اختصارات الإمام الأوحد الفاضل الأمجد أبي الحسن علي بن محمد بن علي القرشي الأندلسي البسطي الشهير بالقلصادي، واختاروا من اختصاراته أخصرها، ومن تواليفه أنورها، وهو أصغر كتبه حجما وأغربها علما المسمى «بكشف الأستار عن علم حروف الغبار» فكنت في جملة من أكب عليه، ولم يجعل معوله إلا عليه، فوجدته عظيم الشأن رفيع الأركان محكم البنيان، غير أنه لشدة اختصاره تكاد النفوس تيأس منه، سيما وهو - مع ذلك - مهرة لم تركب، ودرة لم تثقب، وإن تعاطاه أحد صار كأنما وقع في أجمة أسد، لم يبلغنا عنه تعليق يليق له لا يليق (؟ ) وصار كلام الناس فيه آثارها تطيرها الرياح وأحاديث ليل تمحوها به الصباح لأن ما يسطر في الدفاتر لا يستقر في الفكر، ولا تحويه الضمائر ولما تردد علي بعض الإخوان فربما صدر مني بعض إشارات لمقاصده ولمحات لمراشده، فطلبوا مني أن أقيد لهم ما سمعوه، وأرسم لهم ما فهموه، ثم إني فكرت فيما أمليت وجدته في كل لحظة يتغير فيه الأمر، ويقبل الزيادة والنقص والتغيير والتبديل تحاشيا من النقص، وطلبا للكمال المحبوب طبعا للنفس، فإذا أنا لم أجد لذاك غاية، فاضطرب عندي الأمر، سيما ولم يسبق عندي تأليف، فعزمت على محو ما كتبت، ورجعت عما أضمرت حتى رأيت كلام أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصبهاني معتذرا عن كلام استدركه عليه أنه قد وقع لي شيء، ولا أدري أوقع لك أم لا؟ .
وها أنا أخبرك به وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا الكتاب لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا الكلام أفضل ولو ترى هذا المكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص عل جملة البشر. هـ.
فأقلعت عن ذلك العزم، وعولت على إنقاذه بالفور والحزم.
6 - القول الجاوي في جواب وقفة الشيخ يحيى الشاوي في الفرق بين السبب والشرط، مخزون بالمكتبة الوطنية بتونس (مكتبة ح. ح. عبد الوهاب) بخط علي بن عون الساسي بتاريخ ذي القعدة 1242، 7 ورقات، قياس 16 * 22، وتوجد بها نسخة أخرى.
7 - وأشهر مؤلفاته هو تاريخه المعروف «بنزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» والمعروف أيضا «بدائرة مقديش» المطبوع طبعة حجرية بتونس 1321/ 1903 في جزءين، وهي طبعة سقيمة كثيرة التحريفات والأخطاء، ويوجد مخطوطا في جزءين بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 2520، ج 1، 527 وج 2، 434 ونسخ محمد المنوبي الفراتي الصفاقسي مسطرة 22 حجم 17 * 5، 23، وفي مكتبة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت بالمدينة المنورة 2 جزءان في مجلد، كتبت هذه النسخة في النصف الأول من القرن الثالث عشر نقلا عن نسخة بخط المؤلف في 250 و 350 ورقة مسطرتها 21 قياسها 17 * 24 سم، رقم 142 تاريخ (ينظر، فؤاد سيد، فهرس المخطوطات المصورة، ج 2، ص 316).
ابتدأ تأليفه في سنة 1207/ 1793 على ما ذكره عند كلامه عن مدينة وهران إذ قال: «وكثيرا ما تغلب عليها الإفرنج الأندلس من أيدي المسلمين، ثم يفتحها المسلمون منهم، وساعة تاريخ الكتاب سنة سبع ومائتين وألف بأيدي المسلمين».
ويرى المستشرق الروسي كراتشكوفسكي أنه أتم الجزء الأول من مصنفه عام 1210/ 1796.
وفي الجزء الأول عقد مقدمة مطولة للكلام عن مدن أقطار المغرب، تناول فيها جغرافيتها البشرية والاقتصادية والوصفية معتمدا على نزهة المشتاق للإدريسي، وخريدة العجائب لابن الوردي، ورحلة التجاني، وحاول أحيانا أن يقارن بين معلوماته ومشاهداته، فعتد كلامه عن الإسكندرية ومعالمها كالمجلس الذي بجنوبيها، والأسطوانة المفردة الكائنة في الركن الشمالي من هذا المجلس فقال: «ولقد وقفت عليها سنة إحدى ومائتين وألف فلم يبق من هذا المجلس أثر».وأن هذه الأسطوانة المفردة نحتها أصحاب الطمع رجاء أن يجدوا تحتها بعض الكنوز، فلما لم يجدوا شيئا ردموا ما احتفروه».
وتحدث عن القطر الأندلسي، واعتمد في ضبط الألفاظ، ووصف بعض المعالم على ابن خلكان، ثم وصف بعض جزر الأبيض المتوسط، كصقلية وسردانية، ومالطة.
ويرى المستشرق الروسي كراتشكوفسكي أن هذا القسم يغلب عليه طابع النقل إذ قال: «وتحمل المقالة الأولى لهذا التاريخ طابعا تغلب عليه الجغرافيا، إذ يمثل وصفا لأقطار المغرب والأندلس وكما يبدو من البحث الذي دونه يراع نالينو Nallino فإن الكتاب بأجمعه يغلب عليه طابع النقل والتجميع فالقسم الجغرافي مثلا يعتمد اعتمادا تاما بالتقريب على الإدريسي وابن الوردي والقزويني والتجاني».
وبعد الفراغ من المقالة الأولى الجغرافية تناول التاريخ الإسلامي من مبتدأ أمره وتعاقب دوله وإماراته بالمشرق والمغرب في إيجاز واختصار.
وهذا القسم ينتهي بانقراض الدولة الفاطمية، وظهور الدولة الأيوبية بمصر، واعتمد في تدوين أخبار هذا القسم على وفيات الأعيان لابن خلكان، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ورياض النفوس للمالكي، ومعالم الإيمان للدباغ، ورحلة التجاني، وعند كلامه عن دولة الموحدين والحفصيين رجع إلى كتاب تاريخ الدولتين للزركشي ينقل نص عباراته غالبا من غير إشارة إلى ذلك، وأحيانا ينقل من «المؤنس» لابن أبي دينار من غير تنبيه.
والجزء الثاني أرخ فيه للدولة العثمانية واحتلالها لتونس، وللدولة المرادية والحسينية إلى عهد محمود باي، وتنتهي حوادثه سنة 1238 هـ.
وقد سبق لنا أنه توفي في عام 1228 هـ، فلعل هذه الزيادة كتبت في الهامش فأضافها بعض النساخ إلى صلب الكتاب، وهذه الزيادة شديدة الاختصار، مباينة لأسلوب الكتاب.
ثم تناول تاريخ صفاقس منذ نشأتها، وأرخ لمعالمها وآثارها، وترجم لعلمائها وأدبائها وصلحائها من أقدم العهود إلى عصره، وجلب ما طم ورم من الخوارق والكرامات، وفي القسم الأخير من كتابه لا سيما عند الكلام عن الصوفية والصالحين يصل أسلوبه إلى حد كبير من الإسفاف والضعف، واعتمد أحيانا على المأثورات الشعبية كعند كلامه عن الثورة على النرمان.
ومصادره تبدو أحيانا قليلة، أو فيها بعض التخليط، فهو عند كلامه عن الدولة العثمانية نقل كثيرا من كتاب «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» للقطب النهروالي، وعزا هذا النقل إلى أبي الوليد الأزرقي، وهو متقدم بينه وبين النهروالي قرون، ولعله كانت عنده نسخة من «أخبار مكة» لأبي الوليد الأزرقي يليه «الإعلام بأعلام البيت الحرام» فلم ينتبه لهذا، وظن أن الكتاب كله للأزرقي، وفي ترجمة عيسى بن مسكين لم يعرف تاريخ وفاته حتى أخبره صديق له بذلك ويبدو أنه لم يكن مطلعا على الديباج المذهب لابن فرحون، ولو رجع إليه لوجد ترجمته وتاريخ وفاته فضلا عن الرجوع إلى أصله ترتيب المدارك للقاضي عياض، على أنه في الحوادث القريبة من عصره ذكر تفصيلات مهمة كالحرب بين تونس والبندقية قال كراتشكوفسكي: «فإن مصنفه فيما يتعلق بعرض الحوادث القريبة العهد منه يمثل أهمية كبيرة، فهو مثلا يلقي ضوءا على حوادث الحرب بين تونس والبندقية في عام 1784 - 1792».ولما ظهر كتابه صادرته الحكومة التونسية، ولعل سبب ذلك ما أبداه من تقدير لعلي باشا الأول، وهذه المصادرة جعلت نسخ الكتاب قليلة منذ القديم، قال كراتشكوفسكي: «ويبدو أنه قد مس مسائل معاصرة لأن حكومة تونس صادرته على الفور».
المصادر والمراجع:
- إتحاف أهل الزمان 7/ 85، 86.
- الأعلام 7/ 172 (ط 5/).
- إيضاح المكنون 2/ 637.
- سياسة حمودة باشا في تونس د. رشاد الإمام (تونس 1980) ص 19، 120.
- شجرة النور الزكية 366.
- معجم المطبوعات 1209.
- معجم المؤلفين 12/ 167 نقلا عن فهرس دار الكتب المصرية 5/ 387.
- هدية العارفين 2/ 417، 418.
- كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب (الترجمة العربية) 2/ 768.
- المؤرخون التونسيون (بالفرنسية) ص 274، 284.
- مجلة الثريا شعبان /1363 جويلية 1944 ص 109 بقلم الشيخ محمد المهيري مفتي صفاقس في ذلك التاريخ أحمد الطويلي: مجلة الهداية ع 6 س 10 رمضان شوال ذو القعدة /1403 جويلية وأوت 1983 ص 28 - 34.
دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان-ط 2( 1994) , ج: 4- ص: 356
مقديش محمود بن محمود بن سعيد مقديش، الفقيه الرياضي، أخذ عن والده، وعن غيره.
درس مدة قليلة بصفاقس الفلك، والمنطق، وقرأ عليه محمود السيالة، وعبد السلام الشرفي، ثم انتقل إلى تونس، واحترف التجارة، واتصل بالوزير يوسف صاحب الطابع، وكان يقوم لتلقيه على عادته مع العلماء، ثم تقدم وكيلا على عشر الزيت وشرائه للدولة، ونالته بسبب ذلك محنة على يد الوزير محمد شاكير صاحب الطابع، فارتحل إلى المشرق، وأقام بمصر مدة فأخذ عنه الشيخ محمد عليش وغيره، وتوفي بجدة.
له تأليف في الفلك يسمى سلم السعادة لمعرفة سمت القبلة وأوقات العبادة، شرحه تلميذه محمود السيالة بشرح سماه لولب السيادة لصعود سلم السعادة، وهذا الكتاب رأيت أوراقا يسيرة منه مع تعليقات بخط محمود السيالة، موجودة بالمكتبة الوطنية بتونس، وأصلها من مكتبة الشيخ علي النوري أوله: «سبحان من أبدع ما اخترع، وأتقن بحكمته ما صنع، رفع السموات بقدرته، وخضع كل شيء لجلال عظمته».
وجعله مشتملا على مقدمة وستة وعشرين بابا.
المصادر والمراجع:
- إتحاف أهل الزمان 8/ 24.
- شجرة النور الزكية 335.
- فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية، ص 106.
دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان-ط 2( 1994) , ج: 4- ص: 364