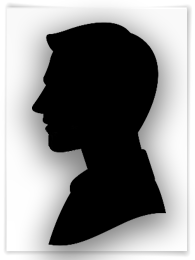المبرد
المبرد محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالي الازدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد: امام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والاخبار. مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه (الكامل-ط) و (المذكر والمؤنث-خ) و (المقتضب-خ) و (التعازي والمراثي-خ) و (شرح لامية العرب-ط) مع شرح الزمخشري، و (إعراب القرآن) و (طبقات النحاة البصريين) و (نسب عدنان وقحطان-ط) رسالة. و (المقرب-خ) قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشددة عند الاكثر وبعضهم يكسر.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 7- ص: 144
المبرد النحوي اسمه محمد بن يزيد.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 9- ص: 44
أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ابن عمير الثمالي الزدري البصري المعروف بالمبرد
توفي سنة 284 ببغداد.
روى عن الرضا عليه السلام قال سئل علي بن موسى الرضا أيكلف الله العباد ما لا يطيقون فقال هو أعدل من ذلك قيل له فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون قال هم أعجز من ذلك.
عن رياض العلماء في باب الألقاب: الإمام النحوي اللغوي الفاضل الإمامي المقبول عند الفريقين وإنما سمي المبرد لأنه لما سأله المازني عن دقيق أصول الدين وعويص أمر الإمامة وأجاب بأحسن جواب قال له قم فأنت المبرد أي المثبت أمر الإمامة والعقائد الحقة.
ومن شعره قوله:
وإني للباس على المقت والأذى | بني العم منهم كاشح وحسود |
أذب وأرمي بالحصى من ورائهم | وابدأ بالحسنى لهم وأعود |
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 10- ص: 98
المبرد النحوي محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد إمام العربية ببغداذ في زمانه، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني وغيرهما، وروى عنه إسماعيل الصفار ولزمه مدة وإبراهيم بن نفطويه ومحمد بن يحيى الصولي وجماعة، وكان فصيحا بليغا مفوها ثقة أخباريا علامة صاحب نوادر وظرافة، وكان جميلا وسيما لا سيما في صباه، وله تصانيف مشهورة منها كتاب الكامل، قال القاضي الفاضل: طالعته سبعين مرة وكل مرة أزداد منه فوائد، والمقتضب والروضة، ولما صنف المازني كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب فقال له: قم فأنت المبرد -بكسر الراء- أي المثبت للحق، فغيره الكوفيون وفتحوا الراء، توفي آخر سنة خمس وثمانين ومائتين وعاش خمسا وسبعين سنة ولم يخلف مثله، ذكر القاضي شمس الدين ابن خلكان في ترجمة المبرد أنه رأى مناما له علاقة بالمبرد وهو منام غريب عجيب أودعه تاريخه، وكانت العداوة قد اشتهرت بين المبرد وثعلب حتى نظم الناس ذلك في أشعارهم فقال بعض الشعراء:
كفى حزنا أنا جميعا ببلدة | ويجمعنا في أرض برشهر مشهد |
وكل لكل مخلص الود وامق | ولكننا في جانب عنه مفرد |
نروح ونغدو لا تزاور بيننا | وليس بمضروب لنا عنه موعد |
فأبداننا في بلدة والتقاؤنا | عسير كأنا ثعلب والمبرد |
يوم كحر الشوق في القلب والحشا | على أنه منه أحر وأوقد |
ظللت به عند المبرد قاعدا | فما زلت من ألفاظه أتبرد |
حبذا ماء العناقيـ | ـد بريق الغانيات |
بهما ينبت لحمي | ودمي أي نبات |
أيها الطالب شيئا | من لذيذ الشهوات |
كل بماء المزن تفا | ح خدود ناعمات |
محمد بن يزيد الواسطي، توفي سنة تسعين ومائة في قول.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 5- ص: 0
المبرد الإمام النحوي اسمه محمد بن يزيد.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 25- ص: 0
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن غسان بن سليمان بن سعد بن عبد الله بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم: وهو ثمالة، ثم ينتهي إلى الأسد بن الغوث، وهو الأزد، فهو الثمالي الأزدي البصري أبو العباس النحوي اللغوي الأديب.
ولد بالبصرة يوم الاثنين غداة عيد الأضحى سنة عشر ومائتين، وأخذ عن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازني، وقرأ عليهما «كتاب سيبويه» وأخذ عن أبي حاتم السجستاني، وأخذ عنه أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ونفطويه وأبو علي الطوماري وغيرهم. وكان إمام العربية ببغداد، وإليه انتهى علمها بعد طبقة الجرمي والمازني، وكان حسن المحاضرة فصيحا بليغا مليح الأخبار ثقة فيما يرويه كثير النوادر فيه ظرافة ولباقة، وكان الإمام إسماعيل القاضي يقول: ما رأى محمد بن يزيد مثل نفسه.
وإنما لقب بالمبرد لأنه لما صنف المازني «كتاب الألف واللام» سأله عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب، فقال له المازني: قم فأنت المبرد- بكسر الراء- أي المثبت للحق، فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء.
وقال السيرافي: سمعت أبا بكر ابن مجاهد يقول: ما رأيت أحسن جوابا من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول لمتقدم، ولقد فاتني منه علم كثير لقضاء ذمام ثعلب.
وقال السيرافي أيضا: سمعت نفطويه يقول: ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد من المبرد وأبي العباس ابن الفرات.
وقال المفجع البصري: كان المبرد لكثرة حفظه للغة وغريبها يتهم بالوضع فيها، فتواضعنا على مسألة نسأله عنها لا أصل لها لننظر ماذا يجيب، وكنا قبل ذلك تمارينا في عروض بيت الشاعر:
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا | حنانيك بعض الشر أهون من بعض |
كأن سنامها حشي القبعضا
قال فقلت لأصحابي: ترون الجواب والشاهد، فإن كان صحيحا فهو عجب وإن كان مختلقا على البديهة فهو أعجب.
وحكى ابن السراج قال: كان بين المبرد وثعلب ما يكون بين المتعاصرين من المنافرة، واشتهر ذلك حتى قال بعضهم:
كفى حزنا أنا جميعا ببلدة | ويجمعنا في أرضها شر مشهد |
وكل لكل مخلص الود وامق | ولكنه في جانب عنه مفرد |
نروح ونغدو لا تزاور بيننا | وليس بمضروب لنا يوم موعد |
فأبداننا في بلدة والتقاؤنا | عسير كلقيا ثعلب والمبرد |
رأيت محمد بن يزيد يسمو | الى الخيرات في جاه وقدر |
جليس خلائف وغذي ملك | وأعلم من رأيت بكل أمر |
وفتيانية الظرفاء فيه | وأبهة الكبير بغير كبر |
فينثر إن أجال الفكر درا | وينثر لؤلؤا من غير فكر |
وكان الشعر قد أودى فأحيا | أبو العباس داثر كل شعر |
وقالوا ثعلب رجل عليم | وأين النجم من شمس وبدر |
وقالوا ثعلب يفتي ويملي | وأين الثعلبان من الهزبر |
وهذا في مقالك مستحيل | تشبه جدولا وشلا ببحر |
أيا طالب العلم لا تجهلن | وعذ بالمبرد أو ثعلب |
تجد عند هذين علم الورى | فلا تك كالجمل الأجرب |
علوم الخلائق مقرونة | بهذين في الشرق والمغرب |
بلغني أنك تنصرف من مجلسنا فتصير إلى مواضع المجانين والمعالجين فما معنى ذلك؟ فقلت: أعزك الله تعالى، إن لهم طرائف من الكلام، قال: فأخبرني بأعجب ما رأيت من المجانين، قال فقلت: صرت يوما إليهم فمررت على شيخ منهم وهو جالس على حصير قصب فجاوزته الى غيره، فقال: سبحان الله تعالى أين السلام؟
من المجنون أنا أو أنت؟ فاستحييت منه وقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال: لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد، على أنا نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العذر لأنه كان يقال إن للداخل على القوم دهشة، اجلس أعزك الله تعالى عندنا، وأومى إلى موضع من الحصير، فجلست إلى ناحية منه أسترعي مخاطبته، فقال لي وقد رأى معي محبرتي: أرى معك آلة رجلين أرجو أن لا تكون أحدهما: أصحاب الحديث الاغثاث أو الأدباء أصحاب النحو والشعر، قلت:
الأدباء، قال: أتعرف أبا عثمان المازني؟ قلت: نعم، قال: أتعرف الذي يقول فيه:
وفتى من مازن | استاذ أهل البصره |
امه معرفة | وأبوه نكره |
حبذا ماء العناقي | د بريق الغانيات |
بهما ينبت لحمي | ودمي أي نبات |
أيها الطالب أشهى | من لذيذ الشهوات |
كل بماء المزن تفا | ح خدود الفتيات |
يقولون هو من الأزد، أزد شنوءة ثم من ثمالة، قال أتعرف القائل في ذلك:
سألنا عن ثمالة كل حي | فقال القائلون ومن ثماله |
فقلت محمد بن يزيد منهم | فقالوا زدتنا بهم جهاله |
فقال لي المبرد خل قومي | فقومي معشر فيهم نذاله |
محمد، قال: فالأب، قلت: يزيد، قال: قبحك الله أحوجتني إلى الاعتذار مما قدمت ذكره، ثم وثب وبسط يده فصافحني، فرأيت القيد في رجله فأمنت غائلته، فقال: يا أبا العباس صن نفسك من الدخول في هذه المواضع، فليس يتهيأ في كل وقت أن تصادف مثلي على مثل حالتي، ثم قال: أنت المبرد، أنت المبرد، وجعل يصفق وانقلبت عيناه واحمرت وتغيرت حالته، فبادرت مسرعا خوف أن تبدر إلي منه بادرة، وقبلت منه والله نصحه، ولم أعاود بعدها الى تلك المواضع أبدا.
وقال الزجاج: لما قدم المبرد بغداد جئت لأناظره، وكنت أقرأ على أبي العباس ثعلب، فعزمت على إعناته، فلما باحثته ألجمني بالحجة وطالبني بالعلة وألزمني الزامات لم أهتد إليها، فاستيقنت فضله واسترجحت عقله وأخذت في ملازمته.
وكان المبرد يحب الاجتماع بأبي العباس ثعلب للمناظرة وثعلب يكره ذلك، حكى أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي، وكان صديقهما، قال: قلت لأبي عبد الله الدينوري ختن ثعلب: لم يأبى ثعلب الاجتماع بالمبرد؟ فقال: لأن المبرد حسن العبارة حلو الاشارة، فصيح اللسان ظاهر البيان، وثعلب مذهبه مذهب المعلمين، فاذا اجتمعا في محفل حكم للمبرد على الظاهر إلى أن يعرف بالباطن.
وحكي أن بعض الأكابر من بني طاهر سأل أبا العباس ثعلبا أن يكتب له مصحفا على مذهب أهل التحقيق، فكتب والضحى بالياء، ومذهب الكوفيين أنه إذا كان كلمة من هذا النحو أولها ضمة أو كسرة كتبت بالياء، وإن كانت من ذوات الواو فالبصريون يكتبون بالألف، فنظر المبرد في ذلك المصحف فقال: ينبغي أن يكتب والضحا بالألف لأنه من ذوات الواو، فجمع ابن طاهر بينهما فقال المبرد لثعلب: لم كتبت
والضحى بالياء؟ فقال: لضمة أوله، فقال له: ولم إذ ضم أوله وهو من ذوات الواو تكتبه بالياء؟ فقال: لأن الضمة تشبه الواو وما أوله واو يكون آخره ياء فتوهموا أن أوله واو، فقال المبرد: أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة.
ولبعضهم في مدح المبرد:
وإذا يقال من الفتى كل الفتى | والشيخ والكهل الكريم العنصر |
والمستضاء بعلمه وبرأيه | وبعقله قلت ابن عبد الأكبر |
وأنت الذي لا يبلغ المدح وصفه | وإن أطنب المداح مع كل مطنب |
رأيتك والفتح بن خاقان راكبا | فأنت عديل الفتح في كل موكب |
وكان أمير المؤمنين إذا رنا | إليك يطيل الفكر بعد التعجب |
وأوتيت علما لا يحيط بكنهه | علوم بني الدنيا ولا علم ثعلب |
يروح إليك الناس حتى كأنهم | ببابك في أعلى منى والمحصب |
ذهب المبرد وانقضت أيامه | وليذهبن إثر المبرد ثعلب |
بيت من الآداب أضحى نصفه | خربا وباقي النصف منه سيخرب |
فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا | للدهر أنفسكم على ما يسلب |
وتزودوا من ثعلب فبكاس ما | شرب المبرد عن قريب يشرب |
أوصيكم أن تكتبوا أنفاسه | إن كانت الأنفاس مما يكتب |
رب من يعنيه حالي | وهو لا يجري ببالي |
قلبه ملآن مني | وفؤادي منه خالي |
والمقتضب في النحو وهو أكبر مصنفاته وأنفسها، إلا أنه لم ينتفع به أحد. قال أبو علي الفارسي: نظرت في «المقتضب» فما انتفعت منه بشيء إلا بمسألة واحدة وهي وقوع إذا جوابا للشرط في قوله تعالى: {وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون} ويزعمون أن سبب عدم الانتفاع به أن هذا الكتاب أخذه ابن الراوندي الزنديق عن المبرد، وتناوله الناس من يد ابن الراوندي فكأنه عاد عليه شؤمه فلا يكاد ينتفع به. ومن تصانيفه أيضا الروضة. والمدخل في كتاب سيبويه. وكتاب الاشتقاق. وكتاب المقصور والممدود. وكتاب المذكر والمؤنث. ومعاني القرآن ويعرف بالكتاب التام. وكتاب الخط والهجاء. وكتاب الأنواء والأزمنة. وكتاب احتجاج القراء وإعراب القرآن. وكتاب الحروف في معاني القرآن إلى سورة طه.
وكتاب صفات الله جل وعلا. وكتاب العبارة عن أسماء الله تعالى. وشرح شواهد كتاب سيبويه. وكتاب الرد على سيبويه. ومعنى كتاب الأوسط للأخفش. وكتاب الزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه. ومعنى كتاب سيبويه. وكتاب الحروف. والمدخل في النحو. وكتاب الإعراب. وكتاب التصريف. وكتاب العروض. وكتاب القوافي.
وكتاب البلاغة. والرسالة الكاملة. والجامع لم يتم. وقواعد الشعر. وكتاب ضرورة الشعر. وكتاب الفاضل والمفضول. والرياض المونقة. وكتاب الوشي. وكتاب شرح كلام العرب وتخليص ألفاظها ومزاوجة كلامها وتقريب معانيها. وكتاب الحث على الأدب والصدق. وأدب الجليس. وكتاب الناطق. وكتاب الممادح والمقابح.
وكتاب أسماء الدواهي عند العرب. وكتاب ما اتفقت الفاظه واختلفت معانيه في القرآن. وكتاب التعازي. وكتاب قحطان وعدنان. وطبقات النحويين البصريين وأخبارهم؛ وغير ذلك.
دار الغرب الإسلامي - بيروت-ط 0( 1993) , ج: 6- ص: 2678
المبرد إمام، النحو، أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، البصري، النحوي الأخباري، صاحب، ’’الكامل’’.
أخذ عن: أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني.
وعنه: أبو بكر الخرائطي، ونفطويه، وأبو سهل القطان، وإسماعيل الصفار، والصولي، وأحمد بن مروان الدينوري، وعدة.
وكان إماما، علامة، جميلا، وسيما، فصيحا، مفوها، موثقا صاحب نوادر وطرف.
قال ابن حماد النحوي: كان ثعلب أعلم باللغة، وبنفس النحو من المبرد، وكان المبرد أكثر تفننا في جميع العلوم من ثعلب.
قلت: له تصانيف كثيرة، يقال: إن المازني أعجبه جوابه: فقال له: قم فأنت المبرد، أي: المثبت للحق، ثم غلب عليه: بفتح الراء.
وكان آية في النحو، كان إسماعيل القاضي يقول: ما رأى المبرد مثل نفسه.
مات المبرد: في أول سنة ست وثمانين ومائتين.
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 10- ص: 545
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد بن عبد الله بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم- وهو ثمالة- بن أحجن بن كعب بن الحارث ابن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن أزد بن الغوث أبو العباس الأزدي الثمالي الم شيخ أهل النحو، وحافظ علم العربية.
ولد يوم الاثنين ليلة الأضحى سنة عشر ومائتين. وقيل: سنة سبع ومائتين.
وهو من أهل البصرة وسكن بغداد.
أخذ عن أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني وغيرهما من الأدباء.
روى عنه: إسماعيل بن محمد الصفار، ونفطويه، ومحمد بن أبي الأزهر، وأبو بكر الصولي، وأبو عبد الله الحكيمي، وأبو سهل بن زياد، وجماعة يتسع ذكرهم.
وكان عالما فاضلا، فصيحا بليغا مفوها، ثقة أخباريا، موثقا به في الرواية، حسن المحاضرة، علامة صاحب نوادر وظرافة، وكان جميلا لا سيما في صباه.
قال السيرافي في «طبقات النحاة البصريين»: وهو من ثمالة- يعني بضم التاء المثلثة- قبيلة من الأزد، وفيه يقول عبد الصمد بن المعذل هاجيا له:
سألت عن ثمالة كل حي | فقال القائلون ومن ثماله |
فقلت محمد بن يزيد منهم | فقالوا زدتنا بهم جهاله |
ولما صنف المازني كتاب «الألف واللام»، سأل المبرد عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب، فقال له: قم فأنت المبرد- بكسر الراء- أي المثبت للحق، فغيره الكوفيون، وفتحوا الراء.
قال نفطويه: ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد منه. مات المبرد
ببغداد يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ست وثمانين ومائتين، وصلى عليه القاضي أبو محمد يوسف بن يعقوب.
وله من التصانيف كتاب «معاني القرآن» ويعرف «بالكتاب التام»، وكتاب «الحروف في معاني القرآن إلى سورة طه» وكتاب «إعراب القرآن»، وكتاب «احتجاج القراء» وكتاب «معاني صفات الله تعالى» وكتاب «الكامل» وكتاب «الروضة»، وكتاب «المقتضب»، وكتاب «الاشتقاق»، وكتاب «التعازي»، وكتاب «الأنواء والأزمنة»، وكتاب «القوافي»، وكتاب «الخط والهجاء»، وكتاب «المدخل» إلى كتاب سيبويه، وكتاب «الرد على سيبويه» وكتاب «المقصور والممدود»، وكتاب «المذكر والمؤنث»، وكتاب «شرح شواهد كتاب سيبويه»، وكتاب «ضرورة الشعر»، وكتاب «نسيب عدنان وقحطان»، وكتاب «أدب الجليس»، وكتاب «العروض»، وكتاب «الممادح والمقابح»، وكتاب «الرياض المونقة»، وكتاب «أسماء الدواهي»، وكتاب «الجامع» لم يتمه، وكتاب «الوشى»، وكتاب «معنى كتاب سيبويه»، وكتاب «معنى كتاب الأخفش الأوسط»، وكتاب «شرح كلام العرب وتخليص ألفاظها ومزاوجة كلامها وتقريب معانيها»، وكتاب «ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه في القرآن»، وكتاب «طبقات النحويين البصريين» وغير ذلك.
قال السيرافي: وكان بينه وبين ثعلب في المنافرة ما لا خفاء به، وأكثر أهل التحصيل يفضلونه.
ولاشتهار عداوتهما نظمهما الشعراء فقال بعضهم:
كفى حزنا أنا جميعا ببلدة | ويجمعنا في أرض برشهر مشهد |
وكل لكل مخلص الود وامق | ولكننا في جانب عنه نفرد |
نروح ونغدو لا تزاور بيننا | وليس بمضروب لنا عنه موعد |
فأبداننا في بلدة والتقاؤنا | عسير كأننا ثعلب والمبرد |
رأيت محمد بن يزيد يسمو | إلى الخيرات في جاه وقدر |
جليس خلائف وغذي ملك | وأعلم من رأيت بكل أمر |
وينثر إن أجال الفكر درا | وينثر لؤلؤا من غير فكر |
وكان الشعر قد أودى فأحيا | أبو العباس دائر كل شعر |
وقالوا ثعلب رجل عليهم | وأين النجم من شمس وبدر |
وقالوا ثعلب يفتى ويملي | وأين الثعلبان من الهزبر |
وهذا في مقالك مستحيل | تشبه جدولا وشلا ببحر |
أيا طالب العلم لا تجهلن | وعذ بالمبرد أو ثعلب |
تجد عند هذين علم الورى | فلا تك كالجمل الأجرب |
علوم الخلائق مقرونة | بهذين بالشرق والمغرب |
حبذا ماء العناقي | د بريق الغانيات |
بهما ينبت لحمي | ودمي أي نبات |
أيها الطالب شيئا | من لذيذ الشهوات |
كل بماء المزن تفا | ح خدود ناعمات |
وذكره شيخنا في «طبقات اللغويين والنحاة».
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 0( 0000) , ج: 2- ص: 269
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد كان فصيحا بليغا وثقة وعارفا أخذ العربية عن
الكسائي الأزدي وعن أبي حاتم السجستاني وله التواليف النافعة في الأدب وصنف في التفسير معاني القرآن وإعراب القرآن
وكانت وفاته سنة ست أو خمس وثمانين ومائتين
كذا في تاريخ مرآة الجنان
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 41
المبرد
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. م سنة 285 هـ رحمه الله تعالى.
علامة في الأدب والتاريخ، والتصانيف منها: الكامل في التاريخ.
له: 1 - نسب عدنان وقحطان. طبع عام 1354 هـ. في الهند.
ثم أعيد طبعه عام 1404 هـ بتحقيق الأستاذ العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي على نفقة آل ثاني في قطر.
2 - كتاب أسماء الدواهي عند العرب.
دار الرشد، الرياض-ط 1( 1987) , ج: 1- ص: 70
المبرد
وأما أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي المعروف بالمبرد - والثمالي منسوب إلى ثمالة بن مسلم بن كعب بن الحارث بن كعب - فكان شيخ أهل النحو والعربية، وإليه انتهى علمها بعد طبقة أبي عمر الجرمي، وأبي عثمان المازني.
وكان من أهل البصرة، وأخذ عن أبي عمر الجرمي، وأبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني، وغيرهم من أهل العربية.
وكان يعول على المازني. ويقال: إنه بدأ بقراءة كتاب سيبويه على الجرمي، وختمه على المازني.
وكان إسماعيل القاضي - وهو أقدم مولداً منه - يقول: ما رأى محمد بن يزيد مثل نفسه.
وأخذ عنه الصولي ونفطويه النحوي، وأبو علي الطوماري، وجماعة كثيرة.
وكان حسن المحاضرة، مليح الأخبار، كثر النوادر، قال أبو سعيد السيرافي: سمعت أبا بكر بن مجاهد يقول: ما رأيت أحسن جواباً من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول لمتقدم. وسمعته يقول: لقد فاتني منه علم كثير لقضاء زمام ثعلب.
وقال السيرافي: وسمعت نفطويه يقول: ما رأيت أحفظ لأخبار بغير أسانيد منه ومن أبي العباس بن الفرات.
وقال أبو سعيد: وقد نظر في كتاب سيبويه في عصره جماعة لم يكن لهم كنباهته، مثل أبي ذكوان القاسم بن إسماعيل، ومثل أبي علي بن ذكوان، ومثل أبي يعلى بن أبي زرعة من أصحاب المازني، ومثل أبي جعفر بن محمد الطبري، ومثل أبي عثمان الأشتانداني، وأبي بكر بن إسماعيل المعروف بمبرمان وغيرهم.
وقال أبو عبد الله المفجع: كان المبرد لعظم حفظه اللغة واتساعه يتهم، فتوافقنا على مسألة لا أصل لها نسأله عنها، لننظر كيف يجيب، وكنا قبل ذلك تمارينا في عروض بيت الشاعر:
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا | حنانيك، بعض الشر أهون من بعض |
#كأن سنامها حُشِيَ القبعضا قال: فقلت لأصحابه: ترون الجواب والشاهد؛ إن كان صحيحاً فهو عجيب، وإن كان اختلق الجواب في الحال فهو أعجب.
وقال أبو بكر بن الأزهر: حدثني محمد بن يزيد المبرد، قال: قال لي المازني: بلغني أنك تنصرف من مجلسنا فتصير إلى مواضع المجانين والمعالجين، فما معنى ذلك؟ قال: فقلت: أعزك الله تعالى! إن لهم طرائف من الكلام، قال: فأخبرني بأعجب ما رأيته من المجانين، قال: فقلت: دخلت يوماً إليهم، فمررت على شيخ منهم وهو جالس على حصير قصب، فجاورته إلى غيره، فقال: سبحان الله تعالى! أين السلام! مَن المجنون؟ أنا أم أنت! فاستحييت منه، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد؛ على أنا نصرف سوء أدبك على أحسن جهاته من العذر؛ لأنه كان يقال: إن للداخل على القوم دهشة؛ اجلس أعزك الله تعالى عندنا! وأومأ إلى موضع من الحصير، فقعدت ناحية استجلب مخاطبته، فقال لي: وقد رأى معي مجبرة: أرى معك آلة رجلين، أرجو أن تكون أحدهما، تجالس أصحاب الحديث الأخفاف، أو الأدباء أصحاب النحو والشعر؟ قلت: الأدباء، قال: أتعرف أبا عثمان المازني؟ قلت: نعم، قال: أتعرف الذي يقول فيه:
وفتى من مازن | ساد أهل البصره |
أمه معرفة | وأبوه نكره |
حبذا ماء العناقيـ | ـد بريق الغانيات |
بهما ينبت لحمي | ودمي أي نبات |
أيها الطالب أشهى | من لذيذ الشهوات |
كل بماء المزن تفا | ح خدود الفتيات |
سألنا عن ثمالة كل حي | فقال القائلون: ومن ثماله |
فقلت: محمد بن يزيد منهم | فقالوا زدتنا بهم جهاله |
فقال لي المبرد: خل قومي | فقومي معشر فيهم نذاله |
ويروى أن أبا العباس ثعلب تخلف أبا العباس المبرد بكلام قبيح، فبلغ ذلك المبرد، فأنشد:
رب من يعنيه حالي | وهو لا يجزي ببالي |
قلبه ملآن مني | وفؤادي منه خالِ |
وحكى أبو بكر بن السراج عن محمد بن خلف، قال: كان بين أبي العباس المبرد وأبي العباس ثعلب من المنافرة ما لا خفاء به؛ ولكن أهل التحصيل يفضلون المبرد على ثعلب، وفي ذلك يقول أحمد بن عبد السلام:
رأيت محمد بن يزيد يسمو | إلى الخيرات في جاه وقدر |
جليس خلائف وغذى ملك | وأعلم من رأيت بكل أمر |
وكان الشعر قد أودى فأحيا | أبو العباس دارس كل شعر |
وقالوا ثعلب رجلٌ عليم | وأين النجم من شمس وبدر! |
وقالوا ثعلبٌ يفتي ويملي | وأين الثعلبان من الهزبر! |
ولبعضهم في مدح المبرد:
وأنت الذي لا يبلغ الوصف مدحه | وإن أطنب المداح في كل مطنبِ |
رأيتك والفتح بن خاقان راكباً | وأنت عديل الفتح في كل موكب |
وكان أمير المؤمنين إذا رنا | إليك يطيل الفكر بعد التعجب |
وأوتيت علماً لا يحيط بكنهه | علوم بني الدنيا ولا علم لتعجب |
يروح إليك الناس حتى كأنهم | ببابك في أعلى مني والمحصب. |
ولبعضهم في مدحه:
وإذا يقال: من الفتى كل الفتي | والشيخ والكهل الكريم العنصر |
والمستضاء بعلمه وبرأيه | وبعقله؟ قلتُ: ابن عبد الأكبر |
وصنف كتباً كثيرة، ومن أكبرها كتاب المقتضب؛ وهو نفيس؛ إلا أنه قلما يشتغل به أو ينتفع به؛ قال أبو علي: نظرت في كتاب المقتضب فما انتفعت منه بشيء إلا بمسألة واحدة؛ وهي وقوع إذا جواباً للشرط في قوله تعالى: (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون).
قال المصنف: وكان السر في عدم الانتفاع به، أن أبا العباس لما صنف هذا الكتاب، أخذه عن ابن الراوندي المشهور بالزندقة وفساد الاعتقاد، وأخذه الناس من يد ابن الراوندي وكتبوه منه؛ فكأنه عاد عليه شؤمه فلا يكاد ينتفع به.
وقال أبو بكر بن السراج: كان مولد المبرد سنة عشر ومائتين، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين.
وكذلك قال محمد بن العباس: قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع: مات محمد بن يزيد المبرد في شوال سنة خمس وثمانين ومائتين، في خلافة المعتضد بالله تعالى.
ولثعلب في المبرد حين مات:
ذهب المبرد وانقضت أيامه | وليذهبن مع المبرد ثعلبا. |
بيتٌ من الآداب أضحى نصفه | خرباً وباقي النصف منه سيخرب |
فتزدوا من ثعلب فبكأس ما | شرب المبرد عن قريب يثرب |
أوصيكمو أن تكتبوا أنفاسه | إن كانت الأنفاس مما يكتب |
مكتبة المنار، الزرقاء - الأردن-ط 3( 1985) , ج: 1- ص: 164
دار الفكر العربي-ط 1( 1998) , ج: 1- ص: 193
مطبعة المعارف - بغداد-ط 1( 1959) , ج: 1- ص: 148
أبو العباس المبرد
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد
بن عبد الله بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله ابن عامر بن مالك بن عوف بن أسلم، وهو ثمالة من أزد.
وإنما نسبته لطعن بعض الناس في نسبه.
مولده البصرة.
وابتدأ بقراءة ’’ الكتاب ’’ على الجرمي فقرأ بعضه، وكمل باقيه على المازني.
واشتهر أمره ببغداد بعد خمول، وذاك أن المتوكل استحضره إلى
سر من رأى، لأنه قرأ يوماً والفتح بن خاقان بحضرته: (وما يشعركم إنها)، فقال الفتح: يا سيدي (أنها)، فقال: ما أعرفها إلا بالكسر. فأمر بإحضار المبرد، فحضر، وورد إلى الفتح بن خاقان فسلم عليه، فذكر له ما استحضره له، فوافق الفتح، فرفع مجلسه، ثم أدخل بعد ذلك المتوكل، فصوب قراءته، وذكر جواز الوجهين جميعاً.
ثم سار إلى بغداد، وتكلم في جامع المنصور، وأخذ يجيب عن مسائل يفهم أنه قد سئل عنها، فقام الزجاج من حلقة أحمد بن يحيى ثعلب إليه، وألقى عليه عدة مسائل، فأجاب في جميعها، فلزمه وترك مجلس ثعلب.
فسمعت شيخنا أبا القاسم الدقيقي، رحمه الله تعالى، يقول: ما زال ’’ الكتاب ’’ مطرحاً ببغداد، لا ينظر فيه، ولا يعول عليه، حتى ورد المبرد إليها، فبينه، على علو قدره وشرفه، ورغب الناس فيه، فكان لا يمكن أحدا من قراءته عليه حتى يقرأه على الزجاج، ويصححه.
قال المعروف باليوسفي: كنت يوماً قاعداً عند أبي حاتم السجستاني، إذ أتاه شاب من نيسابور، فقال له: يا أبا حاتم، إني قد قدمت إلى بلدكم، وهو محل العلم والعلماء، وأنت شيخ هذه المدينة، وقد أحببت أن أقرأ عليك ’’كتاب سيبويه’’. فقال سهل بن محمد: الدين النصيحة، إن أردت أن تنتفع بالقراءة فاقرأ على هذا الغلام. يعني محمد بن يزيد، فعجبت من ذلك.
وكان المبرد يقول الشعر، ومن شعره، ما أنشدنيه أبي محمد بن مسعر، رحمه الله، قال: أنشدني أحمد بن محمد الأنباري، ويعرف بالحميري، القارئ بمعرة النعمان، قال: أنشدنا داود بن الهيثم التنوخي، قال: أنشدنا المبرد لنفسه:
شربت من فضةٍ ومن ذهب | أسرع في فضتي وفي ذهبي |
فصرت عطلاً لم تبق حليته | علي من حليةٍ سوى الأدب |
والأدب الحلية النفيسة لا | زخرفةٌ من زخارف النسب |
قال: كنت عليلاً.
فأطرق أبو العباس ساعة، ثم أنشأ يقول:
فلو كان المريض يزيد حسناً | كما تزداد أنت على السقام |
لما عيد المريض إذا وعدت | لنا الشكوى من النعم العظام |
أبي العباس إلى أبي شراعة فقال: يا أبا شراعة، أنشدني أبياتك في آل رياح.
فقال له أبو شراعة القيسي: بالله يا أبا العباس فيمن تنتمي اليوم؟
فقال: في ثمالة.
قال: بالله يا أبا العباس هلا اخترت لنفسك نسبا هو أرفع من هذا!
فقال له المبرد: دعنا من هزلك، وأنشدنا أبياتك في آل رياح.
فأنشده ونحن عنده:
بني رياحٍ أعاد الله نعمتكم | خير المعاد وأسقى ربعكم ديما |
فكم بها من فتىً حلوٍ شمائله | يكاد ينهل من أعطافه كرما |
لم يلبسوا نعمة لله مذ خلقوا | إلا تلبسها إخوانهم نعما |
وأملى كتبا كثيرة: ’’ المدخل إلى علم سيبويهٍ ’’ و ’’ المقتضب ’’، و ’’ الكامل ’’، و ’’ الجامع ’’.
وله ’’ كتاب صغير ’’ يرد على سيبويهٍ نحو أربعمائة مسألة.
قال الزجاج: رجع عن أكثرها إلى قول سيبويهٍ.
قال: وفيها ما يلزم سيبويهٍ على مذهبه نحو أربعين مسألة.
والذي أعتقد في ذلك أن سيبويهٍ لا يتعلق به شيء مما ذكر عنه، لأنه يروي عن العرب قول الشاعر:
ولم يرتفق والناس محتضرونه جميعاً | .......................... |
أبا ابن التارك البكري بشرٍ | عليه الطير ترقبه وقوعا |
وأكبر ظني أن أبا علي الفارسي إنما عدل عن إقراء كتبه، والتكثر بالرواية عنه، بهذه الحال.
ويروى عنه أنه قال: ما أدري، لم لقب ذلك الكتاب بالكامل!
ومن كتبه كتاب ’’الروضة’’، في من أشعار المحدثين، وله ’’كتاب في القوافي’’، و ’’كتاب في الخط والهجاء’’، و ’’كتاب في القرآن’’، وكتاب ’’اختيار الشعر’’، وكتاب لقبه ’’الكافي’’ فيه أخبارٌ، لا أدري لم اختار له هذا اللقب، من أي شيء يكفي؟.
وكان البحتري صديقا له، وكان - فيما ذكر - يجتمعان على الشراب.
ويروي أن البحتري كتب إليه بهذه الأبيات:
يوم سبتٍ وعندنا ما يكفي الحر | طعاماً والورد منا قريب |
ولنا مجلس على الشط فيا | حٌ فسيحٌ ترتاح فيه القلوب |
فأتنا يا محمد بن يزيد | في استتار كيلا يراك الرقيب |
اطرد الهم باصطباح ثلاثٍ | مترعاتٍ تنفي بهن الكروب |
إن في الراح راحةً من جوى الحب | وقلبي إلى الأديب طروب |
لا يرعك المشيب مني فإني | ما ثناني عن التصابي المشيب |
لئن قمت ما في ذاك مني غضاضةٌ | علي وإني للكريم مذلل |
على أنها مني لغيرك سبة | ولكنها بيني وبينك تجمل |
وقال أحمد بن عبد السلام يرثيه:
ذهب المبرد وانقضت أيامه | وليذهبن مع المبرد ثعلب |
بيت من الآداب أصبح شطره | خرباً وباقي شطره فسيخرب |
فتداركوا من علمه فبكأس ما | شرب المبرد ثعلب فسيشرب |
وعليكم أن تكتبوا أنفاسه | إن كانت الأنفاس مما تكتب |
أيا طالب النحو لا تجهلن | وعذ بالمبرد أو ثعلب |
تجد عند هذين علم الورى | فلا تك كالجمل الأجرب |
علوم الخلائق مقرونةٌ | بهذين في الشرق والمغرب |
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - مصر-ط 2( 1992) , ج: 1- ص: 53
محمد بن يزيد بن عبد الله الأكبر الثمالي، وقيل المازني، الملقب بالمبرد
قرأ كتاب سيبويه على الجرمي، ثم على المازني، إمام في العربية، غزير الحفظ والمادة، تصانيفه كثيرة مشهورة
ومن أمثال المغرب: ’’من لم يقرأ الكامل فليس بكامل، ومن لم يقرأ أمالي القالي فهو للأدب قال’’. توفي سنة خمس وثمانين ومائتين.
جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت-ط 1( 1986) , ج: 1- ص: 72
دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع-ط 1( 2000) , ج: 1- ص: 286
محمد بن يزيد المبرّد البصريّ الأزديّ، أبو العباس.
كان أعلم أهل زمانه بالنّحو والغريب، حدّث أحمد بن حرب أنّ المتوكّل قرأ بحضرة الفتح بن خاقان قوله تعالى: {وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ} بفتح الهمزة، فقال له: بالكسر، فتتابعا على عشرة آلاف دينار، وتحاكما إلى يزيد بن محمد المهلّبيّ، فقال: يقبح أن يخلو باب أمير المؤمنين من عالم يرجع إليه. فقال المتوكّل: سلوا لنا من أعلم الناس بالنّحو؟ فقيل له: أبو العباس المبرّد بالبصرة، فأمر بإحضاره، فأشخص مكرّما، قال المبرّد: فلمّا وصلت سرّ من رأى أدخلت على الفتح بن خاقان، فقال: يا بصري، كيف تقول {وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ} بالفتح أو بالكسر؟ فقلت: بالكسر، وهو الجيّد المختار، وذلك أنّ أوّل الآية {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ} باستئناف جواب الكلام المتقدّم، قال: صدقت.. وركبت إلى دار أمير المؤمنين فعرّفه قدومي، وطالبه بدفع ما تخاطرا عليه، فأمر بإحضاري، فلمّا وقعت عين المتوكّل عليّ، قال: يا بصري، كيف تقرأ هذه الآية {وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ} بالكسر أو بالفتح؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أكثر الناس يقرءونها بالفتح. فضحك المتوكّل وقال: أحضر يا فتح المال، فقال: يا مولانا، والله قال لي بخلاف ذلك. فقال: دعني من هذا وأحضر المال، فلمّا خرجت أتتني رسل الفتح فأتيته، فقال: يا بصري، أول ما ابتدأتنا به الكذب، فقلت: ما كذبت والله، قال: وكيف وقد قلت لأمير المؤمنين: الصواب بالفتح. فقلت: إنّما قلت: أكثر الناس يقرءونها بالفتح، وأكثرهم على الخطإ، وإنّما تخلّصت من اللائمة وهو تغليط أمير المؤمنين، فقال: أحسنت. قال المبرّد: فما رأيت أكرم أخلاقا، ولا أرطب بالخير لسانا من الفتح. ولم يزل المبرّد مقيما بسرّمن رأى إلى أن قتل المتوكّل والفتح، وكان قد أفاد منهما مالا عظيما، فعند ذلك قدم بغداد.
قال محمد بن إسحاق النديم: وللمبرّد من الكتب كتاب الكامل، وكتاب الرّوضة، وكتاب المقتضب، وكتاب الاشتقاق، وكتاب الأنواء والأزمنة، وكتاب القوافي، وكتاب الخطّ والهجاء، وكتاب المدخل إلى كتاب سيبويه، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب المذكّر والمؤنّث، وكتاب التامّ في معاني القرآن، وكتاب الردّ على سيبويه، وكتاب الرسالة الكاملة، وكتاب إعراب القرآن، وكتاب الحثّ على الأدب والصّدق، وكتاب نسب عدنان وقحطان، وكتاب الزّيادة على كتاب سيبويه، وكتاب التعازي، وكتاب المدخل إلى النّحو، وكتاب شرح شواهد سيبويه، وكتاب ضرورة الشّعر، وكتاب أدب الجليس، وكتاب الحروف في معاني القرآن إلى طه، وكتاب صفات الله عزّ وجل، وكتاب الممادح والمقابح، وكتاب الإعراب، وكتاب الرّياض المونقة، وكتاب أسماء الدّواهي، وكتاب الجامع، لم يتم، وكتاب الوشي، وكتاب معنى كتاب سيبويه، وكتاب الناطق، وكتاب العروض، وكتاب البلاغة، وكتاب معنى كتاب الأوسط للأخفش، وكتاب شرح كلام العرب وتلخيص ألفاظها، وكتاب ما اتّفقت ألفاظه واختلفت معانيه، وكتاب الفاضل والمفضول، وكتاب طبقات النّحويّين البصريّين، وكتاب العبارة عن أسماء الله عزّ وجل، وكتاب الحروف، وكتاب التصريف، وكتاب الكافي.
وكانت وفاته، فيما ذكره ابن المرزبان، في ثامن عشر ذي الحجة من سنة خمس وثمانين ومائتين.
دار الغرب الإسلامي - تونس-ط 1( 2009) , ج: 1- ص: 147