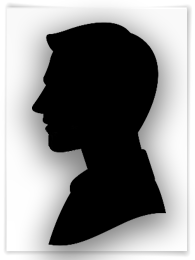الحجري
الحجري محمد بن علي بن سعيد الحجري التونسي: اديب نحوي. ولد بقرية (بوحجر) من قرى المنستير، وتعلم واستقر بتونس. ومات شابا. له (زواهر الكواكب -ط) حاشية على شرح الاشموني على الفية ابن مالك، في النحو، و (اللوامع) رسالة في المنطق، و (الفلك المشحون) ديوان نظمه ونثره.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 6- ص: 296
الحجري محمد بن علي بن سعيد الحجري (نسبة إلى بوحجر قرية من قرى المنستير بالساحل التونسي) الملقب نجم الدين، الأديب، الشاعر النحوي، المشارك في علوم.
انتقل به والده وهو صغير إلى تونس العاصمة، فقرأ بجامع الزيتونة على اعلام عصره كمحمد بن قاسم المحجوب، وصالح الكواش، وغيرهما.
وكان ذكيا المعيا طوى المرحلة الابتدائية في مدة قصيرة ولحق بمن تقدمه في التعلم، وظهر نبوغه وتفوقه في وقت مبكر، ولما امتلأ وطابه تصدر للتدريس والافادة، فأظهر تحقيقا وفصاحة مما دعا الطلبة إلى الاقبال على دروسه، وابتدأ باقراء الكتب الكبيرة كشرح الأشموني على الفية ابن مالك، على خلاف العادة المتبعة في أن المدرس عند أول ظهوره يبتدئ باقراء الكتب الصغيرة حتى يتسع أفقه ويرسخ قدمه، ومع هذه المخالفة فقد أظهر تمكنا في العلوم والكتب التي درسها، وسحر الألباب وأتى بالعجب العجاب.
ودرس كتاب «الشفا» للقاضي عياض بجامع الزيتونة بعد صلاة الصبح، وحضر يوم ختمه العالم الأديب الحاج محمد ابن الشيخ عبد الله السوسي السكتاني، ومدحه بقصيدة دالية أجابه عنها.
وانتفع به كثيرون كحميدة بن الخوجة المفتي الحنفي، وحسين بن عبد الستار، وغيرهما ولفصاحته وحلاوة تقريره تجلس العامة وراء حلقة درسه.
وكان أديبا شاعرا نحويا، منطقيا، له مشاركة في العلوم المتداولة في عصره، وأحرز على شهرة واسعة تجاوزت حدود البلاد فدارت مراسلات بينه وبين علماء استانبول، وتوثقت الصلة بينهم فاستغلها في تكليفهم بشراء ما يحتاج إليه من الكتب المفقودة في تونس، لا سيما كتب العلماء الأتراك والفرس، وقد استفاد منها في تدوين حاشيته على شرح الخبيصي للتهذيب في المنطق.
وله مراسلات مع الشيخ عمار الشريف القسنطيني من خريجي جامع الزيتونة، منها مباحثته في مسألة الاستدلال على عرضية العقل، وأنه ضعيف، وتكررت بينهما المراسلات، وحكم بينهما العلامة الشيخ محمد النيفر برسالة.
وبالرغم من أنه لم يعمر طويلا ومات وهو ما يزال غض الاهاب، لم يستوف أمد اقرانه وذلك في الطاعون الجارف المعروف بالوباء الكبير الذي حصد آلافا من الخلائق فإنه ترك تراثا علميا محترما مما ينبئ عن ذكاء وقاد خارق، وعن تأثير خصائص بيئته الأولى فيه من الكد ومواصلة العمل بدون فتور ولا وناء، وعدم إضاعة الوقت الثمين فيما لا يجدي من السفاسف وتوافه الأمور، ومن يقلب أوراق كتب الطبقات والتراجم للمغاربة والمشارقة يظفر بكثير من الأمثلة على احتمال أبناء القرى لشظف العيش في سبيل طلب العلم، ويظهر له سر تفوقهم ونبوغهم، وتبدو تأثيرات البيئة الأولى في أجلى صورها وأرفع مظاهرها.
وكان يجيد ارتجال الشعر مع متانة الصوغ وقوة السبك، وبدت هذه الميزات في باكورة انتاجه، يحكى أنه كان جالسا مع رفاق له ذات مساء على سطح مخازن من القطران بالبحيرة في مدينة تونس، فأظلم الجو لتراكم السحب، وأسودت الجبال فاقترحوا عليه أن يقول شعرا في وصف الحال، فارتجل بديهة هذه القطعة وهي أول مرة ينظم فيها شعرا:
انظر إلى لون الجبال وقد بدت | مسودة لما ارتدت بغمام |
فكأنها قلبي المسود بالجفا | مما بدا لك من ضياع ذمام |
والشمس في حلل السحاب تسترت | لما رأتك رميتها بسهام |
وإذا نظرت هنيأة تجد الدجى | وافى إليك ببدره كغلام |
وذي قوام نضير لا نظير له | سل الكرى من جفوني ثمت انقلتا |
في وسط قلبي من مر الغرام به | صيف ولكن في عيني منه شتا |
عاينت وقت زوال الشمس طلعته | لذاك عيناي إن قلت اكففا همتا |
وشمت في خده بنت العذار وما | عهدي هناك بغير الورد قد ثبتا |
وله قصيدة متشوقا إلى الديار المقدسة ومعارضا أبيات القاضي عياض في «الشفا» ومطلعه:
يا دار قطب دوائر الشرف الذي | لم تحوه الأقمار في الهالات |
هل زورة تشفي فؤاد متيم | يا أهل مكة والحطيم وزمزم |
1) حاشية على شرح الخبيصي للتهذيب في المنطق، اعتمدها العلامة الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر، وناقشه في بعض المواضيع، وهما مطبوعتان مع بعضهما بمصر أول مرة ببولاق سنة 1296/ 1878 وأعيد طبعهما.
2) حاشية على السكتاني في علم العقائد.
3) زواهر الكواكب لبواهر المواكب، وهي حاشية على شرح الأشموني على
الفية ابن مالك في النحو، ابتدا في جمعها عند تدريسه الكتاب، واتهمه البعض أنه استمد من حاشية الصبان على الكتاب لاتفاق آرائهما في بعض المواضع، وقد فند هذا الاتهام الشيخ محمد النيفر في «عنوان الأريب» حيث قال: «يزعم بعض الناس أنه اطلع على حاشية العلامة الصبان عليه لتواردهما في بعض الأبحاث، والحق أنه لم يرها لأنه لو رآها لكانت حاشيته أحفل مما هي عليه، على أن درجة صاحب الترجمة في الذكاء والتحصيل تؤهله لاصابة تلك الأغراض التي توارد عليها».
ط، الجزء الأول من هذا الكتاب بالمط الرسمية في تونس وقع الانتهاء من طبعه في 1293/ 1876 في 402 ص من القطع الكبير، وهذا الجزء يحمل العنوان الخاطئ «جواهر» بدلا من «زواهر» والجزء الثاني انتهى طبعه في سنة 1298/ 1880 في 324 ص، وتوجد من الكتاب نسختان مخطوطتان في المكتبة الوطنية بتونس.
4) شرح شواهد الأشموني.
5) الفلك المشحون بالجوهر المكنون، ديوان جمع فيه شعره ونثره في 15 ورقة من القطع المتوسط مخطوطا بالمكتبة الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم 16024، وتوجد منه نسخة أخرى بها.
6) اللوامع رسالة في المنطق.
ولما ذاعت مؤلفاته كاتبه علماء من المشرق والمغرب منوهين بفضله وعلمه، مثنين على ذكائه وفهمه.
المصادر والمراجع:
- اتحاف أهل الزمان 17/ 19/7.
- الاعلام 7/ 189.
- شجرة النور الزكية 250.
- عنوان الاريب 2/ 44 - 48.
- فهرس مخطوطات المكتبة الاحمدية 95 - 96، 269 - 270.
- مجمل تاريخ الأدب التونسي 255 - 256.
- معجم المطبوعات 117.
- معجم المؤلفين 11/ 12 - 13.
- هدية العارفين 2/ 345.
- خطبة شيخ جامع الزيتونة الشيخ صالح المالقي المنشورة بالمجلة الزيتونية رجب /1356 ديسمبر 1936 م 1 العدد 1 ص 8.
J.Quemeneur، Publications de L'Imprimerie officielle Tunisienne، en revue Jbla، 1962 No 98 p.161.
دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان-ط 2( 1994) , ج: 2- ص: 97