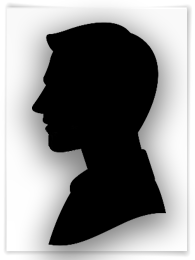ابن الأبار
ابن الأبار محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعي البلنسي، ابو عبد الله، ابن الابار: من اعيان المؤرخين، اديب. من أهل بلنسية (بالاندلس) رحل عنها لما احتلها الافرنج، واسقر بتونس فقربه صاحبها السلطان ابو زكرياء، وولاه كتابه (علامته) في صدور الرسائل، مدة، ثم صرفه عنها، واعاده. ومات ابو زكرياء وخلفه ابنه المستنصر، فرفع هذا مكانته. ثم علم المستنصر ان ابن لابار كان يزري عليه في مجاليه، وعزيت اليه ابيات في هجائه، فامر به فقتل (قعصا بالرماح) في تونس. من كتبه (التكملة لكتاب الصلة -ط) في تراجم علماء الاندلس، و (المعجم -ط) في تاريخ امراء المغرب، و (اعتاب الكتاب -ط) في اخبار المنشئين، و (ايماض البرق في ادباء الشرق) و (الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة -ط) و (تحفة القادم) نشرت مجلة المشرق مختصرا له، و (درر السمط في خبر السبط) ينال فيه من بني امية. وله شعر رقيق.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 6- ص: 233
ابن الأبار
محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن الأبار القضاعي البلنسي، نزيل تونس، أبو عبد الله الحافظ المحدث الأديب الكاتب الشاعر المؤرخ صاحب التآليف الكثيرة. أصل والده من أندة.
ولد ببلنسية من بلدان شرق الأندلس، المدينة الجميلة ذات الخصب والهواء المعتدل.
وكان والد ابن الأبار من أهل العلم، دينا تقيا، قرأ على طائفة من العلماء وأجازوه. قرأ عليه ابنه صاحب الترجمة القرآن بحرف نافع، وسمع منه أخبارا وأشعارا، ووجهه وامتحن حفظه أيام الطلب وناوله جميع كتبه. قال ابن الأبار في ترجمة والده: «وكان - رحمه الله - ولا أزكيه - مقبلا على ما يعنيه، شديد الانقباض، بعيدا عن التصنع، حريصا على التخلص، مقدما في حملة القرآن، كثير التلاوة له والتهجد به، صاحب ورع لا يكاد يهمله، ذاكرا للقراءات مشاركا لأخذ المسائل، آخذا فيما يستحسن من الأدب، معدلا عند الحكام، وكان القاضي أبو الحسن بن واجب يستخلفه على الصلاة بمسجد السيدة داخل بلنسية، قرأت عليه القرآن بقراءة نافع مرارا، وسمعت منه أخبارا وأشعارا، واستظهرت عليه مرارا أيام أخذي على الشيوخ يمتحن بذلك حفظي وناولني جميع كتبه، وشاركته في أكثر من روى عنه .. ».
ويتضح من هذا إن ابن الأبار نشأ في وسط علمي، ووجهه والده لطلب العلم. ومن أشهر أعلام بلنسية بل أعلام الأندلس الذين أخذ عنهم وتخرج بهم في علوم الحديث التي منها معرفة أسماء الرجال وأنسابهم وتواريخهم، وتخرج به في الكتابة أيضا الحافظ المحدث الحافل الأديب صاحب الرواية الواسعة والتصانيف أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الحميري الكلاعي، لازمه عشرين سنة. ولم يكتف ابن الأبار بالأخذ عن أعلام بلنسية بل جال في بلدان الأندلس للأخذ عن رجالها والرواية عنهم. وفي شيوخه كثرة ذكرهم ابن عبد الملك المراكشي في «الذيل والتكملة».وتوفي والده في ربيع الأول سنة 619/ 21 مارس 1222 ولم يحضر جنازته لأنه كان غائبا عن مسقط رأسه في ثغر بطليوس، فقد جاء في أواخر ترجمته لوالده «وتوفي ببلنسية - وأنا حينئذ بثغر بطليوس - عند الظهر يوم الثلاثاء الخامس شهر ربيع الأول سنة 619 ودفن لصلاة العصر من يوم الأربعاء بعده بمقبرة باب بيطالة وهو ابن ثمان وأربعين سنة، وحضر غسله أبو الحسن بن واجب وجماعته وكانت جنازته مشهودة، وأثنوا عليه جميلا نفعه الله بذلك».
وابن الأبار حريص على الرواية عمن تقدمت سنهم وعلا إسنادهم حتى بعد استكمال تحصيله وتجاوز طور الشباب، اتباعا لتقليد شاع في أوساط المحدثين، فقد لقي بتونس المقرئ الراوية أبا زكريا يحيى بن محمد بن عبد الرحمن البرقي المهدوي مصروفا عن قضاء المهدية (ت. سنة 647/ 1251). وقد اجتمع البرقي في تونس بالحافظ أبي الخطاب عمر بن حسن الكلبي المعروف بابن دحية، وروى عنه، وروى عنه عبد المنعم بن عبد الرحيم الخزرجي المعروف بابن الفرس. ويبدو أن ابن الأبار كان عارفا بمكانته قبل لقائه.
وبعد استكمال تحصيله وإشباع نهمه من لقاء الشيوخ بالقطر الأندلسي رجع إلى مسقط رأسه بلنسية فتولى الكتابة لواليها أبي عبد الله بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن المعروف بالبياسي وقد نشأ هو وأخوه أبو زيد عبد الرحمن في بياسة، فعرفوا من أجل ذلك بالبياسيين.
ولما خرج من بلنسية والتجأ إلى حلفائه القشتاليين خلفه على إمارة بلنسية أخوه أبو زيد عبد الرحمن، واستمر ابن الأبار على خطته في الكتابة حتى إذا ضيق على هذا الأمير أبو جميل زيان بن أبى الحملات مدافع بن يوسف بن سعد بن مردنيش في بلنسية التجأ إلى حليفه جايم أو خايمة الأول ملك أراغون وصحبه كاتبه ابن الأبار ثم رجع ابن الأبار إلى بلنسية عند ما رآه يفضل الإقامة في بلاد ملك أراغون وعمل كاتبا لأبي جميل زيان بن مردنيش الوالي الجديد على بلنسية. وكان القطر الأندلسي في هذا العصر مختل الأوضاع تعصف به الحروب الداخلية والحروب الخارجية من الإسبان بقيادة ملك قشتالة وملك أرغوان بحيث أن حركة الاسترداد الإسبانية سجلت انتصارات متعددة واحتلت مدنا عديدة، وكانت الدولة الموحدية في طورها الأخير من الضعف والانحلال، وأفراد بيتها منقسمون على أنفسهم متعطشون إلى السلطة تعطشا محموما بدون إقامة وزن للظروف الحرجة والمصلحة العامة، وأمراء الطوائف من الأندلسيين يتحاربون ويستعينون بهذا وذاك من ملوك الاسبان للتغلب على خصومهم ويرضون في مقابل ذلك بأداء إتاوة سنوية وهي نوع من الحماية بعدها الاحتلال في الفرصة المؤاتية، ويظهر للمتأمل أن مصير الأندلس تقرر منذ العقود الأولى من القرن السادس الهجري.
وكان شرقي البلاد الأندلسية هدفا لهجومات ملك أراغون خايما الأول فاستولى على كثير من القلاع حول بلنسية وشقر سنة 633/ 1236 وبنى حصن أنيشة قرب بلنسية ليعسكر فيه جنده استعدادا لحصار بلنسية، وقد حاول ابن مردنيش أن يبذل آخر جهوده فاستنفر أهل شاطبة وشقر، فانضموا إلى جند بلنسية، وهاجموا حصن أنيشة في العشرين من ذي الحجة سنة 634/ 13 أوت 1237 ولكنهم هزموا وقتل في المعركة كثير من الفقهاء والعلماء، ومن بينهم العلامة المحدث أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي شيخ ابن الأبار وهو مقبل غير مدبر يحرض الفارين على القتال.
وكانت هزيمة المسلمين أمام حصن أنيشة دليلا على قرب سقوط بلنسية فأخذ الناس في الانتقال منها. وفي رمضان سنة 635/ 1238 هاجم ملك أراغون بلنسية وضرب حولها حصارا قويا وأدرك المسلمون فيها أن لا طاقة لهم بصد المحاصرين وعزموا على الاستعانة بسلطان الدولة الحفصية في تونس وعند ذلك أرسل ابن مردنيش وفدا من أهل بلنسية إلى سلطان تونس أبي زكريا يحيى الحفصي وعين كاتبه ابن الأبار من بين أعضاء الوفد في رجب سنة /636 ديسمبر 1238 وطالب الوفد السلطان أبا زكريا الحفصي بنجدتهم وأدى ابن الأبار مهمته خير تأدية وأنشد بين يدي أبي زكريا الحفصي قصيدته السينية الطويلة وعدد أبياتها 67 بيتا من البحر البسيط طالعها:
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا | إن السبيل إلى منجاتها درسا |
«وفيها من التكلف ما يكاد يصرف قارئها عن الحال المحزن الذي قيلت فيه ». «وهو فيها شاعر مملوء النفس بالعاطفة مغمور الفؤاد بالأسى بين وطن مغلوب، وملك بالرجاء مطلوب، فالمعاني متوفرة، ومجال القول ذو سعة، من أجل ذلك أطال وأجاد ووجد وجوه الكلام مختلفة، فصال وجال لكنه كان فيها الواصف الناقل ينتقل من هذا كله ولم يكن الخائل الذي يملك تلوين هذه الأوصاف المنقولة وترويقها لتروق حينا وتهول حينا آخر، فهذا الخطب تفزع له النفوس وتجزع، وهو في حاجة إلى من يصوره فيحسن تصويره لا من يسرده فيحسن سرده.
وإنك إذ تحس جزعا وهلعا عند سماعك هذه القصيدة أو قراءتها فليس شعر الشاعر مبعثه أو مأتاه ولكن ما انطوت عليه الأبيات من تلك الحقائق المتراصة التي أحسن الشاعر جمعها ولم يحسن وصفها».
ولكن القصيدة على أي حال حققت الهدف من إنشادها، وكان لها تأثير في نفس السلطان أبي زكريا فتحمس وأرسل أسطولا إلى بلنسية مشحونا بالسلاح والقوت والمال.
وكان الملك خايمة الأول قد ضيق الحصار على بلنسية وراقب ميناءها، وحاول الأسطول الحفصي النزول في موضع جراو قرب بلنسية في 4 محرم 636/ 18 أوت 1238 فلم يستطع النزول لوجود الجنود النصارى «فأرسل قائد الحملة أبو يحيى بن أبي حفص عمر الهنتاتي المعروف بالشهيد إلى أبي زكريا الحفصي يعلمه بالحال، واتجه هو بالسفن إلى دانية وهي تابعة لابن مردنيش وأرسى فيها في 12 محرم 636/ 26 أوت 1238 وترك لأهلها الطعام والسلاح اللذين كان يحملهما أما المال فقد عاد به إذ لم يجد من يتسلمه منه».
وكان الحصار محكما شديدا حول بلنسية، والقتال ضاريا عنيفا وأعداد جند النصارى تتزايد يوما بعد يوم «حتى أصبح معسكر ملك أراغون كأنه مدينة كبيرة، خف إليها التجار من كل صوب».
وفي الوضع المتأزم اليائس استقر رأي زيان بن مردنيش على مفاوضة الأعداء لتسليم مدينة بلنسية، وتم التسليم في 17 صفر /636 سبتمبر 1238 وقد اشترك ابن الأبار في المفاوضات وكتب العقد.
وقد وصف ابن الأبار موكب التسليم، وبعض ما تضمنه اتفاق التسليم وانتقال الناس من بلنسية وخروج ابن مردنيش من قصر الإمارة. قال: «ثم ملكها الروم ثانية بعد أن حاصرها الطاغية جاقم البرشلوني من يوم الخميس الخامس من شهر رمضان سنة خمس وثلاثين وستمائة إلى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة ست وثلاثين وفي هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد الجذامي من المدينة، فهو - يومئذ - أميرها في أهل بيته ووجوه الطلبة والجند وأقبل الطاغية وقد تزيا بأحسن زي في عظماء قومه من حيث نزل بالرصافة أول هذه النازلة فتلاقيا بالولجة واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلما لعشرين يوما ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم وحضرت ذلك كله وتوليت العقد عن أبي جميل في ذلك وابتدئ بضعفة الناس وسيروا في البحر إلى نواحي دانية، واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا وصبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر المذكور كان خروج أبي جميل بأهله من القصر في طائفة يسيرة أقامت معه وعند ذلك استولى عليها الروم».
وكان حزن المسلمين على سقوط بلنسية عظيما، وبكى ابن الأبار مسقط رأسه بدمع غزير قال من رسالة له: «أما الأوطان المحبب عهدها بحكم الشباب، المشبب فيها بمحاسن الأحباب فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد، وأخنى عليها الذي أخنى لبد أسلمها الإسلام.
وانتظمها الانتثار والاصطلام، حين وقعت أنسرها الطائرة، وطلعت أنحسها الغائرة فغلب على الجذل الحزن، وذهب مع المسكن السكن (بسيط):
كزعزع الريح صك الدوح عاصفها | فلم يدع من جنى فيها ولا غصن |
واها وواها يموت الصبر بينهما | موت المجاهد بين البخل والجبن |
أين بلنسية ومغانيها وأغاريد ورقها وأغانيها، وأين حلى رصافتها وجسرها، ومنزلا عطائها ونصرها، أين أفناؤها تندى غضارة وذكاؤها تبدو من خضارة، أين جداولها المنساحة وذمائلها، أين جناتها النفاحة وشمائلها، شد ما عطل من قلائد أزهى نحرها، وخلعت شعشعانية الضحى بحيرتها وبحرها، فأية حيلة لا حيلة في صرفها مع صرف الزمان، وهل كانت حتى بانت إلا رونق الحق وبشاشة الإيمان، ثم لم يلبث داء عقرها أن دب إلى جزيرة شقر فأمر عذبها النمير وذوى غصنها النضير، وخرست حمائم أدواحها وركدت نواسم أرواحها».
وقد عدد ابن الأبار المدن الأندلسية التي سقطت بأيدي الاسبان، والتي يتوقع سقوطها « .. وتلك البيرة بصدد البوار، ورية في مثل حلقة السوار، ولا مرية في المرية وخفقها على الجوار إلى بنيات لواحق بالأمهات، ونواطق بهاك لأول ناطق بهات».
وذهب ابن مردنيش إلى دانية ومعه ابن الأبار، ثم رأى ابن الأبار الانتقال إلى تونس والاستقرار بها ليأسه من الوضع السيئ بالأندلس، ولحسن استقباله بتونس عند زيارته الأولى وتقديره وذيوع صيته وأكرم أبو زكريا الحفصي وفادته وولاه كتابة العلامة، وهي عبارة عن التواقيع التي تضاف إلى المكاتبات السلطانية وترفع إلى السلطان ليضع عليها خاتمة.
تولى ابن الأبار هذه الخطة بعد وفاة أبي عبد الله محمد بن الجلاء البجائي سنة 1240/ 638 صاحب خطة الإنشاء والعلامة.
وكان من المنتظر أن يلاقي النجاح والتوفيق لسابق تجربته في الخدمة بقصر الإمارة ببلنسية ولكنه لسوء أخلاقه وعدم احترازه من فلتات لسانه لم ينجح في الاضطلاع بهذه المهمة السامية وأخر وبعد تأخيره وتولية غيره كتابة العلامة لم يتقيد بدقة بما أعطي له من أوامر ولعل ذلك مبعثه الغرور.
قال الزركشي: «ثم أخر لسوء خلقه وإقدامه على التعليم (أي كتابة العلامة) في كتب لم يؤمر بالتعليم فيها».
ومثل هذا التفصي من القيود والسير بما تمليه الشهوة والرغبة، وبعبارة أخرى عدم التقيد بأي رسم من رسوم الإجراءات والأنظمة الديوانية، ومثل هذا ربما نجد له مبررا إذا كان القائم بهذه الوظيفة غرا عديم التجربة، أما ابن الأبار ذو التجربة السابقة فلا تفسير لسلوكه إلا الغرور وإذا كان هكذا فما له والاتصال بقصر له نظمه وتقاليده ويتقلد فيه وظيفة أخرى؟
وآل الأمر إلى تأخير السلطان أبي زكريا الحفصي لابن الأبار عن كتابة العلامة وتقديم أحمد بن إبراهيم بن عبد الحق الغساني التونسي المولد الأندلسي الأصل وكان يكتب العلامة بالخط المشرقي بما نصه: «من الأمير أبي زكريا ابن الشيخ أبي حفص» وطلب من ابن الأبار أن يقتصر على إنشاء الرسائل وكتابتها وأن يدع كتابة العلامة فيها لأحمد بن ابراهيم الغساني فلم يمتثل ما أمر به فبقي يكتب العلامة فعوتب في ذلك وروجع فاستشاط غضبا ورمى بالقلم من يده وأنشد متمثلا ببيت المتنبي:
أطلب العز في لظى وذر الذل | ولو كان في جنان الخلود |
وحمل الخبر إلى السلطان فصرفه عن العمل وأمره بلزوم بيته.
وقد عزا بعض الباحثين نكتبه إلى أن سعاية بعض حساد ابن الأبار من أهل تونس ممن ساءهم أن يروا المهاجرين الأندلسيين يحتلون أرفع المناصب في الدولة الحفصية ويزاحمونهم عليها بما يملكون من ثقافات ومواهب، أي أن هناك نزعة بلدية ضيقة لا تنظر بارتياح إلى تسنم الوافدين الغرباء من الأندلسيين أعلى المناصب وأن في هؤلاء غرورا واعتدادا بأنفسهم وثقافتهم وكونهم أهلها وأحق بها من غيرهم.
وليس هذا صحيحا من كل وجه لأن ابن الغماز البلنسي ابن بلدة ابن الأبار وتلميذ أبي الربيع الكلاعي مثل ابن الأبار تولى قضاء الجماعة بتونس (ما يعادل بعض اختصاصات وزير العدل الآن) مرات وكتابة العلامة الكبرى، ولم تحدث له مشاكل أو سعايات لأن ابن الغماز كان رجلا هادئا عاقلا رزينا رضي الأخلاق، بعيدا عن مزالق فلتات اللسان والغرور والادعاء.
وكان محل تقدير من جميع الأوساط، ولما مات تأسف الناس لفقده فرثوه بقصائد كثيرة جمعت في تأليفين لرجلين.
إن إخفاق ابن الأبار مرده إلى حدة طباعه وسوء أخلاقه وغروره وعدم تحرزه من فلتات لسانه ومما يدل على عدم تحرزه من فلتات لسانه وعدم تقديره لما ينجر عنها من نتائج غير سارة، أنه لما قدم من بلنسية في الأسطول نزل ببنزرت وخاطب الوزير ابن أبي الحسين بغرض رسالته ووصف أباه في عنوان مكتوبه «بالمرحوم» ونبه على ذلك فضحك وقال: «إن أبا لا تعرف حياته من موته لأب خامل» ونمي ذلك إلى الوزير فأسرها في نفسه وراح يكيد له، وابن الأبار يؤذي بلسانه ويتهكم في سخرية من لا يروق له «ويبدو أنه كان ممن ينبزون الآخرين بالكلام القارص أو النقد المهين في خفية وتستر حاسبين أن أمرهم لا يفتضح وأمرهم في الحقيقة لا يخفى على أحد، ومن هنا لقبه خصومه بالفأر ويغلب على الظن أن وجهه كان صغيرا نحيلا، ومن هناك قال فيه أحد خصومه وهو أبو الحسن علي بن شلبون المعافري البلنسي [كامل]:
لا تعجبوا لمضرة نالت جمي | ع الخلق صادرة من الآبار |
أوليس فأرا خلقة وخليقة | والفأر مجبول على الأضرار |
وبعد صرف ابن الأبار عن خطته انتقل إلى بجاية لملاقاة ولي العهد أبي يحيى زكريا «وكان في أيام أبيه شابا مستضعفا دائم الخوف من إخوته محمد وابراهيم وعمر وأبي بكر (وكلهم ولي بعده) ومن أبناء عمه محمد بن عبد الواحد المعروف باللحياني لعظيم لحيته، ولهذا كان حريصا على أن يكسب لنفسه أنصارا يشدون أزره، فسره أن يتشفع به ابن الأبار فكلم أباه في أمره فأعاده إلى الرضا».
وفي فترة الابتعاد عن الخدمة نظم القصائد الضارعة معتذرا وراجيا عفو السلطان أبي زكريا من زلقة:
لمبشري برضاك أن يتحكما | لا المال استثني عليه ولا الدما |
ندمي على ما ند مني دائم | وعلامة الأواب أن يتندما |
وفي هذه الفترة ألف ابن الأبار «إعتاب الكتاب» «برسم السلطان أبي زكريا، وتذلل في فاتحته فأسرف في التذلل، وقص فيه حكايات كتاب غضب عليهم الملوك والأمراء ثم عفوا عنهم وقبلوا أعذارهم واعتبوهم.
أين هذا من تمثله منشدا:
أطلب العز في لظى وذر الذل | ولو كان في جنان الخلود |
بل ها هو ذا متضرع ذليل في الدنيا لا في دار الخلود!
إن ابن الأبار تحمله الحدة وسوء الخلق على عدم الانسجام بين مواقفه وأقواله وما كان أغناه عن التذلل والركوع لو أحسن ضبط نفسه ولم يكرع من ماء الغرور العكر.
وتوفي السلطان أبو زكريا سنة 647/ 1248 وتولى بعده أبو عبد الله محمد الملقب بالمستنصر ثاني أولاده وقد رتب جماعة من العلماء والأدباء لمجالسته وكثير منهم أندلسيون كابن عصفور وابن الأبار وأبي بكر ابن سيد الناس وأبي المطرف بن عميرة وغيرهم.
وابن الأبار لم يستفد من تجاربه في خدمته الديوانية مع ما فيه من خفة وطيش فألب الأعداء حوله لسلاطة لسانه وإيذائه به وغروره فلم يقصر هؤلاء في نسج الدسائس له حتى أودوا بحياته ومنهم الوزير أحمد بن أبي الحسين، والكاتب أحمد بن إبراهيم الغساني، هذا زيادة عما في حياة القصر من رسوم تضيق بالفضول والغرور.
وقد تمكن خصوم ابن الأبار وأضداده وفي مقدمتهم الوزير ابن أبي الحسين من إيغار صدر المستنصر عليه، فنفاه إلى بجاية سنة 655/ 1257.
وفي مدة نفية ببجاية لقيه أبو الحسن علي بن سعيد الأندلسي وقال بعد أن أشار إلى قصيدته السينية وتوفيقه فيها وإعجاب الناس بها: «إلا أن أخلاقه لم تعنه على الوفاء بأسباب الخدمة، فقلصت عند ذلك النعمة، وأخر من تلك العناية، وارتحل إلى بجاية، وهو الآن عاطل من الرتب، خال من حلى الادب مشتغل بالتصنيف في فنونه، مثقل منه بواجبه ومسنونه، ولي معه مجالسات آنق من الشباب، وأبهج من الروض عند نزول السحاب.
وفي هذه الفترة نقح وزاد في كتابة «التكملة لكتاب الصلة» وأتم كتابه «الحلة السيراء» واستطاع ابن الأبار أن يسترضي السلطان المستنصر فعاد إلى تونس. ولم تطل مدة إقامته بها حتى قتل.
وذكروا في سبب قتله أنه جرى بالمجلس يوما ذكر مولد الواثق ابن السلطان المستنصر فلما كان من الغد جلب ابن الأبار بطاقة يعرف فيها بساعة المولد والطالع فلما وقف عليه المستنصر قال: «هذا فضول ودخول فيما لا يعنيه من أمرنا» وأمر بتثقيفه بسقيفة القصبة، وبعث إلى داره أحمد بن إبراهيم الغساني وبينهما من العداوة ما يكون بين صاحب خطة أخذها أحدهما من الآخر فوجد في تقاييده أبياتا منها:
طغى بتونس خلف | سموه ظلما خليفة |
وحكى المرادي أن البيت الذي وجد له يقتضي هجاء الخليفة هو قوله:
عق أباه وجفا أمه | ولم يقل من عثرة عمه |
فلما قرأها السلطان أمر بضربه ضربا شديدا ثم قتل مرشوقا بالرماح، وأخذت كتبه
وتقاييده فأحرقت في موضع قتله وكانت خمسة وأربعين تأليفا وذلك في صبيحة يوم الثلاثاء 21 محرم 658 بمقصورة المحتسب خارج باب ينتجمي ثم ندم السلطان بعد ذلك على قتله.
قال المؤرخ ابن أبي الضياف: «وتركها شنعاء في ملوك الإطلاق».
وقيل إن سبب قتله أنه وجد بين كتبه «كتاب في التاريخ» عثر فيه على ما يسيء إلى المستنصر أثار السلطان فقتله.
وسواء صحت هذه الحكاية أو تلك في سبب قتله أو لم تصح فإنها لا تفقد دلالتها في عدم احتراز ابن الأبار من فلتات لسانه وبدوات قلمه وإن الذين ربما دسوا بين أوراقه بيتي الشعر السالفين كانوا عارفين بنفسيته وأخلاقه بحيث إذا تعمدوا الكذب والوضع لا يكذبهم ما عرف عنه من صفات وأخلاق.
ويصدق على ابن الأبار أنه كان «غير عارف بزمانه ولا مقبل على شانه» لأنه جلب لنفسه عداوة رجال كان في غنى عنها، ولم يكن عارفا بشهوة ملوك الإطلاق في سفك دم من لا يروق لهم أو يخالفهم في الرأي الخلاف البسيط.
ولا نبرئ المستنصر من جسارته على سفك الدماء وليس ابن الأبار هو الوحيد الذي قتله بل قتل إبراهيم الللياني، ودبر اغتيال ابن عصفور الأشبيلي النحوي وقد بالغ المستنصر في شناعة الانتقام فلم يقتصر على الأمر بضرب ابن الأبار وقتله، بل أحرق شلوه مع كتبه. وما ذنب الكتب حتى تحرق؟ ! نعوذ بالله من غضب يفقد معه صاحبه رشده واتزانه وكان بوسع المستنصر الاحتفاظ بمكتبة ابن الأبار وضمها إلى مكتبة القصر وتيسير السبيل لمن يريد الاطلاع أو النسخ وهي كتب علمية بعيدة عن السياسة، ولا تدعو إلى الانتفاض أو الثورة أو الخلاف، وبوسعه التخلص من بعض كتب قليلة تسيء إليه ولا تروق له ككتاب التاريخ - على ما قيل - وكان هذا العمل الإجرامي الجنوني من المستنصر سببا في اتلاف مؤلفات ابن الأبار بحيث لم يبق منها إلا القليل مما نسخه بعض الآخذين عنه وسمعه منه قبل قتله.
ثناء العلماء عليه:
قال ابن عبد الملك المراكشي: «وكان آخر رجال الأندلس براعة واتقانا وتوسعا في المعارف وافتنانا، محدثا مكثرا ضابطا، عدلا ثقة، ناقدا يقظا، ذاكرا للتواريخ على تباين أغراضها متبحرا في علوم اللسان نحوا ولغة وأدبا، كاتبا بليغا، شاعرا مفلقا مجيدا، عني بالتأليف وبحث فيه واعين عليه موفور مادته وحسن التهدي إلى سلوك جادته فصنف فيما كان ينتحله مصنفات برز في إجادتها، وأعجز عن الوفاء بشكر إفادتها».
وقال عبد الحي الكتاني: «وهو عندي عديل ابن خلدون وابن الخطيب في الإنشاء وملكة الشعر، ويفوقهما بصناعة الحديث ومعرفته معرفة تامة، ليس للتونسيين من يشاركه ويضارعه فيها، ولفرط اعتنائه وعظيم اهتباله قال الغبريني في «عنوان الدراية »: لا يكاد كتاب من الكتب الموضوعة في الإسلام إلا وله فيه رواية بعموم أو خصوص».
تلامذته:
روى عنه صهره على بنته أبو الحسن عيسى بن لب، وأبو بكر بن أحمد ابن سيد الناس، وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد التجاني التونسي، ومحمد بن أبي القاسم بن رزين التجيبي نزيل تونس، ومحمد بن الجلاب نزيلها، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن برطلة، وعبد الله بن هارون الطائي القرطبي نزيل تونس.
وابن الأبار لم ينتصب للتدريس والإسماع في مسجد أو مدرسة، ولعل هؤلاء سمعوا منه في منزله بتونس.
مؤلفاته:
أغلب تآليفه في الحديث أو ما له صلة به كالمعاجم التي ألفها عن بعض مشاهير محدثي الأندلس ولا يكاد المحدث يخلو من العناية بالتاريخ والتراجم، ولعل أول مؤلفاته كانت في الحديث كالمورد المسلسل، والمأخذ الصالح، ثم المعاجم، وتكملة كتاب الصلة الذي ألفه قبل «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» للإحالة عليه في هذا الكتاب، وتناوله بالتنقيح والزيادة في تونس وبجاية. ونذكر فيما يلي تآليفه مرتبة على حروف المعجم:
1 - حضار المرهج في إحضار المبهج على نحو كتاب أبي منصور الثعالبي. كذا قال ابن عبد الملك المراكشي ولم يبين أي كتاب من كتب الثعالبي نحا منحاه.
2 - أربعون حديثا عن أربعين شيخا من أربعين مصنفا لأربعين عالما من أربعين طريقا إلى أربعين تابعا عن أربعين صاحبا بأربعين اسما عن أربعين قبيلا في أربعين بابا. أبدى فيه اقتداره مع ضيق مجاله، ما عجز عنه الملاحي من ذلك.
3 - الاستدراك على أبي محمد القرطبي ما أغفله من روايات الموطأ.
4 - إعتاب الكتاب، حققه وعلق عليه وقدم له الدكتور صالح الأشتر وطبع بالمطبعة الهاشمية بدمشق سنة 1380/ 1960 من مطبوعات مجمع اللغة العربية، «وتسمية الكتاب توحي بالغرض الذي ألف من أجله وتكشف عن موضوعه، فالأعتاب مصدر من «أعتب» وتقول «اعتبه» إذا أعطاه العتبى أي الرضى وأزال لومه وأرضاه وإعتاب الكتاب - إذن - إعطاؤهم العتبى بالرضى عنهم والعفو عن زلاتهم وإعادة الحظ والحقوق إليهم، وبذلك يلخص عنوان الكتاب غرضه وموضوعه
والغاية من تأليف الكتاب أنه أراد أن يضرب للسلطان أبي زكريا الأمثال في حلم الملوك وعفوهم عن أخطاء كتابهم، فراح يبحث عن هذه الأمثال في تراجم الكتاب في الشرق والغرب الإسلاميين ويتقصاها ويجمعها، ويبرز في كل مثل إقالة الذنب ليحث بذلك السلطان على إقالة ذنبه، ومن هنا كان الكتاب في هيكله العام تراجم مقتضبة لهؤلاء الكتاب وأخطائهم وعفو أسيادهم عنها. ولما كانت إقالة العثرة هي المحور الأساسي في تأليف الكتاب فقد أهمل المؤلف في ترجمة كل كاتب ما ليس له صلة بذلك المحور في حياتهم.
ويمكننا تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول المقدمة: وفيها استعرض المؤلف موضوع كتابه ويشرح الغرض منه.
القسم الثاني: تراجم الكتاب وعددها خمس وسبعون ترجمة تختلف طولا وقصرا فبعضها يتسع حتى يشغل أكثر من خمس صفحات. ويضيق بعضها ويقصر فلا يزيد على أسطر قليلة
أما تصنيفه التراجم فقد قسمت إلى قسمين ظاهرين:
أولهما لتراجم الكتاب المشارقة وثانيهما لكتاب المغرب الإسلامي (شمالي افريقيا والأندلس) وإن لم تكن مراعاة هذا التقسيم دقيقة جدا ذلك أننا نجد في قسم المشارقة أمثال داود القيرواني وعبد الله بن محمد الزجالي الأندلسي، كما نجد في القسم الثاني ترجمة لكاتب صلاح الدين.
وتتسلسل التراجم في كل من القسمين تسلسلا زمنيا .. وقد أهمل ابن الأبار في كل ترجمة تحديد سني المولد والوفاة، والحق أن الكتاب يمثل أسلوبا جديدا في فن التراجم، أسلوبا موجها وجهة خاصة.
ويشير ابن الأبار في أغلب الأحيان إلى مصادره التي ينقل منها، وقد كان أمينا في نقله حتى ليبدو لنا في كتابه جماعة يجمع وينقل ويحاول أن يربط ويضم أطراف ما يجمعه وينقله ويضيف إلى ذلك وهنالك إشارات إلى السلطان أبي زكريا وولي عهده أبي يحيى. أما ابن الأبار المؤلف حقا فلا يظهر إلا في التراجم التي خص بها بعض الكتاب الأندلسيين الذين عرفهم في حياته معرفة شخصية.
والقسم الثالث: خاتمة المؤلف وفيها يعلن ابن الأبار غايته بعد تقديمه الكتاب إلى السلطان أبي زكريا فجميع تلك الأمثلة التي ضربها لعفو الملوك عن زلات كتابهم هي دون عفو السلطان أبي زكريا عن زلته.
ولكتاب «إعتاب الكتاب» قيمة محققة فهي مصدر تاريخي يكشف لنا عن حياة عدد كبير من الكتاب والوزراء في الدول العربية والإسلامية وقد يقدم لنا أحيانا معلومات لا نجدها في مصدر آخر تزيدنا علما بتلك الشخصيات السياسية التي لعبت أدوارا هامة في تاريخ الحضارة الإسلامية وتنير لنا جانبا من النظم والتقاليد التي كانت متبعة في تنظيم الدواوين وأعمالها في دول العالم الإسلامي. وكتاب «الإعتاب» بذلك كله يأخذ مكانه إلى جانب كتاب «الوزراء والكتاب» للجهشياري وكتاب «الفخري في الآداب السلطانية» لابن الطقطقى و «كتاب الوزراء للصايي».
وقد مهد محقق الكتاب ببحث مستفيض عن عصر ابن الأبار وحياته ومؤلفاته، وتحليل واف لكتاب «إعتاب الكتاب».
5 - إعصار الهبوب في ذكر الوطن المحبوب. ولعله يتعلق ببلده بلنسية، وما حاق بها من محن أدت إلى سقوطها بين يدي ملك أراغون، والملاحظ أن كلمة وطن عند القدامى ليس لها اتساع في المدلول كما في عصرنا بحيث تشمل القطر كله بل إن كلمة «الوطن» عندهم مرادفة لكلمة «مسقط الرأس».
6 - الانتداب للتنبيه على زهر الآداب.
7 - الإيماء إلى المنجبين من العلماء (أي من أهل الأندلس).
8 - إيماض البرق في شعراء الشرق.
9 - برنامج رواياته.
10 - كتاب التاريخ، وكان سبب قتله وإحراق كتبه لما وجد فيه من أمور تسيء إلى المستنصر حسب رواية المقري.
11 - تحفة القادم - عارض به زاد المسافر لأبي بحر صفوان بن إدريس، كذا قال ابن عبد الملك المراكشي. ولعله جمع مادته بالأندلس وأظهره بتونس. والعنوان يدل على الغرض وظرفه. وهو «كتاب في تراجم الشعراء يضم مائة من الشعراء وأربع من الشاعرات من أهل الأندلس من رجال القرنين الخامس والسادس مع قطع مختارة من أشعارهم ».
وقد اختصره أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البلفيقي باسم «المقتضب من تحفة القادم» طبع في القاهرة سنة 1957 بتحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. وهو مختصر سيء الصنيع استغنى البلفيقي فيه عن معظم النثر ولم يبق منه إلا هيكلا جافا يتكون من أسماء وبضعة أشعار.
12 - التكملة لكتاب الصلة، ألف ابن الأبار هذا الكتاب قبل «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» كما يفهم من الإحالة عليه في «المعجم» في مواضع متفرقة. ألفه بإشارة من شيخه أبي الربيع الكلاعي.
قال الدكتور حسين مؤنس «والراجح - على حسب ما استبان لي - أن كتاب «التكملة» كتب على فترات، ففيه مواد يبدو بوضوح أنها كتبت قبل سنة 630/ 1232 - 1233، وأخرى كتبت بعد هذا التاريخ، وقبل هجرة ابن الأبار إلى المغرب، وثالثة كتبت وهو في بجاية وهذا معقول بالنسبة لكتاب كبير مثل «التكملة».صحيح أنه يفهم من فاتحة الكتاب كما نشرها محمد بن شنب في «المجلة الافريقية» (سنة 1918) ص 317 إن الفراغ من كتاب «التكملة» كان في أوائل المحرم سنة 631/ 1233 - 34 - لكن في الكتاب مواد كتبت وابن الأبار في تونس أو بجاية مما يدل على أن الأبار فرغ من صورة أولى للكتاب أول محرم سنة 631 ثم عاد إلى الكتاب ووضعه في الصورة التي وصلت إلينا وهو في بجاية للمرة الثانية.
وانتهى من تأليفه سنة 646 وهو مطبوع نشر القسم الكبير فرانشيسكو كوديرا من حرف (ح) إلى نهاية الكتاب في مجلدين في مدريد بين عامي 1888 - 1889 ونشر القسم الأول الباقي منه محمد بن أبي شنب والفريد بال في الجزائر سنة 1920 ونشره عزت العطار الحسيني في القاهرة سنة 1955 وصدر منه جزءان وفي أثناء طبع الجزء الثاني مات الناشر، ولم يتم طبع البقية.
والكتاب في تراجم علماء الأندلس مرتب على حروف المعجم حسب الطريقة المغربية، على خلاف كتاب ابن الفرضي، و «الصلة» لابن بشكوال، كما سار على الطريقة المغربية في الترتيب أبو العباس بن فرتون في كتابه «الذيل على الصلة» ومكمله أبو جعفر بن الزبير في كتابه «صلة الصلة» والطريقة المغربية تتفق مع الطريقة المشرقية إلى الزاي وبعده عند أهل المغرب والأندلس: ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ وي.
وإذا كان كتاب «التكملة» مرتبا على الحروف فإنه قد روعي في هذا الترتيب الطبقات بأن يذكر المتقدم وفاة على سابقه ولو كان في ذلك إخلال بالترتيب المعجمي الدقيق في مراعاة أسماء الآباء والأجداد مع الاسم اي ما يسمى بمراعاة الثواني والثوالث، ولولا الفهارس المسهلة للمراجعة لأضاع الباحث وقتا كثيرا في البحث عن ترجمة اسم في حرف من الحروف بتتبع الأسماء المشتركة ولم يوف ابن الأبار ومن سبقه بشرط الترتيب على الطبقات «وقد كان من الاتقان في العمل أن بنوا كتبهم على ترتيب الطبقات أن يعمدوا إلى أقدم من باسم أوله حرف الباب موتا فيصدرون به ويتبعونه مشاركيه في الاسم كما يفعلون في المفاريد، ثم يفعلون ذلك في الأسماء اسما اسما، فلم يفعلوا ذلك بل نجد أول مذكور في الترجمة السابقة متأخر الوفاة عن أول مذكور في الترجمة الثانية بل في الثالثة فصاعدا، وذلك موجود كثيرا لمن يلتمسه في كتبهم.
واعتبر ابن الأبار في الترتيب زمن رواية الراوي عن شيوخه مع وفاة من قبله ومن بعده فيذكره بينهما، وفيه من الخلل في الترتيب ما فيه لأن الراوي قد يكون زمن الرواية صغير السن ثم يعمر ما شاء الله أن يعمر فلا يكون من ذلك طبقة حسب ترتيب الوفيات. قال ابن عبد الملك المراكشي: «ومما وجدت أبا عبد الله بن الأبار يعتبر في التطبيق زمن رواية الراوي عن شيوخه بعد وفاة من قبله ومن بعده فيوسطه بينهما فيجعل الراوي سنة عشرين وخمسمائة مثلا بين من توفي سنة تسع عشرة وبين من توفي سنة إحدى وعشرين ولعل الراوي سنة عشرين كان طفلا صغيرا أو ابن خمس عشرة أو عشرين ثم يعمر بعد ما شاء الله ويبلغ الثمانين أو التسعين وخمسمائة وستمائة وكيف يسوغ الحكم بأنه من تلك الطبقة على مراعاة ترتيب الوفيات.
وسار ابن الأبار ومن سبقه على ذكر الأسماء النادرة في المفاريد وذلك في كل حرف وعلى ذكر الغرباء في كل حرف بعد الفراغ من ذكر الأندلسيين، والغرباء - في اصطلاحهم - وهم الطارئون على الأندلس من غيرها سواء كان أصلهم منها أو من غيرها.
ولا حظ الناقد المتلمح ابن عبد الملك المراكشي بأن مصطلحهم في الغرباء خارج عن عرف المحدثين والمؤرخين فإن نسبة الراوي إلى بلد والديه ونشأ وقرأ وروى عنه أو فارقه ثم عاد إليه نسبة صادقة بكل اعتبار من هذه الاعتبارات التي ذكرها العلماء، وقد اشترك في استعمالها المتقدمون والمتأخرون فأما إن كان ناقلة بعد مولده فما بعده على تدريج الأحوال إلى غيره فإن المتقدمين راعوا موضع استقراره فهم إنما ينسبونه إلى البلد الذي صار مستقره إلى أن قال: «فعلى هذا كان عمل المتقدمين أئمة المحدثين وتبعهم في ذلك المتأخرون ما عدا أبا الوليد بن الفرضي وتابعيه وهلم جرا».
واضطرب ابن الأبار في خصوص الغرباء فقد عد بعضهم أندلسيا استكثارا أو تعصبا وذكر في الغرباء من لم يدخل الأندلس، قال ابن عبد الملك المراكشي: «وقد اضطرب عمل أبي عبد الله بن الأبار في هذا اضطرابا ينافي شهير نبله ومعروف تيقظه وتحفظه من متعلقات النقد وأسبابه فجرى في معظم كتابه على اصطلاح أبي الوليد بن الفرضي ومن تبعه وخالفهم في بعضه فذكر في الأندلسيين جماعة من الناقلة إليها عمل المتقدمين المفروغ من تقريره تشبعا واستكثارا وإفراطا في التعصب الذي كان الغالب عليه حتى غلا فيه ويكفيك ما ختم به رسم أبي عبد الله بن عيسى بن المناصف - رحمه الله - بعد أن ذكره في الأندلسيين وذكر من أحواله ما رأى أن يذكره به قال: «مولده بتونس وقيل بالمهدية وهو أصح». ثم قال: وذكره في الغرباء لا يصلح ضنا به على العدوة وحسبك ما احتمل هذا القول من الشهادة على قائله بما لا يليق بأهل الإنصاف من العلماء واستحكام الحسد المذموم، واحتقار طائفة كبيرة من الجلة العدويين ».
ومن تشبع ابن الأبار واستكثاره في الغرباء من لم يعرف دخولهم الأندلس كأبي المعالي الخراساني. «وكم من شاهد على أبي عبد الله بن الأبار بفاضح التشبع في كتابه كذكره أبا المعالي الخراساني ورواية أبي زيد الفزاري عنه وقوله إنه لا يدري أين لقيه، فما الذي يسوغ له أفراده برسم في كتابه.»
وذكر ابن الأبار في «التكملة» كثيرا من العباد غير معروفين بالعلم استكثارا وهم ليسوا من شرط كتابه ولا كتابي سلفيه «ابن الفرضي وابن بشكوال» وكذلك ذكر طائفة كبيرة ليست من شرط كتابه ولا «كتابي الشيخين أبي الوليد بن الفرضي وأبي القاسم بن بشكوال لأنهم لم يرسموا بفن من فنون العلم، وإن ذكروا بصلاح وخير واجتهاد في العبادة وانقطاع إلى أعمال البر فلذكرهم مجموع آخر يشملهم مع من كان على مثل أحوالهم.
وفي «التكملة» أحيانا التكرار وقلب النسب، ومما أخل به أي إخلال أن ذكر ابن أحمد ابن سعيد بن مطرف التجيبي من أهل قلعة أيوب، نزيل مدينة فاس، ويعرف بابن البيراقي، ويكنى أبا عبد الله، روى عن أبي محمد بن عتاب، وكان من أهل العلم صاحب دفاتر ودواوين نفيسة، حدث عنه أبو حفص عمر بن محمد، وتوفي في حدود الأربعين وخمسمائة عن بعض أصحابنا انتهى إليهم» ثم قال بعد مائة وتسعة وستين اسما واثر من توفي بعد أربع وثمانين ما نصه: «محمد بن أحمد بن مطرف بن سعيد التجيبي يكنى أبا عبد الله، وروى عن ابن عتاب، أخذ عنه ابنه عمر بن محمد انتهى إليهم» وهذا هو المذكور قبل لا محالة.
هذه بعض الانتقادات والمآخذ على كتاب «التكملة» التي لا حظها الناقد كاتب التراجم ذي المنهج الدقيق ابن عبد الملك المراكشي.
وقد ألم ابن الأبار في مقدمة «التكملة» بما زاده واستدركه على ابن الفرضي وابن بشكوال ومخالفته لهما على الحروف حسب الطريقة المغربية لا المشرقية فقال: «ولم أقتصر على الابتداء من حيث انتهى ابن بشكوال، بل تجاوزته إلى الفرضي، أتولى التقصي وأتوخى الإكمال، وربما أعدت من تخيفا ذكره وما تعرفا أمره، وخالفتهما في نسق الحروف فجريت على النهج المعروف».
وكتاب التكملة استتمام لما بدأ به أبو الوليد عبد الله بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي (351 - 403/ 962 - 1012) من التراجم لعلماء الأندلسيين، وواصل العمل أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأنصاري (494 - 578/ 1100 - 1182) ثم استتم ما فاته في كتاب لم يصل إلينا هو كتاب «ذيل الصلة» ذكره ابن الأبار في «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» ثم جاء ابن الأبار فتصدى لاستكمال ما فات سابقيه ومواصلة التراجم إلى أيامه.
ثم واصل العمل أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد المعروف بابن فرتون السلمي الفاسي ثم السبتي (580 - 660/ 1184 - 1262) في كتابه «الذيل على صلة ابن بشكوال» وهو مفقود. ثم واصل هذا العمل الجليل أبو جعفر أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الزب (627 - 709/ 1229 - 1308)
في كتابه «صلة الصلة» ثم واصله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ، (634 - 703/ 1237 - 1303) في كتابه «الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» وهو أسدها منهجا وأغزرها مادة، وختمه ابن الخطيب بكتابه «عائد الصلة».
وهذه الكتب كلها ما عدا الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي تتبع منهجا واحدا في الترجمة فتذكر الرجل باسمه الكامل وكنيته ونسبته وبلده الذي ولد فيه أو الذي منه أصله والبلد الذي سكنه إن كان قد نزل بلدا آخر ثم شيوخه وما قرأ عليهم، ثم تلامذته ومن أخذ عنه وتختم الترجمة بتاريخ الوفاة ومكانها وتاريخ الميلاد ومكانه إذا تيسر.
وهذه في الحقيقة ليست تراجم بالمعنى المعروف وإنما هي سجلات بالأسماء وتواريخ الميلاد والوفيات والشيوخ فلا تعطي فكرة واضحة عن المترجم له إلا فيما ندر فليس فيها إلا القليل جدا من إشارات إلى حياة الرجل وما وقع له أو صفاته وخصائصه كرجل له صفات وخصائص بل ليس فيها إلا في القليل أيضا تلك الطرائف والحكايات الصغيرة التي نجد نماذج منها في «تاريخ القضاة» للخشني أو في «رياض النفوس» أو «الإحاطة» لابن الخطيب أو سلسلة الوفيات المشرقية التي بدأت بابن خلكان، ومن ثم فإن قيمتها للتاريخ السياسي والاجتماعي للأندلس بل فائدتها في التعريف بالرجال أنفسهم قليلة، ولكنها على أي حال أكثر فائدة من المواد التي يتضمنها الكثير من كتب علي بن سعيد وكتاب «الخريدة» للعماد الأصفهاني أو «الكتيبة الكامنة» لابن الخطيب، فهذه مجموعة مختارات وليست بتراجم أو مواد ذات قيمة تاريخية وفي هذه الحدود تتساوى كتب ابن الفرضي وابن بشكوال وابن الأبار وابن الزبير في الدقة والاتقان وربما شف ابن بكشوال على صاحبيه في تراجمه بسبب ملكته التاريخية الواضحة، وابن الأبار على هذا الاعتبار واحد من أعلام مؤرخي العلم بالأندلس ومرجع من المراجع التي لا يستغني عنها مؤرخ خلال القرنين السادس والسابع الهجريين بصفة خاصة.
13 - كتاب الحلة السيراء ابتدأ ابن الأبار تأليف هذا الكتاب في تونس عقب استقراره بها فهو في فاتحته يتحدث عن شعر السلطان أبي زكريا يحيى وولي عهده أبي يحيى، وكانا يقرضان الأبيات منه بين الحين والحين وقد صنفه ابن الأبار تمجيدا لشاعرية السلطان وابنه وتدليلا على أن قول الشعر من خصال كبار الخلفاء والسلاطين والأمراء، فهذا الكتاب مثل كتاب «إعتاب الكتاب» كتاب مناسبة ولكنها كانت مناسبة سعيدة لأنها أتاحت الفرصة لهذا الحافظ الواعي أن يسجل شيئا من محفوظه الغزير.
وفي الكتاب إشارة إلى أنه كان ما زال مشتغلا بكتابته سنة 646/ 1249 - 49 وهي السنة التي توفي فيها ولي العهد أبو يحيى، وربما يكون قد أتمه قبل وفاة أبي زكريا ولكن العجلة التي تبدو في الباب الأخير من الكتاب تدل على أنه أتمه بعد هذه السنة بمدة قصيرة، وفي الغالب أيام إقامته الثانية ببجاية.
وهو بدون شك أحسن كتب ابن الأبار وأعظمها فائدة بل هو من عيون ما ألف أهل الأندلس قاطبة ومن المراجع التي لا يستغني عنها من يؤرخ له أو يكتب من أي ناحية من نواحي الحياة فيه.
وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن عنوان الكتاب الكامل «الحلة السيراء في شعر الأمراء» ولم نجد هذا في المخطوط ولا عند الموثوق فيهم ممن كتبوا عنه، ولهذا جعلنا عنوان الكتاب «الحلة السيراء» فحسب، ولو أن إكماله بعبارة «في شعر الأمراء» معقول.
وجدير بالملاحظة أن شعر الكتاب ليس كله لأمراء بل فيه الكثير من شعر الوزراء والكتاب وأصحاب الجاه والعلماء وهذا الشعر كله جيد مما يدل على ملكة ابن الأبار كناقد للشعر عارف بالجيد منه وغير الجيد ولكن أهم من الشعر في الكتاب نثره، فهو تراجم غاية في الفائدة لعدد كبير من الشخصيات التاريخية في المغرب والأندلس من القرن الأول الهجري إلى القرن السابع مع مادة تاريخية لا بأس بها عن أعلام مشارقة من أهل القرن الأول كان لهم صيت في فتوح المغرب والأندلس.
وفي كل هذه المواد يبدو لنا ابن الأبار مؤرخا فحلا واسع الاطلاع نافذ النظر صادق الحكم وإذا استثنينا بعض المواد الأولى التي ينسب فيها ابن الأبار شعرا إلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، وبعض أجزاء الباب الأخير الخاص بمن لم يؤثر عنه شعر، تبينا أن مادة التراجم كلها متعادلة من حيث القيمة والغزارة والأصالة، غنية بكل ما ينفع المؤرخ ولا أذكر أني قرأت لغير ابن الأبار في الأندلس شيئا يدل على سعة النظر على هذه الصورة، فهو متمكن غزير المادة سواء كتب عن خلفاء بني العباس أم أمراء الأندلس وخلفائها أو أمراء الطوائف ومن عاصرهم، وهو ليس غزير المادة فحسب، بل ناقدا لا يمر بخطاء في تاريخ أو اسم إلا استدرك عليه، وتبدو منه بدوات هنا وهناك تدل على أنه كان بالفعل من أعلم الناس بتاريخ المسلمين السياسي والعلمي والأدبي.
ومن حسن الحظ أن ابن الأبار تخلص من السجع بعد فراغه من فاتحة الكتاب فجاء
أسلوبه قويما رصينا بليغا يرتفع إلى أعلى مستويات أساليب العربية الصافية وأسلوبه هذا أشبه أسلوبه في «إعتاب الكتاب».
حقق الكتاب وقدم له معرفا بابن الأبار وعصره وتآليفه الدكتور حسين مؤنس الباحث المؤرخ المشهور، وطبع بالقاهرة سنة 1963 في جزءين.
14 - خضراء السندس في شعراء الأندلس من أول فتحها إلى آخر عمره.
15 - درر السمط في خبر السبط على طريقة أبي الفرج بن الجوزي (كذا في الذيل والتكملة) قال ابن الأحمر. لكنه تشتم (منه) رائحة التشيع، وتستطلع منه أنباء الشقاوة إذ تمنعه عن الطعن والتضيع ط. بتحقيق محسن جمال الدين عمارة، مط.
المعارف بغداد 1974، 14 ص مستل من مجلة البلاغ ع 5 س 4 و 5 (مجلة المورد العراقية ج 2 مجلد 10، ص 451، 1981).
ولعل ابن الأبار في كتابيه «درر السمط» و «معدن اللجين في مراثي الحسين» أبدى عطفا لما أصاب أهل البيت من ظلم وتنكيل لذلك قال من قال: إنهما تشتم منهما رائحة التشيع وابن الأبار لم يكن شيعيا بالمعنى الاصطلاحي المعروف، ولا دائنا بمذهب من مذاهب الشيعة من النص الجلي على إمامة علي، والقول بالرجعة، ولو كان شيعيا دائنا بما سبق ذكره لاستغل الفرصة خصومه وأضداده للطعن عليه والحط منه والازدراء به ولكان سببا في تبرير قتله.
وصلتنا من هذا الكتاب نسخة خطية وحيدة تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري، وكان السيد عامر غديرة قد حققها وترجمها للفرنسية وأعدها للطبع وقدمها لنيل ديبلوم الدراسات العليا بباريس.
16 - ديوان شعر على الحروف.
17 - شرح صحيح البخاري - قال ابن عبد الملك المراكشي: «كان قد شرع فيه فعاقه عن إتمامه ما ختم به محتوم حمامه».
18 - الشفاء في تمييز الثقات من الضعفاء، مقصور على أهل الأندلس.
19 - فضالة العباب ونفاضة العياب - في أرجوزة ابن سيدة ومن نحا منحاه في ما أسمك على حروف المعجم.
20 - قصد السبيل في ورد السلسبيل، في المواعظ والزهد - أربعة مجلدات.
21 - قطع الرياض في بديع الأغراض، مجلدان ضخمان.
22 - المأخذ الصالح في حديث معاوية بن صالح في أخباره ورواياته، وربما كان من أوائل مؤلفاته (ينظر المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي ص 186).
23 - مجموع رسائله.
24 - مختصر أحكام ابن أبي زمنين.
25 - مظاهرة السعي الجميل ومحاذرة المرعى الوبيل في معارضة ملقى السبيل لأبي العلاء المعري. قال ابن عبد الملك المراكشي «على حروف المعجم نظم ما ينثر بعد نثر ما ينظم» نشره الدكتور صلاح الدين المنجد ضمن سلسلة «رسائل ونصوص» رقم 3 ط دار الكتاب الجديد بيروت 1963.
26 - معجم أصحاب أبي داود الهاشمي.
27 - معجم أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي.
وهو كتاب في تراجم الرواة عن القاضي الشهيد أبي علي الحسين بن محمد بن فيرة الصدفي يعرف بابن سكرة وابن دراج السرقسطي، فقد في حرب كتندة سنة 514/ 1121 رتب ابن الأبار الأسماء فيه على حروف المعجم على طريقة الأندلسيين والمغاربة. وقد سبقه القاضي عياض إلى جمع معجم في شيوخ شيخه أبي علي الصدفي فتممه وزاد عليه، قال ابن الأبار في مقدمة هذا الكتاب «وبعد فهؤلاء الرواة عن القاضي أبي علي بن سكرة الصدفي السرقسطي ويعرف بابن دراج، سموت إلى جمع أسمائهم وأبيات من مكانهم مما أمكن ذكره من أنبائهم مباهيا بهم وبعصرهم، ومناغيا أبا الفضل عياض في جمع شيوخه وحصرهم، ولا غرو فنحوه في المعجم الذي صنع نحوت، وفوز قدمي بإخلاص كرمي رجوت، ليكون هذا لذلك تتمة وليهون الوقوف عليهم مؤتمن وأيمة، وهم بين صاحب في الأخذ عنه راغب، وتلميذ على السماع منه راتب، ومن شيوخه من شذ، واعتقده في وقته الفذ، فكتب من روايته، وخصه بحظ من عنايته، ذلك لاختصاصه بقربة هي ما هي، ورتبة في العدالة بلغت التناهي».
«وابن الأبار في «المعجم» دقيق الدقة كلها دقيق في رسم الأسماء وتواريخ الميلاد وتعدد الشيوخ، ودقيق أيضا في المنهج الذي اتبعه فهو يرتب أسماء المترجم لهم على حروف المعجم مع بعض اختلاف قليل مقصود كإيراد اسم أحمد قبل إبراهيم، وهو بعد أن يفرغ من حرف يحصي عدد من ذكرهم فيه وإذا أهمل حرفا ينبه إلى أنه لم يجد فيه «معروفا من هؤلاء الرواة ولا مكثرا» أو «ليس في هؤلاء الرواة من أول اسمه دال أو ذال» وعدة المذكورين في الحروف الثلاثة: الجيم والحاء والخاء ثلاثة عشر منهم في «التكملة» تسعة رجال «وعدد التراجم التي في هذا المعجم 315.
وترجم لبعض الغرباء الوافدين على الأندلس كأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد النفطي ويعرف بابن الصائغ، دخل الأندلس وله رحلة إلى المشرق، وعمر بن أحمد بن عبد الله بن أحمد التوزري نزيل بجاية، وعلي بن عبد الله بن داود اللمائي المعروف بالمالطي نزيل المهدية.
ويذكر أحيانا عقب الترجمة حديثا يرويه عن شيخه أبي علي الصدفي بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين أبو علي أحيانا ما فيه من علو. ويذكر في الترجمة من روى عن المترجم له والتراجم تختلف طولا وقصرا، فبعضها لا يتجاوز بضعة أسطر وبعضها في نحو الصفحة والنصف هذا إلى ضبط في الألقاب والأنساب وتفسير معناها إن كان أصلها غير عربي وتحديد مكان البلد الذي ينتمي إليه المترجم له، ولا يهمل ذكر مؤلفات المترجم له.
والكتاب ألفه ببلنسية، وربما زاد فيه زيادات بعد خروجه منها على ما يستفاد من ترجمة يعقوب بن حماد الأغماتي من أهل تلمسان وذلك عند الكلام عن سند حديث كأن يقول: «وقد حدثني القاضي أبو الخطاب بن واجب بجامع بلنسية جبرها الله » وهذه الجملة ربما توحي بأنها سقطت بأيدي العدو.
والمعجم نشره فرانشيسكو كوديرا وطبع بمدريد سنة 1886 وأعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى ببغداد بدون تاريخ.
27 - معجم أصحاب أبي علي الغساني.
28 - معجم أصحاب أبي عمر بن عبد الله.
29 - معجم أصحاب أبي عمرو المقري.
30 - معجم شيوخ أبي الحسين أحمد بن محمد بن السراج.
31 - معجم شيوخه.
32 - معدن اللجين في مراثي الحسين قال الغبريني «ولو لم يكن له من التآليف إلا الكتاب المسمى بكتاب اللجين في مراثي الحسين لكفاه».
33 - المورد المسلسل في حديث الرحمة المسلسل.
«وهذا الحديث قد رويته مسلسلا من طرق مذكورة في غير هذا الموضع، وكلفني من أوجب حقه وأوثر وفقه تخريج أسانيده فيه وجمع طرقه المتصلة فاجتمع لي من ذلك جزء رسمته بالمورد المسلسل في حديث الرحمة المسلسل. ولعله من أوائل مؤلفاته.
34 - هداية المتعسف في المؤتلف والمختلف، مقصور على أهل الأندلس.
35 - الوشي القيسي في اختصار الفيح القسي والأصل للعماد الكاتب الأصبهان.
وقد خص ابن الأبار بتآليف الدكتور المرحوم عبد العزيز عبد المجيد: ابن الأبار حياته وكتبه في 384 ص ط بتطوان 1951.
المصادر والمراجع:
- اتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف 1/ 161.
- أزهار الرياض للمقري 3/ 205.
- الأعلام للزركلي 7/ 110، 110، 10/ 209.
- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى لابن سعيد الأندلسي اختصره محمد بن عبد الله بن خليل تحقيق إبراهيم الأبياري (ط القاهرة 1959) ص 191، 197.
- إيضاح المكنون 1/ 97، 107، 148، 419؛ 2/ 205، 235، 236.
- كشف الظنون 372.
- بلاد البربر الشرقية في عصر الحفصيين لروبير برانشفيك (بالفرنسية) 2/ 184.
- تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 3/ 84، 177.
- تاريخ ابن خلدون 6/ 283، 285.
- تاريخ الدولتين للزركشي (ط تونس 1289) ص 20، 21، 27.
- تاريخ الفكر الأندلسي تأليف جنثالث بلنثيا، نقله عن الاسبانية حسين مؤنس (ط مصر 1955) ص 274، 280.
- تذكرة الحفاظ للذهبي 4/ 1461.
- الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي 6/ 253، 275 (أورد القصيدة السينية كاملة وقطعا من شعره ونثره وقائمة بأسماء مؤلفاته).
- ذيل مرآة الزمان للقطب اليونيني 2/ 173.
- شجرة النور الزكية 195، 196.
- شذرات الذهب 5/ 295.
- العبر للذهبي 5/ 245.
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأحمد الغبريني تحقيق رابح بونار (ط الجزائر 1970) ص 207.
- الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية لابن القنفذ القسنطيني تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي (ط تونس 1966) ص 116، 126، 127 تعليقات المحققين في آخر الكتاب ص 232، 233.
- فهرس الفهارس والإثبات لعبد الحي الكتاني 1/ 99.
- فهرس معجم شيوخ الدمياطي لجورج فاجدا (بالفرنسية) ص 109.
- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (ط محمد محيي الدين عبد الحميد) 2/ 450، 452.
- كشف الظنون 1/ 286، 372.
- مستودع العلامة ومستبدع العلامة لأبي الوليد بن الأحمر (المط المهدية بتطوان المغرب الأقصى سنة 1384/ 1964) ص 128.
- معجم المطبوعات 1/ 26، 27.
- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 10/ 204.
- مقدمة إعتاب الكتاب للدكتور صالح الأشتر.
- مقدمة الحلة السيراء للدكتور حسين مؤنس.
- مقدمة المقتضب من تحفة القادم للأستاذ إبراهيم الأبياري.
- نفح الطيب تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 3/ 348، 350.
- هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي 2/ 27.
- الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي 1/ 355، 358.
- الوفيات لابن قنفذ ص 50.
- دائرة المعارف الإسلامية (ط جديدة بالفرنسية) 2/ 694 - 695.
دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان-ط 2( 1994) , ج: 1- ص: 12
ابن الأبار الأندلسي اسمه محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن ويطلق ابن الأبار أيضا على أبي جعفر أحمد بن محمد الخولاني شاعر أمير إشبيلية.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 2- ص: 257
الشيخ الحافظ محمد بن عبد الله بن أبي بكر الشيخ الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي المعروف بتبن الآبار الأندلسي
ولد في بلنسية في ربيع الثاني عام 595 ومات صبيحة الأربعاء 20 المحرم سنة 658 جاء في دائرة المعارف الإسلامية تعريب محمد ثابت وأحمد الشتناوي وإبراهيم زكي وعبد الحميد يونس: مؤرخ ومحدث وأديب وشاعر عربي أصله من (أندة) أرض بني قضاعة بالأندلس تلقى العلم على أبي عبد الله بن نوح وأبي جعفر الحصار وأبي الخطاب بن واجب وأبي الحسن بن (خيرة) وأبي سليمان بن حوط وأبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن سعادة وغيرهم وظل أكثر من عشرين عاما على اتصال وثيق بأبي الربيع بن سالم أعظم محدثي الأندلس وهو الذي حبب إليه إتمام كتاب الصلة لابن بشكوال وكان كذلك كاتم سر حاكم بالنسية أبي عبد الله محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن علي ثم كاتم سر أبيه أبي زيد وأخيرا كاتم سر زيان بن مردنيش ولما حاصر ملك أرجونة دون جايم مدينة بلنسية في رمضان عام 635 أرسل ابن الآبار في مهمة سياسية إلى سلطان تونس أبي زكريا ويحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص ليقدم إليه وثيقة يعترف فيها سكان بلنسية وأميرها بسيادة الدولة الحفصية فقابل السلطان في اربعة المحرم سنة 663 وأنشده قصيدة سينية يلتمس فيها مساعدته للمسلمين بالأندلس ثم رجع إلى بلنسية ثم غادرها مع أسرته إلى تونس قبل سقوط بلنسية في أيدي المسيحين أو بعده بأيام قلائل وذلك في صفر سنة 636 وقال الغبريني أنه ذهب أولا إلى بجاية فاشتغل بالتدريس مدة وأحسن سلطان تونس استقباله وأصبح كاتم سره وناط به رسم طغرائه في أعلى الرسائل والمنشورات السلطانية ثم عزل وولي مكانه أبو العباس الغساني وكان لا يشق له غبار في كتابة الخطوط الشرقية التي كان السلطان يفضلها على الخط المغربي وغاظ ذلك ابن الآبار وظل رغما من التحذير المتكرر يضع الطغراء السلطاني على الوثائق التي يكتبها واعتكف في داره وألف كتابه المسمى أعتاب الكتاب وأهداه إلى السلطان فعفى عنه وأعاده إلى منصبه ولما مات أبو زكريا وخلفه ابنه المستنصر قرب ابن الآبار واستمع إلى نصحه ثم غضب منه فعذبه وصادر مصنفاته فوجد بينها قصيدة في هجاء السلطان فأمر أن يقتل طعنا بالحراب ثم أحرق جسده ومصنفاته وأشعاره وإجازاته العلمية في محرقة واحدة. وألف ابن الآبار عدة كتب في التاريخ والحديث والأدب والشعر لم يبق منها إلا المؤلفات الآتية:
(1) كتاب التكملة لكتاب الصلة طبع في مجريط.
(2) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي طبع في مجريط.
(3) الحلة السيراء طبع بعضها في ليدن.
(4) تحفة القادم.
(5) أعتاب الكتاب ’’اه’’.
وذكره أحمد المقري المغربي في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب كما ذكرناه ولم يذكر اسمه وذكر له رسالة خاطب بها الكاتب البارع القاضي أبا المطرف بن عميرة المخزومي وقال وهي من غرض ما نحن فيه فلنقتبس نور البلاغة منها وذكر جواب أبي المطرف عنها وذكر أيضا إن لابن الآبار كتابا اسمه درر السمط في خبر السبط وأورد منه فصولا ثم قال انتهى ما سنح لي ذكره من درر السمط وهو كتاب غاية في بابه ولم أورد منه غير ما ذكرته لأن في الباقي ما تشم منه رائحة التشيع والله سبحانه يسامحه بمنه وكرمه ولطفه ثم قال وقد عرفت بابن الآبار في أزهار الرياض بما لا مزيد عليه ’’اه’’ ولم يتيسر لنا الإطلاع على أزهار الرياض لنعلم ما ذكره في حقه أما رسالة الحافظ ابن الآبار التي خاطب بها المطرف فتذكر فقرات منها وهي كجوابها مسجعة على عادة أهل ذلك العصر من جلتها: الحديث عن القديم شجون والشأن بتقاضي الغريم شؤون فلا غرو أن أطارحه إياه وأفاتحه الأمل في لقياه أبت البلاغة إلا عمادها ومع ذلك فسأنبئ عمادها درجت اللدات والأتراب وخرجت الروم بنا إلى حيث الأعراب أيام دفعنا لأعظم الأخطار وفجعنا بالأوطان والأوطار فألام نداري برح الألم وحتام نساري النجم في الظلم جمع أوصاب ماله من انفضاض ومضض اغتراب شذ عن ابن مضاض فلو سمع الأول بهذا الحارث ما ضرب المثل بالحارث فيا لله من جلاء ليس به يدان وثناء قلما يسفر عن تدان هؤلاء الإخوان بين هائم بالسرى ونائم في الثرى وأما الأوطان المحبب عهدها بحكم الشباب المشبب فيها بمحاسن الأحباب فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد وأخنى عليها الذي أخنى على لبد أسلمها الإسلام وانتظمها الإنثار والأصطلام.
كزعزع الريح صك الدوح عاصفها | فلم يدع من جنى فيها ولا غصن |
واها وواها يموت الصبر بينهما | موت المحامد بين البخل والجبن |
قال صاحب نفح الطيب
وقد رأيت أن أثبت هنا رسالة خاطب بها الكاتب البارع القاضي أبو المطرف بن عميرة المخزومي الشيخ الحافظ أبا عبد الله بن الآبار (جوابا عن رسالته السابقة) يذكر له أخذ العدو مدينة بلنسية، ونحن نذكر منها بعض فقرات تتعلق بوصف ابن الآبار وأخذ بلنسية قال: أيها الأخ الذي دهش ناظري لكتابه بعد أن دهش خاطري من أغبابه فبورك فيه أحوذيا وصل رحمه وكسا منظره من البهجة ما كان حرمه وأبان والبيان لا تنجاب عنه ديمته ولا تغلو بغير قلمه قيمته فمهلا أيها الموفي على علمه النافث بسحر قلمه أتظن منزلتك في البلاغة ومهيعها لأحب ومنزعها بالعقول لاعب تسفل وقد ترفعت أو تخفى وإن تلفعت عرفناك يا سودة وشهرت حلة عطارد الملاحة والجودة طارحني حديث مورد جف وقطين خف فيالله لأتراب درجوا وأصحاب عن الأوطان خرجوا قصت الأجنحة وقيل طيروا وإنما هو القتل أو الأسر أو تسيروا فتفرقوا أيدي سبا وانتشروا ملء الوهاد والربى ففي كل جانب عويل وزفرة وبكل صدر غليل وحسرة ولكل عين عبرة لا ترفأ من أجلها عبرة وهي بلنسية ذات الحسن والبهجة والرونق وما لبث أن أخرس من مسجدها لسان الأذان وأخرج من جسدها روح الإيمان فأين تلك الخمائل ونضرتها والجداول وخضرتها راجعت سيدي مؤديا ما يجب أداؤه ومقتديا وما كل أحد بحسن اقتداؤه وإنما ناضلت ثعليا وعهدي بالنضال قديم وناظرت جدليا وما عندي للمقال تقديم أتم الله عليه آلاءه وحفظ مودته وولاءه ومتع بخلته الكريمة إخلاءه بمنه والسلام. (ثم قال ف ينفح الطبيب): رأيت هنا أن أذكر فصولا مجموعة من كلامه في كتابه المسمى بدرر السمط في خبر السبط قال رحمه الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فروع النبوة والرسالة وينابيع السماحة والبسالة صفوة آل أبي طالب وسراة بني لؤي بن غالب الذي جاءهم الروح الأمين وحلاهم الكتاب المبين فقل في قوم شرعوا الدين القيم ومنعوا اليتيم أن يقهر والإيم ما قد من أديم آدم أطيب من أبيهم طينة ولا أخذت الأرض أجمل من مساعيهم زينة لولاهم ما عبد الرحمن ولا عهد الإيمان سراة محلتهم سر المطلوب وقرارة محبتهم حبات القلوب أذهب الله عنهم الرجس وشرف بخلقهم الجنس فإن تميزوا فشريعتهم البيضاء أو تحيزوا فلعشيرتهم الحمراء من كل يعسوب الكتيبة منسوب لنحيب ونحيبة نجاره الكرم وداره الحرم.
نمته العرانين من هاشم | إلى النسب الأصرح الأوضح |
إلى نعبة فرعها في السماء | ومغرسها سرة الأبطح |
(فصل) ما كانت خديجة لتأتي بخداج ولا الزهراء لتلد إلا أزاهر كالسراج مثل لنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا خلدت بنت خويلد ليزكو عقبها من الحاشر العاقب ويسمو مرقبها على النجم الثاقب (فصل) إلى البتول سير بالشرف التالد وسبق الفخر بالأم الكريمة والوالد وأبيها أن أم أبيها لا تجد لها شبيها نثرة النبي وطلبة الوصي وذات الشرف المستوي على الأمد القصي كل ولد الرسول درج في حياته وحملت هي ما حملت من آياته ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لا فرع للشجرة المباركة من سواها فهل جدوى أوفر من جدواها الله أعلم حيث يجعل رسالته حفت بالتطهير والتكريم وزفت إلى الكفو الكريم فوردا صفو العارفة والمنة وولدا سيدي شباب أهل الجنة عوضت من الأمتعة الفاخرة بسيدي الدنيا والآخرة فصاهره الشرع وخا لله وقال بعض صعلوك لا مال له نرفع درجات من نشاء (فصل).
أتنتهب الأيام أفلاذ أحمد | وأفلاذ من عاداهم تتودد |
ويضحي ويظمى أحمد وبناته | وبنت زياد ودها لا يصرد |
أفي دينه في أمنه في بلاده | تضيق عليهم فسحة تتورد |
وما الدين إلا دين جدهم الذي | به أصدروا في العالمين وأوردوا |
ولا يخفى أن رائحة التشيع العطرية ونفحاته المسكية مشمومة مما أورده أيضا لظهوره في إخلاصه في حب أهل البيت الطاهر واعترافه بفضلهم الباهر الذي قلما يطيق كثير من الألسن ذكره أو تستطيع نشره ولا شك أن ما تركه تحرجا وتأثما حتى كأنه من الموبقات رائحة التشيع العطرية منه فائحة، وبعض المخلوقات لا يستطيع شم طيب الرائحة، فتشيع ابن الآبار ظاهر على ما رغم ما في رسالته السابقة إلى ابن المطرف من قوله من معاداة الشيعة وموالاة الشريعة إذ أنه كلام لا يخلو من إجمال موجب لتطرق الاحتمال بشاهد الحال وغيره في الدلالة على تشيع الرجل أوضح وأصرح.
وهناك رجل يعرف بابن الآبار وهو أبو جعفر أحمد بن محمد الخولاني شاعر أمير أشبيلية توفي عام 433 وله كما في كشف الظنون غير ديوانه أربعة مؤلفات تنسب عادة إلى صاحب الترجمة والظاهر أن المعروف بابن الآبار هو المترجم هذا.
وقال محمد عبد الله عنان:
يعتبر من أعظم شخصيات التاريخ الأندلسي، في تلك المرحلة القائمة من مراحله، مرحلة التفكك والانهيار والسقوط.
ونحن لا نقصد في هذا المقال، أن نقدم ترجمة كاملة لحياة ابن الآبار، ولا أن نتحدث عنه كفقيه راسخ، أو كاتب بلغ ذروة البيان، أو شاعر مبدع مبك، أو مؤرخ محقق، ما زالت آثاره وتراجمه، أهم وأوثق مصادرنا عن حوادث عصره، ورجالات عصره، ولكنه نريد فقط أن نقدم بعض صفحات عن حياته السياسية والدبلوماسية، التي اقترنت بأهم حوادث عصره، والتي جعلت منه شخصية تاريخية بارزة، تفوق في أهميتها، وفي الأدوار التي قامت بها، شخصيات أمراء هذا العصر وسادته
ويكفي أن نقول في نشأة ابن الآبار، إنه ولد بثغر بلنسية، أعظم وأجمل حواضر شرقي الأندلس، في سنة 595ه (1199م)، في بيت علم ونبل، وأصلهم من أندة الواقعة على مقربة من غربي بلنسية، والتي انتسب إليها كثير من أكابر العلماء، ودرس ابن الآبار الحديث والفقه، وبرع في اللغة والأدب، وشغف بالأخبار والسير، ثم رحل في مطلع شبابه إلى غربي الأندلس فزار قرطبة، ثم اشبيلية، وهو يأخذ أينما حل عن أساتذة العصر، ولما توفي أبوه في سنة 619 ه، كان هو ما يزال بغربي الأندلس، في مدينة بطيوس، عاكفا على دراساته، فعاد عندئذ إلى بلنسية، ومثوى أسرته
وكانت الحوادث في شرقي الأندلس، قد أخذت في هذا الوقت بالذات تؤذن بتطورات خطيرة، ونحن نعرف أن الأندلس كانت ما تزال حتى الوقت ولاية مغربية تحت حكم الخلافة الموحدية، ولكن الدولة الموحدبة، كانت قد بدأت قبل ذلك بقليل، منذ موقعة العقاب المشئومة (سنة 609ه-1212م) التي سحقت فيها الجيوش الموحدية، على يد الجيوش الأسبانية المتحدة، تدخل في دور انحلالها، وبدأ سلطانها بالأندلس، يهتز تحت ضربات الحركات القومية المحلية، وكان شرقي الأندلس بالأخص مسرحا لموجة جديدة من الصراع بين القوى الوطنية، والسيادة الموحدية.
وكان والي بلنسية يومئذ هو السيد أبا عبد الله محمد بن يوسف بن عبد المؤمن.
ولدينا ما يدل على أن ابن الآبار، عقب عودته من منطقة الغرب، قد تولى منصب الكتابة لهذا السيد، ولكن السيد أبا عبد الله توفي بعد ذلك بقليل في سنة 620ه، وقام في ولاية بلنسية مكانه ولده السيد عبد الرحمن، فاستمر ابن الآبار في منصبه كاتبا للوالي الجديد، وزادت حظوته ومكانته، ولم يلبث أن غدا موضع ثقة السيد وتقديره
وكان سلطان الموحدين، في هذه المنطقة من الأندلس، منطقة الشرق، أضعف منه في أية منطقة أخرى، أولا لنأيها وبعدها عن مركز الحكومة العامة باشبيلية، وثانيا لأن منطقة الشرق، كان منذ أيام زعيم الشرق محمد بن سعد بن مردنيش، قبل ذلك بنحو سبعين عاما، مركزا لأعنف ثورة وطنية أندلسية، اضطرمت ضد الموحدين، ومن ثم، فإنه لما انهارت قوى الموحدين العسكرية بالأندلس على أثر موقعة العقاب، عادت بوادر الثورة والاضطراب من جديد تعمل في منطقة الشرق، وكانت مرسية، وهي حاضرة الشرق الجنوبية، أول مسرح لانفجار الثورة الوطنية، فقام بها محمد بن يوسف بن هود، واستطاع أن ينتزع السلطة من حاكمها الموحدي السيد أبي العباس (سنة 625ه).
وشعر السيد أبو زيد والي بلنسية بخطورة هذه الحركة، فسار في قواته لمقاتلة ابن هود، ولكن ابن هود هزمه، فأرتد مفلولا إلى بلنسية وهو يستشعر سوء المصير.
ذلك إنه لم تمض على ذلك أشهر قلائل، حتى ظهر صدى الحوادث في بلنسية ذاتها، وأضطرم أهل بلنسية بالثورة ضد الموحدين، واتجهوا إلى الانضواء تحت زعامة الرئيس أبي جميل زيان بن مدافع بن مردنيش وزير السيد وكبير بطانته وكان الرئيس زيان، وهو سليل آل مردنيش، جملة لواء الثورة الوطنية من قديم ضد الموحدين، هو الزعيم الطبيعي لمثل تلك الحركة، وكان من أثر ذلك إن وقعت الوحشة بين الوالي السيد أبي زيد، وبين وزيره الرئيس زيان، وخشى زيان من نقمة السيد، فارتد في أهله إلى حصن أندة القريب وامتنع به، وهو يرقب سير الحوادث.
وعندئذ اشتد الهياج في بلنسية، وهتف الشعب برياسة زيان، وخشى السيد أبو زيد بدوره البادرة على نفسه، ولم يجد سبيلا لمدافعة هذه الثورة الجارفة، فغادر بلنسية في أهله وأمواله، ومعه كاتبه ابن الآبار، والتجأ إلى بعض الحصون القريبة، وكان خروج السيد أبي زيد من بلنسية في شهر صفر سنة 626هه (1219). وعلى أثر خروجه دخل الرئيس أبو جميل زيان بلنسية ونزل بالقصر، ودعا للخليفة العباسي، واستقبله الشعب بأعظم مظاهر الحماسة والترحيب.
ولبث السيد أبو زيد مدى حين بمقره على مقربة من بلنسية، فلما رأى تطور الأمور على هذا النحو، ولما لم يجد سبيلا إلى استرداد سلطانه عول على أن يلتجئ إلى خايمي الأول ملك أراجون، وكان يعقد بلاطه يومئذ بقلعة أيوب، فسار إليه ومعه كاتبه ابن الآبار.
وهنا تبدأ تلك الصفحات المشجية من حياة ابن الآبار الدبلوماسية، وقد وقفنا في أحد مخطوطات الأسكوريال على هذين البيتين، اللذين أنشدهما ابن الأبار حين مغادرته لبلنسية مع مخدومه السيد أبي زيد، وهما:
الحمد لله لا أهل ’’ولا ولد | ولا قرار ولا صبر’’ ولا جلد |
كان الزمان لنا سلما إلى أمد | فعاد حربا لنا لما انقضى الأمد |
والحقيقة إن هذا الأمير الموحدي السيد أبا زيد كان ينوي أن يذهب في ارتمائه في أحضان النصارى، إلى أبعد مدى يمكن تصوره، وكان خايمي الأول ملك أراجون، من جانبه يحاول أن يجتني لقاء معاونة الأمير المسلم، أقصى ما يمكن اجتناؤه من أشلاء الأندلس، وكانت بلنسية بالذات هي أعز أمانيه، وتاج أطماعه، ومن ثم فقد عقدت بين الأمير الموحدي وملك أراجون، معاهدة صداقة وتحالف، تقضي بأن يسلم الأمير الموحدي إليه جزءا مما يفتتحه من الأراضي والحصون الإسلامية، وأن يحتفظ الملك خايمي كذلك بكل ما يقوم بافتتاحه هو من الأراضي والحصون لنفسه، وإن يسلم إليه السيد أبو زيد عدة حصون وبلاد هامة في منطقة بلنسية رهينة بولائه، وأن يقوم ملك أراجون لقاء ذلك بحماية السيد والدفاع عنه ضد أعدائه
وليست لدينا تفاصيل عن الدور الذي أداه ابن الأبار، في عقد هذه المعاهدة، ولكن يبدو لنا من تصرفه اللاحق، أنه لم يكن راضيا عن هذا التسليم المزري، الذي عمد إليه السيد أبو زيد، في أراضي الوطن الأندلسي وحصونه، تحقيقا لأطماعه الشخصية. بل يلوح لنا إن كان فوق ذلك على علم بما ينتويه السيد من خطوات لاحقة، أبعد مدى وأشد إيلاما للنفس. ذلك أن ابن الأبار ما لبث أن غادر مخدومه السيد أبا زيد، وعاد مسرعا إلى بلنسية، وهناك التحقق بخدمة أمير بلنسية الجدبد أبي جميل زيان، وتولى منصب كتابته، وكان ابن الأبار قد ظهر في هذا أحميدان ببلاغته الأخاذة وبيانه الرائع.
أما السيد أبو زيد، فقد ذهب في مغامراته إلى حد اعتناقه، دين النصرانية واتخذ
اسما نصرانيا وهو بشنتى Vicente أو بجنب بالعربية يسمى في الوثائق النصرانية بثنتى ملك بلنسية وحفيد أمير المؤمنين وتجمع الرواية الإسلامية على صحة واقعة تنصر هذا السيد الموحدي، وتنحى عليه بأشد ضروب الإنكار واللوم.
ولقد كان ابن الأبار صادق الحس، بعيد النظر، حينما ترك مخدومه الضال لمصيره المحزن، ومن المحقق أنه نبذ في ذلك كل إغراء، وكل وعود براقة، ولم يقبل أن يتورط لحظة، فيما يعتبره خيانة لوطنه وأمته ودينه0
كانت هذه التجربة الأليمة أول عهد ابن الأبار بالمغامرات الدبلوماسية، بيد أن القدر كان يدخره لمهام دبلوماسية أخرى، أشد إيلاما للنفس، وأبعث إلى الحسرة والأسى.
ذلك أن صرح الأندلس القديم الشامخ. قد أخذ في تلك الآونة العصيبة يهتز ويتداعى، أجل أن قوى الأندلس المفككة، كانت عندئذ تحاول أن تجتمع في الشرق تحت زعامة المتوكل بن هود، وفي الوسط والجنوب تحن زعامة محمد بن الأحمر، ولكن هذه الزعامات المحلية الجديدة، لم تكن تستطيع، والفتنة تمزق أوصال الأندلس، أن تصمد بمواردها المحدودة في وجه أسبانيا النصرانية، وكان خايمي الأول ملك أراجون، وفراناندو الثالث ملك قشتالة، يرقب كل منهما فرصته، لانتزاع ما يمكن انتزاعه من أشلاء الأندلس الممزقة.
وشاء القدر أن يكون ملك قشتالة هو السابق بانتزاع كبرى قواعد الأندلس التالدة - فاستولى على قرطبة عاصمة الخلافة القديمة في شوال ينة 633ه(يونيه 1226م).
وأخذ نلك أراجون من جانبه يمهد للإستيلاء على بلنسية، وذلك بانتزاع حصونها الأمامية شيئا فشيا، كل ذلك وزيان أمير بلنسية يقاوم الأرجويين ما استطاع. وأخيرا مزقت قوى البلنسيين في معركة أنيشه الحاسمة على مقربة من بلنسية (سنة 634ه).
وامتنع زيان بفلوله داخل الثغر العظيم، وعول ذلك أراجون على أن يأخذ بلنسية بالحصار والمطاولة، فجمع جيشا مختارا من فرسان الداوية والأستبارية والأرجويين والقطلان والمتطوعة الفرنسيين، وسار إلى بلنسية، وطوقها بقواته من البر، وضرب محتله بينها وبين البحر، لكي يقطع سائر علائقها مع الخارج، وبدأ هذا الحصار الشهير في رمضان سنة 635 ه (أبريل 1238م).
في تلك الآونة العصيبة، اتجهت أنظار الأمير زيان، بتوجيه وزيره وكاتبه ابن الأبار إلى إخوانه المسلمين في الضفة الأخرى من البحر، إلى مملكة إفريقية (تونس) الفتية القوية أو مملكة بني حفص، وكان عاهلها الأمير زكريا ابن أبي حفص قد استطاع أن يجعل منها في فترة قصيرة قوة زاخرة يحسب حسابها، وبعث زيان إلى أمير افريقية سفارة على رأسها وزيره وكاتبه ابن الأبار، يحمل إليه بيعته وبيعة أهل بلنسة، وصريخه بسرعة الغوث والأنجاد قبل أن يفوت الوقت، ويسقط الثغر الأندلسي العظيم في أيدي النصارى.
ولما وصل ابن الأبار إلى تونس، مثل بين يدي سلطانها الأمير أبي زكريا الحفصي، في حفل مشهود، وألقى قصيدته السينية الرائعة، التي اشتهرت في التاريخ، كما اشتهرت في الشعر، يستصرخه فيها لنصرة الأندلس، ونصرة الدين وهذا مطلعها:
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا | إن السبيل إلى منجاتها درسا |
وهب لها من عزيز النصر ما التمست | فلم يزل منك عز النصر ملتمسا |
وحاش ما تعانيه حشاشتها | فطالما ذاقت البلوى صباح مسا |
يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا | للحادثات وأمسى جدها تعسا |
في كل شارقة إلمام بائعة | يعود مأتمها عند العدا عرسا |
وكل غاربة أجحاف نائبة | تثني الأمان حذارا والسرور أسى |
تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم | ولا عقائلها المحجوبة الأنسا |
وفي بلنسية منها وقرطبة | ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا |
مدائن حلها الأشراك مبتسما | جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا |
وحيرتها العوادي العابثات بها | يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا |
فكان لإنشاد هذه القصيدة المبكية التي ما زالت تحتفظ حتى يومنا برنينها المحزن، والتي كانت كأنها نفثة الأندلس الجريح، أبلغ الأثر في نفس الأمير أبي زكريا، فبادر بتجهيز أسطول، شحنه بالسلاح والأطعمة والكسى والأموال، وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه
ولكن هذه السفن المنشودة لم توفق إلى تحقيق هدفها، لأنها لم تستطع أن تصل إلى مياه الثغر المحصور بأية وسيلة، وطاردتها السفن الأرجونية، فاضطرت أن تفرغ شحنتها في ثغر دانية وإن تعود أدراجها إلى تونس، واستطاع ابن الأبار ورفاقه أن يجوزوا إلى مدينتهم، وتركت بلنسية لقضائها المحتوم.
وهنا شدد الأرجونيون الحصار على المدينة، بالرغم مما بذله الأمير زيان وقواته من ضروب الإقدام والبسالة، في مدافعة الجيش المحاصر، فقد كان من الواضح أنه لا نفر من التسليم، إذا أريد أن تنجو المدينة من العبث والتخريب، ومن ثم فقد بدأت المفاوضة بين زيان وملك أراجون في شروط التسليم، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن تسلم المدينة صلحا.
وإليك كيف يصف لنا ابن الأبار، وقد كان شاهد عيان ما تلا ذلك من لقاء بين الأمير زيان والملك خايمي، ومن إبرام شروط التسليم بينهما، في يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر سنة 636 ه قال:
’’وفي هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع ابن يوسف بن سعد الجذامي من المدينة، وهو يومئذ أميرها، في أهل بيته ووجوه الطلبة والجند، وأقبل الطاغية وقد تزيا بأحسن زي في عظماء قومه، من حيث نزل بالرصافة أول هذه المنازلة، فتلاقيا بالولجة، واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلما لعشرين يوما، ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم، وحضرت ذلك كله، وتوليت العقد عن أبي جميل في ذلك، وابتدئ بضعفة الناس، فسيروا في البحر إلى نواحي دانية، واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا، وصبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر المذكور، وكان خروج أبي جميل بأهله من القصر في طائفة يسيرة أقامت معه، وعندئذ استولى عليها الروم أحانهم الله’’.
ودخل خايمي الفاتح وجنده ثغر بلنسية في يوم الجمعة 27 صفر سنة 636ه الموافق لليوم التاسع من أكتوبر سنة 1238م، التي سقطت في تلك الفترة، في أيدي الأسبان، وقد كان انهيار هذه القواعد الأولى من الصرح الأندلسي الشامخ مقدمة لانهيار نعظم القواعد الباقية تباعا، في فترة قصيرة، لا تجاوز العشرة الأعوام.
هكذا كان الدور المؤلم الذي لعبه ابن الأبار في حوادث سقوط بلنسية. ولقد هزت هذه المحنة مشاعره إلى الأعماق، فلم يطق أن يبقى في الوطن المنكوب، فغادر أميره وغادر الأندلس كلها وعبر البحر إلى تونس، فوصلها في أواخر سنة 636ه، وعاش حينا في كنف أميرها أبي زكريا يتولى له كتابة العلامة. ثم أخذ يتردد حينا بين تونس وبجاية، ويدرس هنا وهنالك، ولما توفي الأمير أبو زكريا في سنة 647ه وخلفه ولده المستنصر بالله، التحق ابن الأبار ببطانته العلمية، ولكنه لم يمن قريرا مطمئنا إلى هذه الحياة، لما كان يتخللها من غضب السلطان، بسبب دسائس خصومه أحيانا، وبسبب تصرفاته الشخصية النزفة أحيانا أخرى.
واستطاع خصوم ابن الأبار في النهاية أن يوقعوا به، ورفعت إلى السلطان بعض أقوال وأبيات نسبت إلى ابن الأبار طعنا في السلطان وتعريضا به، فأمر السلطان بجلده، ثم بقتله، فضرب بالسياط، ثم قتل طعنا بالرماح، وأخذت كتبه وأحرقت في موضع قتله، ووقع مصرع ابن الأبار على هذا النحو المؤسي في الحادي والعشرين من شهر المحرم سنة 658 ه (8 يناير سنة 1260م) واختتمت بذلك حياة أعظم شخصية في أدب الأندلس في القرن السابع للهجري.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 9- ص: 384
ابن الأبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر الحافظ العلامة أبو عبد الله القضاعي البلنسي الكاتب الأديب المعروف بابن الأبار وبالأبار، ولد سنة خمس وتسعين وسمع من أبيه الأبار وأبي عبد الله محمد بن نوح الغافقي وأبى الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعى الحافظ وبه تخرج وعني بالحديث وجال في الأندلس وكتب العالي والنازل وكان بصيرا بالرجال عارفا بالتاريخ إماما في العربية فقيها مقرئا أخباريا فصيحا له يد في البلاغة والإنشاء في النظم والنثر كامل الرياسة ذا جلالة وأبهة وتجمل وافر، وله من المصنفات في الحديث والتاريخ والأدب، كمل الصلة لابن بشكوال بكتاب في ثلثة أسفار قال الشيخ شمس الدين: اختصرته في مجلد واحد ومن رأى كلام الرجل علم محله من الحديث، وكان له إجازة من أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي جمرة روى عنه بها، وقتل مظلوما بتونس على يد صاحبها لأنه تخيل منه الخروج وشق العصا وقيل إن بعض أعدايه ذكر عند صاحب تونس أنه ألف تاريخا وأنه تكلم فيه في جماعة فلما طلب أحسن بالهلاك فقال للغلام: خذ البغلة وامض بها إلى حيث شئت فهي لك، وله جزء سماه درر السمط في خبر السبط ينال فيه من بني أمية ويصف عليا عليه السلام بالوحي وهذا تشيع ظاهر ولكنه إنشاء بديع، قلت: وله كتاب تحفة القادم تراجم شعراء، وكتاب إيماض البرق والحلة السيراء في أشعار الأمراء وإعتاب الكتاب أخبرني الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس أنه أملاه في ثلاثة أيام، توفى سنة ثمان وخمسين وست ماية، ومن شعره يصف المركب:
يا حبذا من بنات الماء سابحة | تطفو لما شب أهل النار تطفئه |
تطيرها الريح غربانا بأجنحة الـ | ـحمايم البيض للإشراك ترزؤه |
من كل أدهم لا يلفى به جرب | فما لراكبه بالقار يهنؤه |
يدعى غرابا وللفتخاء سرعته | وهو ابن ماء وللشاهين جؤجؤه |
مرقوم الخد مورده | يكسوني السقم مجرده |
شفاف الدر له جسد | بأبي ما أودع مجسده |
في وجنته من نعمته | جمر بفؤادي موقده |
نظرت عيناي له خطأ | فأبى الأنظار تعمده |
ريم يرمي عن أكحله | زرقا تصمي من يصمده |
متداني الخطوة من ترف | أترى الأحجال تقيده |
ولاه الحسن وأمره | وأتاه السحر يؤيده |
ونهر كما ذابت سبايك فضة | حكى بمحانيه انعطاف الأراقم |
إذا الشفق استولى عليه احمراره | تبدى خضيبا مثل دامي الصوارم |
وتحسبه سنت عليه مفاضة | لأن هاب هبات الرياح النواسم |
وتطلعه من دكنة بعد زرقة | ظلال لأدواح عليه نواعم |
كما انفجر الفجر المطل على الدجى | ومن دونه في الأفق سحم الغمايم |
لله نهر كالحباب | ترقيشه سامي الحباب |
يصف السماء صفاؤه | فخصاه ليس بذي اصطخاب |
وكأنما هو رقة | من خالص الذهب المذاب |
غارت على شطيه أبـ | ـكار المنى عصر الشباب |
والظل يبدو فوقه | كالخال في خد الكعاب |
لا بل أدار عليه خو | ف الشمس منه كالنقاب |
مثل المجرة جر فيـ | ـها ذيله جون السحاب |
شتى محاسنه فمن زهر على | نهر تسلسل كالحباب تسلسلا |
عريت به شمس الظهيرة لاتني | إحراق صفحته لهيبا مشعلا |
حتى كساه الدوح من أفنانه | بردا يمزق في الأصايل سلسلا |
وكأنما لمع الظلال بمتنه | قطع الدماء جمدن حين تحللا |
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 3- ص: 0
ابن الأبار الإمام العلامة البليغ الحافظ المجود المقرئ مجد العلماء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي الأندلسي البلنسي الكاتب المنشئ، ويقال له: الأبار وابن الأبار.
ولد سنة خمس وتسعين وخمس مائة.
وسمع من: أبيه الإمام أبي محمد الأبار، والقاضي أبي عبد الله بن نوح الغافقي، وأبي الخطاب بن واجب، وأبي داود سليمان بن حوط الله، وأبي عبد الله بن سعادة، وحسين بن زلال، وأبي عبد الله ابن اليتيم، والحافظ أبي الربيع بن سالم، ولازمه، وتخرج به.
وارتحل في مدائن الأندلس، وكتب العالي والنازل، وكانت له إجازة من أبي بكر بن حمزة، استجازه له أبوه.
حدث عنه: محمد بن أحمد بن حيان الأوسي، وطائفة.
وذكره أبو جعفر بن الزبير، وقال: هو محدث بارع، حافل، ضابط، متقن، كاتب بليغ، وأديب حافل حافظ. روى عن أبيه كثيرا، وسمى جماعة.
إلى أن قال: واعتنى بباب الرواية اعتناء كثيرا، وألف ’’معجمه’’ وكتاب ’’تحفة القادم’’، ووصل ’’صلة’’ ابن بشكوال، عرفت به بعد تعليقي هذا الكتاب بمدة -يعني كتاب ’’الصلة’’ لابن الزبير- قال: وكان متفننا متقدما في الحديث والآداب، سنيا، متخلفا فاضلا، قتل صبرا ظلما وبغيا، في أواخر عشر سنين وست مائة.
قلت: كان بصيرا بالرجال المتأخرين، مؤرخا، حلو التترجم، فصيح العبارة، وافر الحشمة، ظاهر التجمل، من بلغاء الكتبة، وله تصانيف جمة منها ’’تكملة الصلة’’ في ثلاث أسفار، اخترت منها نفائس.
انتقل من الأندلس عند استيلاء النصارى، فنزل تونس مدة، فبلغني أن بعض أعدائه شغب عليه عند ملك تونس، بأنه عمل ’’تاريخا’’ وتكلم في جماعة، وقالوا: هو فضولي يتكلم في الكبار، فأخذ، فلما أحس بالتلف قال لغلامه: خذ البغلة لك، وامض حيث شئت، فلما أدخل، أمر الملك بقتله، فتعوذ بالله من شر كل ذي شر، هذا معنى ما حكى لي الإمام أبو الوليد ابن الحاج -رحمه الله- من قتله.
ومن تواليفه ’’الأربعون’’ عن أربعين شيخا من أربعين تصنيفا لأربعين عالما من أربعين طريقا إلى أربعين صحابيا لهم أربعون اسما من أربعين قبيلة في أربعين بابا.
أخبرنا أبو عبد الله بن جابر المقرئ سنة 734، أخبرنا محمد بن أحمد بن حيان بتونس سنة سبع عشرة، حدثنا أبو عبد الله ابن الأبار، حدثنا أبو عامر نذير بن وهب بن لب الفهري بقراءتي حدثنا أبي أبو العطاء، حدثنا أبي القاضي أبو عيس لب بن عبد الملك بن أحمد، حدثنا أبي أبو مروان، حدثنا علي بن عيسى الجذامي صاحب الصلاة، حدثنا أبو مروان، حدثنا علي بن عيسى الجذامي صاحب الصلاة، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإلبيري في كتاب ’’أدب الإسلام’’، حدثني الفقيه إسحاق بن إبراهيم الطليطلي، عن أحمد بن خالد، عن ابن وضاح، عن ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ’’لا يرحم الله من لا يرحم الناس’’.
هذا حديث صحيح وقع لنا نازلا بسبع درجات عما أخبرنا ابن أبي عمر وغيره إجازة، قالوا: أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا هبة الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان، أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن شداد، حدثنا يحيى القطان، عن إسماعيل بهذا.
وقد رأيت لأبي عبد الله الأبار جزءا سماه ’’درر السمط في خبر السبط عليه السلام’’ يعني الحسين بإنشاء بديع يدل على تشيع فيه ظاهر، لأنه يصف عليا -رضي الله عنه- بالوصي، وينال من معاوية وآله، وأيضا رأيت له أوهاما في تيك ’’الأربعين’’ نبهت عليها.
وكان مصرعه في العشرين من المحرم، عام ثمانية وخمسين وست مائة، بتونس.
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 16- ص: 472
الأبار
الإمام، الحافظ، العلامة، البليغ، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر، القضاعي، الأندلسي، البلنسي، الكاتب المنشيء، ويقال له: الأبار، وابن الأبار.
ولد سنة خمس وتسعين وخمس مئة.
وسمع من أبيه الإمام أبي محمد الأبار، والقاضي أبي عبد الله بن نوح الغافقي، وأبي الخطاب بن واجب، وأبي داود سليمان بن حوط الله، وحسين بن زلال، وأبي عبد الله بن اليتيم، والحافظ أبي الربيع بن سالم، ولازمه وتخرج به.
وارتحل في مدائن الأندلس، وكتب العالي والنازل، وكانت له إجازة من أبي بكر بن أبي جمرة.
حدث عنه: محمد بن أحمد بن حيان الأوسي، وطائفة.
وكان بصيراً بالرجال المتأخرين، فصيح العبارة، وافر الحشمة، ظاهر التجمل، من بلغاء الكتبة، وله تصانيف منها ’’تكملة الصلة’’ في ثلاثة أسفار، ومنها جزءٌ سماه ’’درر السمط في خبر السبط - عليه السلام - ’’ يعني الحسين، وفيه يدل على تشيعه، ومنها ’’الأربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين تصنيفاً لأربعين عالماً من أربعين طريقاً إلى أربعين تابعياً عن أربعين صحابياً لهم أربعون اسماً من أربعين قبيلة في أربعين باباً’’.
قال ابن الزبير: هو محدثٌ بارع، حافل، ضابط، متقنٌ، وكاتب بليغ، وأديب حافل ضابط حافظ، اعتنى بباب الرواية اعتناء كبيراً، وألف ’’معجمه’’، وكتاب ’’تحفة القادم’’، ووصل ’’صلة’’ ابن بشكوال، عرفت به بعد تعليقي هذا الكتاب بمدة. يعني كتاب ’’الصفة’’ لابن الزبير.
قال: وكان متفنناً متقدماً في الحديث والأداب، سنياً، متخلقاً، فاضلاً، قتل صبراً ظلماً وبغياً.
وقال غيره: انتقل من الأندلس عند استيلاء النصارى، فنزل تونس مدة، ثم إن بعض أعدائه شغب عليه عند ملك تونس: بأنه عمل تاريخاً وتكلم في جماعة، وهو كثير الفضول يتكلم في الكبار: فلما أحس بالتلف قال لغلامه: خذ البغلة لك، وامض حيث شئت. فلما أدخل أمر الملك بقتله، وذلك في سنة ثمانٍ وخمسين وست مئة.
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان-ط 2( 1996) , ج: 4- ص: 1