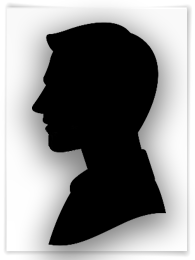ابن الخوجة
ابن الخوجة أحمد بن محمد بن الخوجة، أبو العباس: فاضل، من شيوخ تونس وعلمائها. مولده ووفاته فيها. ولى قضاء الحنفية، ثم الفتوى، ثم مشيخة الإسلام سنة 1294 هـ. له (كشف اللثام عن محاسن الإسلام) وعدة رسائل في موضوعات مختلفة.
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 1- ص: 248
ابن الخوجة أحمد المعروف بحميدة ابن الشيخ محمد بن أحمد بن الخوجة، الفقيه، الحنفي، المفكر، الأديب، الشاعر القادري الطريقة، ينحدر من سلالة تركية، وأسرته اشتهرت بالعلم في العصر الحسيني.
ولد بتونس في شعبان 1245/ 1830، واعتنى والده بتربيته وتوجيهه، وأقبل بجد واجتهاد على التعلم بجامع الزيتونة، وكان أكثر أخذه ومعظم استفادته من دروس والده شيخ الإسلام من أجلة علماء عصره بجامع يوسف صاحب الطابع كما أخذ عن العلامة الأديب محمد بيرم الرابع بالمدرسة العنقية، وعن محمد بن عاشور بزاوية جده خارج باب المنارة، وأخذ بجامع الزيتونة عن القاضي الأديب محمد بن سلامة ومحمد بن حمدة الشاهد، والقاضي محمد الطاهر بن عاشور، والقاضي محمد النيفر وظهر نبوغه وتفوقه سريعا، وباشر التدريس بجامع الزيتونة تطوعا، وهو دون العشرين من عمره باشارة من شيوخه، ثم سمي مدرسا رسميا في ذي القعدة سنة 1266/ 1851 وكان في دروسه فصيحا مفهوما مع براعة في إيصال المعلومات إلى المستمعين، ويضيف إلى ذلك حسن التقرير، ودقة التحقيق مما يبهر الألباب بالسحر الحلال، ودرس أهم الكتب المتداولة التدريس بالجامع، ولبث خمسة وأربعين عاما منبع افادة، ومنهل إجادة، وآخر دروسه وأشهرها درسه لتفسير القاضي البيضاوي.
تولى القضاء في ربيع الأول سنة 1277/ 1861 وعمره لا يتجاوز اثنتين وثلاثين سنة عوضا عن الشيخ مصطفى بيرم، فأظهر كفاءة في الاجراءات وتطبيق النصوص، ثم نقل إلى خطة الافتاء سنة 1279/ 1863 بعد وفاة والده في محرم 1279 وتولى مشيخة الإسلام في 27 صفر 1294/ 1878 بعد
وفاة الشيخ محمد معاوية، وسمي خطيبا بجامع يوسف صاحب الطابع سنة 1278/ 1862، ثم نقل إلى جامع محمد باي المرادي خلفا عن والده عند وفاته وقد امتاز بين خطباء عصره بارتجال خطبة الجمعة مع الايجاز احتفاظا بالوقت لاداء فريضة الجمعة على أصح الأقوال الواردة في تعداد الخطبة في المصر الواحد.
وفي أثناء قيامه بوظيفة الافتاء ظهرت مواهبه العالية في الفقه من تطبيق النصوص على مقتضيات الأحوال، وترجيح ما هو الأولى منها بالترجيح، فكان مائلا إلى الاجتهاد المذهبي، مستندا إلى علم أصول الفقه لتحرير مناط الحكم ودفع التعارض بين النصوص، ويضيف إلى ذلك الاطلاع على المذاهب الإسلامية، وكان في فتاويه متفتح الذهن، جيد الفكر، عارفا بما دخل على المجتمع من تطورات سياسية واجتماعية، والأحكام الشرعية المناسبة لها وبهذه المواهب الخصبة كان من أكبر المؤيدين لأصول قانون عهد الأمان والنظم المتفرعة عن تلك الأصول، وصدرت عنه الفتاوى المحررة، حاز بها شهرة في التحقيق والتحرير لا في تونس فحسب بل في أقطار المغرب والمشرق.
وكان في طليعة رجال الدين الذين اعتمد عليهم الوزير المصلح خير الدين في سبيل انجاز برنامجه الاصلاحي، فشارك في تأسيس نظام جمعية الأوقاف، وفي تأسيس المدرسة الصادقية، وفي اصلاح ترتيب الدروس بجامع الزيتونة.
وأقعده المرض ثلاث سنوات بمنزله ثم طغا المرض وازدادت مضاعفاته وافقده حياته ولحق برحمة ربه في ذي الحجة سنة 1313/ 1896.
مؤلفاته:
1) اختام على أحاديث من صحيح البخاري.
2) تقارير على حاشية الشيخ عبد الحكيم السيالكوني على تفسير البيضاوي.
3) تكملة حاشية والده على الدرر.
4) رسالة من حكم الانتفاع بشواطئ البحار ومعظم الأنهار.
5) رسائل فقهية، توجد ضمن مجموعة من الرسائل الفقهية ترتيبها الثالث بالمكتبة الوطنية بتونس، وأصلها من المكتبة العبدلية.
6) الصبح المسفر.
7) فتاوى كثيرة، أصدرها وهو متول للافتاء، توجد بالمكتبة الوطنية بتونس، وأصلها من المكتبة العبدلية.
8) الكردار في الأحباس بالمكتبة الوطنية بتونس وأصلها من المكتبة العبدلية.
9) كشف اللثام عن محاسن الإسلام، حرر فيه مسائل من أمهات الفقه والسياسة.
10) مجموعة من اجازاته واجازات مشايخه، فمن مجيزيه هو عامة الشيخ إبراهيم الرياحي، ووالده شيخ الإسلام محمد بن الخوجة اجازه سنة 1271/ 1855، والشيخ محمد بيرم الرابع، واجازته له نظما، وأجاز هو الشيخ محمد المكي بن عزوز وابن عمه الشيخ أحمد الأمين بن المدني بن عزوز.
11) المرشد.
12) نفثة المصدور.
المراجع:
- الاعلام 1/ 235.
- أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور (القاهرة 1387/ 1967 ط 1).
ص 373 - 377، وفيه أن تاريخ ميلاده سنة 1246، واعتمد على ترجمة بخط صديقه الشيخ محمد الخضر حسين نقلا عن مذاكراته الخاصة.
- برنامج المكتبة الصادقية 4/ 365
- تاريخ معالم التوحيد 116.
- تراجم الاعلام 93 - 101.
- شجرة النور الزكية 2/ 137.
- عنوان الأريب 2/ 137 - 141.
- فهرس الفهارس 1/ 285 - 286.
- معجم المؤلفين 2/ 100.
دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان-ط 2( 1994) , ج: 2- ص: 244